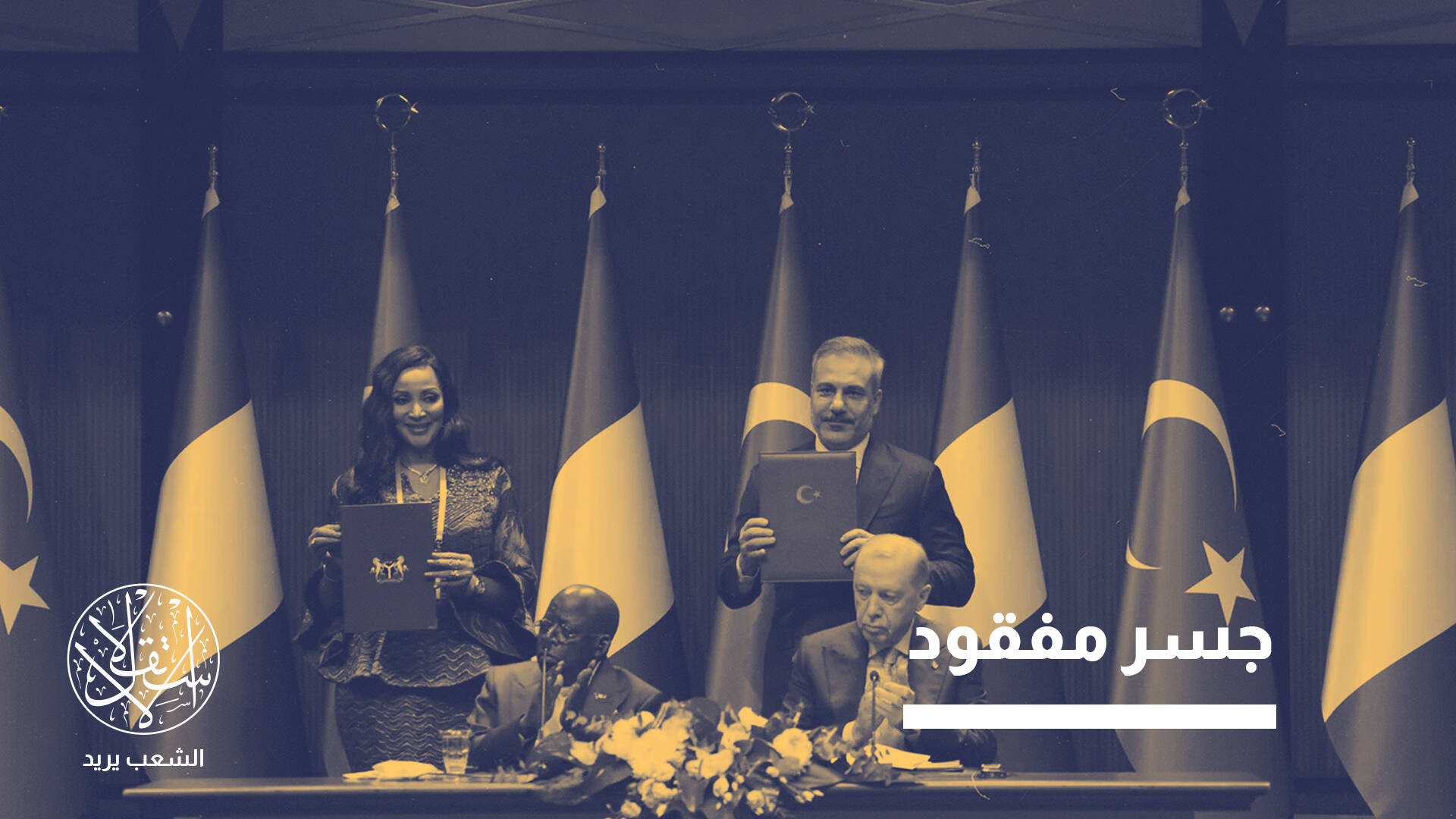من صالح إلى الإمارات.. كيف جرى توظيف "ورقة الإرهاب" بوجه حزب الإصلاح في اليمن

شكّل حزب الإصلاح، منذ تأسيسه عام 1990، أحد أبرز شركاء صالح في السلطة
مصطفى كمال
لم يكن ملف الإرهاب في اليمن شأناً أمنياً محضاً، بقدر ما تحوّل منذ نهاية التسعينيات إلى أداة سياسية متعددة الوظائف، استُخدمت داخلياً لإدارة الصراع على السلطة، وخارجياً لإعادة تموضع النظام اليمني داخل المعادلات الدولية.
في هذا السياق، برز نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بوصفه أول من حوّل الإرهاب إلى ورقة تفاوض إستراتيجية مع الولايات المتحدة، ثم إلى أداة لتحجيم الخصوم السياسيين، وفي مقدمتهم حزب التجمع اليمني للإصلاح.
وبينما استخدم صالح الإرهاب كورقة ضغط ومساومة في علاقاته الإقليمية والدولية، أعادت الإمارات العربية المتحدة إنتاج الخطاب ذاته، ولكن ضمن مقاربة أمنية إقليمية أوسع عنوانها مواجهة «الإسلام السياسي».

شيطنة الخصوم
اعتمد الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح، خلال مراحل متعددة من حكمه، سياسة توظيف ممنهجة لورقة الإرهاب في إدارة صراعاته الداخلية، خصوصاً مع حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي استُخدمت هذه الورقة ضده بغرض الابتزاز وتصفية الحسابات السياسية.
شكّل حزب الإصلاح، منذ تأسيسه عام 1990، أحد أبرز شركاء صالح في السلطة، وخصوصا خلال مرحلة ما بعد حرب 1994. غير أن هذا التحالف بدأ بالتآكل تدريجياً مع تنامي نفوذ الإصلاح اجتماعياً وسياسياً، وتحوله إلى منافس حقيقي داخل بنية الحكم، قبل أن ينقلب إلى خصومة مفتوحة عقب انتخابات 2006، عندما دعم الحزب مرشح المعارضة في مواجهة صالح.
في السنوات العشر الأولى من الألفية الثالثة (2000-2010) كثف صالح جهوده في استخدام ورقة الإرهاب ضد التجمع اليمني للإصلاح الذي لم يكن في الساحة اليمنية سواه كقوة سياسية يُحسب لها، فيما كان الرجل قد خطا خطوات حثيثة نحو التوريث، وكانت ورقة الإرهاب ضمن أخطر أوراقه التي رفعها في مواجهة الإصلاح في محاولة لتأليب الداخل واستعداء الخارج عليه.
بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وجد صالح في "الحرب على الإرهاب" فرصة إستراتيجية لإعادة تسويق نفسه لدى الولايات المتحدة والغرب، مستخدماً ملف تنظيم القاعدة كورقة تفاوضية.
وفي هذا السياق، بدأ النظام يلمّح -بشكل غير مباشر ثم مباشر- إلى وجود صلات بين حزب الإصلاح والجماعات المتطرفة، مستغلاً الخلفية الإسلامية للحزب، رغم مشاركته العلنية في العملية السياسية والتزامه بالعمل السلمي.
في 28 ديسمبر 2002 شهدت صنعاء اغتيال الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني جار الله عمر داخل قاعة المؤتمر العام الثالث لـ حزب الإصلاح المنعقد بالكلية الحربية بصنعاء، على يد علي السعواني.
وسارعت أجهزة نظام صالح إلى إعلان انتماء المنفذ للإصلاح وارتباطه بجامعة الإيمان. وبعد يومين فقط، وقعت جريمة إرهابية ثانية في مستشفى جبلة بمحافظة إب، نفذها عابد الكامل وأودت بحياة ثلاثة أطباء أجانب، لتعاود أجهزة الإعلام الرسمية ربط الجريمة بالإصلاح.
جاء توظيف هاتين الجريمتين في سياق سياسي حساس سبق الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 أبريل 2003، حيث كان صالح قلقاً من صعود تحالف أحزاب المشترك بقيادة الإصلاح واحتمال تراجع حظوظ حزبه في البرلمان.
وعليه، مثّلت شيطنة الإصلاح عبر ورقة الإرهاب أداة ضغط استباقية لتقويض التحالف المعارض، والتأثير على الرأي العام، وإعادة تشكيل البيئة السياسية بما يخدم موازين القوة لصالح النظام.
وبلغ توظيف ورقة الإرهاب ذروته بعد اندلاع ثورة فبراير 2011، حين انحاز حزب الإصلاح إلى صف الثورة. عندها صعّد صالح خطابه، متهماً الثورة بأنها "مشروع إخواني–قاعدي"، ومحذراً المجتمع الدولي من سقوط اليمن في أيدي المتطرفين إذا أُطيح بنظامه.
وتجلّى هذا التوظيف بوضوح في أحداث مدينة زنجبار/ أبيّن عام 2011، عندما سيطر تنظيم القاعدة (أنصار الشريعة) على المدينة بالتواطؤ مع صالح، وهو ما عد دليلاً على استخدامه التنظيم كورقة ضغط لإثبات روايته القائلة: إن البديل عن نظامه هو الفوضى والإرهاب.

إعادة إنتاج الخطاب
منذ انخراطها في التحالف العربي باليمن، تبنّت دولة الإمارات إستراتيجية سياسية وعسكرية اتسمت بعدائها الواضح لحزب التجمع اليمني للإصلاح، حيث لجأت إلى توظيف خطاب "مكافحة التطرف والإرهاب" بوصفه أداة لتبرير دعمها لقوى سياسية وعسكرية مناوئة للحزب.
ويعكس هذا السلوك إعادة إنتاج ممنهجة لـ"ورقة الإرهاب" -أو ما يُسمى بمخاطر الإسلام السياسي- بوصفها أداة سياسية وأمنية فاعلة في إدارة الصراع داخل الساحة اليمنية.
ومع انطلاق عملية عاصفة الحزم في مارس 2015، بدأت الإمارات توجيه اتهامات مباشرة لحزب الإصلاح بالتخاذل، إذ صرّح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، بأن "التحرير كان يمكن أن يكتمل لولا تخاذل جماعة الإخوان المسلمين".
وفي مطلع عام 2017، عاد قرقاش ليصعّد من حدة الاتهامات، واصفاً جماعة الإخوان بالانتهازية، ومؤكداً -دون تقديم أدلة- وجود تنسيق بينها وبين تنظيم القاعدة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل مضى إلى اتهام الإخوان بالقتال في صفوف الانقلابيين الحوثيين وقوات الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، زاعماً أنهم يسعون لإطالة أمد الحرب عبر تزويد الانقلابيين بالأسلحة.
غير أن تطورات لاحقة، مدعومة بتحقيقات سعودية، كشفت أن الإمارات نفسها كانت متورطة في إيصال أسلحة إلى الحوثيين عبر أدواتها المحلية، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي.
وعقب تفجر الصراع بين الحوثيين وعلي عبدالله صالح، وانتهائه بمقتل الأخير في الرابع من ديسمبر 2017، طرأ تحول محدود على علاقة الإمارات بحزب الإصلاح.
فقد عُقد أول لقاء رسمي بين الطرفين في المملكة العربية السعودية منتصف ديسمبر 2017، بعد عشرة أيام فقط من مقتل صالح، وهو الحدث الذي عده محللون نكسة للتحالف السعودي–الإماراتي بعد فشل الرهان على انتفاضة صالح وحزبه ضد الحوثيين.
وفسّر هذا اللقاء على أنه محاولة من التحالف لإعادة تجميع الدعم من قوى يمنية وازنة، عقب تعثر الخيارات السياسية والعسكرية، وتكريس الحوثيين لسيطرتهم الميدانية.
وعقب اللقاء، صرّح أنور قرقاش بأن الاجتماع أكد أهمية توحيد الجهود لهزيمة إيران والحوثيين، مشيراً إلى أن حزب الإصلاح أعلن فك ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، وأن المرحلة المقبلة تمثل "فرصة لاختبار النوايا".
والحقيقة أن حزب الإصلاح كان قد أعلن، قبل أكثر من عام من هذا اللقاء، وتحديداً في الذكرى السادسة والعشرين لتأسيسه (13 سبتمبر 2016) عدم ارتباطه بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، في خطوة استباقية عكست قراءته المبكرة لمآلات المشهد السياسي اليمني في ظل الهيمنة المتزايدة للتحالف العربي.
غير أن هذا التقارب المحدود لم يدم طويلاً، إذ عادت العلاقات بين الإمارات وحزب الإصلاح إلى مسار التوتر الحاد، خصوصاً بعد مطالبة الحزب، في أكتوبر 2018، بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الحكومة اليمنية والتحالف العربي للكشف عن ملابسات ملف الاغتيالات التي استهدفت قياداته وكوادره في مدينة عدن.
وأوضح الحزب حينها أن 22 من أعضائه وقياداته تعرضوا لعمليات اغتيال ممنهجة خلال ثلاث سنوات، في ظل صمت رسمي من الجهات المعنية. هذا التصعيد السياسي فتح الباب مجدداً لعقد لقاء آخر بين قيادة الحزب وولي عهد أبوظبي في نوفمبر 2018، بحضور ولي العهد السعودي، إلا أن اللقاء -كغيره- لم يفضِ إلى أي اختراق حقيقي أو تفاهم سياسي مستدام.
وبعد أقل من عام على ذلك اللقاء، وفي أغسطس 2019، شنّ الطيران الإماراتي غارات جوية استهدفت قوات الجيش اليمني في محافظتي عدن وأبين، وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 جندي، بذريعة احتضان الجيش لعناصر إرهابية.
هذا التطور الخطير دفع رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح، محمد اليدومي، لتوجيه انتقادات علنية للإمارات، وإدانة قصف طيرانها للجيش الوطني، ورفض اتهامه بالإرهاب، معتبراً ما جرى انحرافاً صريحاً عن أهداف تحالف دعم الشرعية.
ولم تكتفِ الإمارات باستخدام خطاب الإرهاب ضد حزب الإصلاح، بل تجاوزت ذلك إلى ممارسات أكثر خطورة، تمثلت في استئجار مرتزقة لتنفيذ عمليات اغتيال منظمة بحق قيادات الحزب وكوادره.
ففي أكتوبر 2018، كشف موقع "بزفيد" الإخباري أن الإمارات موّلت برنامجاً لاغتيال سياسيين ودعاة في اليمن، كان معظمهم من قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح، مستخدمة مرتزقة أميركيين ضمن شركة أمنية خاصة يديرها إسرائيلي.
وأفاد التحقيق بأن العقد المبرم بين الإمارات والشركة الأميركية نصّ على دفع 1.5 مليون دولار شهرياً، إضافة إلى توفير كافة أنواع العتاد والدعم اللوجستي لفريق الاغتيالات.
وفي السياق ذاته، كشف تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في يناير 2024 أن الإمارات موّلت عمليات اغتيال سياسي في اليمن، وأن غالبية المستهدفين كانوا من أعضاء حركة الإصلاح، بوصفها الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين.
وعلى الرغم من تكشّف الوثائق والأدلة التي تدين الإمارات بتلك الجرائم، فإن حزب الإصلاح أحجم عن ملاحقتها قضائياً أمام المحاكم المحلية أو الدولية. ويُرجّح أن هذا الموقف نابع من مخاوف تتعلق بانهيار التحالف العربي واستفادة الحوثيين من أي تصدع داخلي، فضلاً عن ضغوط سعودية محتملة مورست على الحزب لتفادي فتح مسارات مساءلة قانونية قد تمتد لتشمل أطرافاً أخرى في التحالف.
والمفارقة أن السعودية شرعت، في الآونة الأخيرة، في فتح ملف الانتهاكات الإماراتية في جنوب اليمن، عقب تدهور العلاقات بين الطرفين، وانتهاء الشراكة عملياً، وصولاً إلى إنهاء الدور الإماراتي في اليمن.
في المحصلة، يمكن القول إن أحد الأهداف المركزية لدولة الإمارات في اليمن تمثّل في إضعاف حزب الإصلاح، عبر توظيف ورقة الإرهاب كأداة سياسية وأمنية لتشويه الحزب وعزله، داخلياً وخارجياً ضمن خطاب يربط الإصلاح بالتطرف، بما يبرر استبعاده من مراكز التأثير والقرار.

ما بعد الانحسار الإماراتي
يمثّل تراجع الدور الإماراتي في اليمن فرصة سياسية مهمة أمام حزب الإصلاح لاستعادة جزء من حضوره، بعد سنوات من الإقصاء المنهجي في المحافظات الجنوبية والشرقية. ويتعزز هذا التحول مع انحسار الدور السياسي والعسكري للمجلس الانتقالي، وما خلّفه من فراغ إداري وسياسي قابل لإعادة التشكّل.
كما أن توقف حملات الاغتيالات والملاحقات الأمنية التي استهدفت كوادر الإصلاح في عدن وغيرها تمنح الحزب هامش حركة أوسع لإعادة تنظيم صفوفه وبناء قواعده الشعبية والسياسية، بعد مرحلة طويلة من التهديد الوجودي.
في السياق ذاته، تشير معطيات إلى أن السعودية بدأت مراجعة مقاربتها تجاه حزب الإصلاح، بوصفه فاعلًا قادرًا على المساهمة في ضبط أي فوضى محتملة ناجمة عن تراجع نفوذ المجلس الانتقالي.
وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة واشنطن بوست عن رفض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عرضًا إماراتيًا قُدّم لإدارة الرئيس ترامب، تضمّن وقف الدعم السعودي للإصلاح مقابل مشاركة إماراتية عسكرية واسعة ضد الحوثيين، في دلالة واضحة على تحول أولويات الرياض.
وتلوح في الأفق ملامح تحالف جديد قد يشكّل حزب الإصلاح أحد أعمدته، إلى جانب قوات درع الوطن وجناح المؤتمر الشعبي العام الموالي للشرعية، بهدف تثبيت الاستقرار في الجنوب، واحتواء النزعات الانفصالية، والضغط على جماعة الحوثي، إضافة إلى تأمين الحدود، وهو الهاجس الإستراتيجي الأبرز للسعودية.
في هذا المشهد، يبدو حزب الإصلاح أكثر المستفيدين من التوتر السعودي–الإماراتي، غير أن مستقبله يظل مرهونًا بقدرته على التحول من فاعل أيديولوجي إلى شريك دولة منضبط بإيقاع الرؤية السعودية الجديدة لليمن 2026، بما في ذلك التخلي التدريجي عن خطاب ثورة فبراير والشعارات التي لم تعد منسجمة مع المقاربة الإقليمية الراهنة، وهو ما يعمل عليه الحزب بالفعل.
وبذلك، يكون الإصلاح قد انتقل من مرحلة "الدفاع عن البقاء" في عهد علي صالح، إلى مرحلة "النجاة من الاجتثاث" خلال التدخل الإماراتي، وصولًا إلى مرحلة "الشريك الوظيفي في إعادة الترتيب" ضمن السياق السعودي الحالي. ومع ذلك، يظل هذا التقارب محكومًا بسياسة سعودية تقوم على مبدأ "العصا والجزرة".
فبالتوازي مع دعم عودة الحزب سياسيًا، شرعت الرياض في فبراير 2026 بتشكيل لجان تحقيق في قضايا فساد عسكري وملفات جنود وهميين ضمن وحدات محسوبة على الإصلاح في تعز ومأرب، في مسعى واضح لضبط إيقاع الحزب ومنع خروجه عن السيطرة.
وهنا تبرز مخاوف من أن توظف السعودية ثقل الحزب مرحليًا لإنهاء تمرد المجلس الانتقالي في الجنوب، قبل العودة إلى سياسة التوازن عبر تقليص نفوذه لصالح قوى سلفية أو تكنوقراطية، منعًا لهيمنة أي طرف على المشهد.
المصادر
- اعلان الاصلاح في الذكرى الـ 26 لتأسيسه عدم علاقته بالإخوان
- تصفية الخصوم والاستفراد بالسلطة.. أصابع الإرهاب الخفية في اليمن
- انتهازية «الإخوان المسلمين» تعرقل مسيرة تحرير اليمن
- بن سلمان وبن زايد يلتقيان قيادات الإصلاح اليمني بالرياض
- قيادات بحزب الإصلاح اليمني في زيارة للإمارات
- مقدمات لتحول إماراتي سعودي نحو حزب "الإصلاح" اليمني
- التحقيق باغتيالات عدن.. مطلب من الإصلاح للسعودية والإمارات
- بزفيد: الإمارات استأجرت مرتزقة أميركيين لاغتيال ساسة وأئمة باليمن
- زعيم إصلاح اليمن يهاجم الإمارات ويتهمها بانحراف دورها
- تحقيق BBC يكشف أن الإمارات العربية المتحدة موّلت اغتيالات سياسية في اليمن
- ولي العهد السعودي يحبط عرضاً إماراتياً لترامب: لا مقايضة حزب “الإصلاح” بقتال الحوثيين