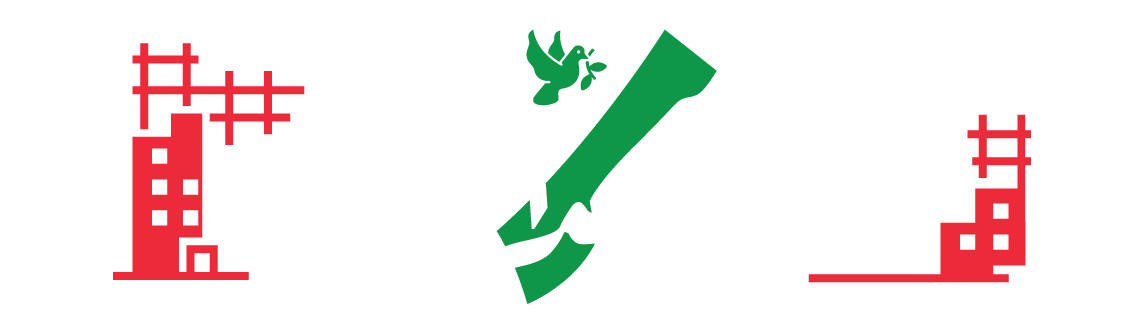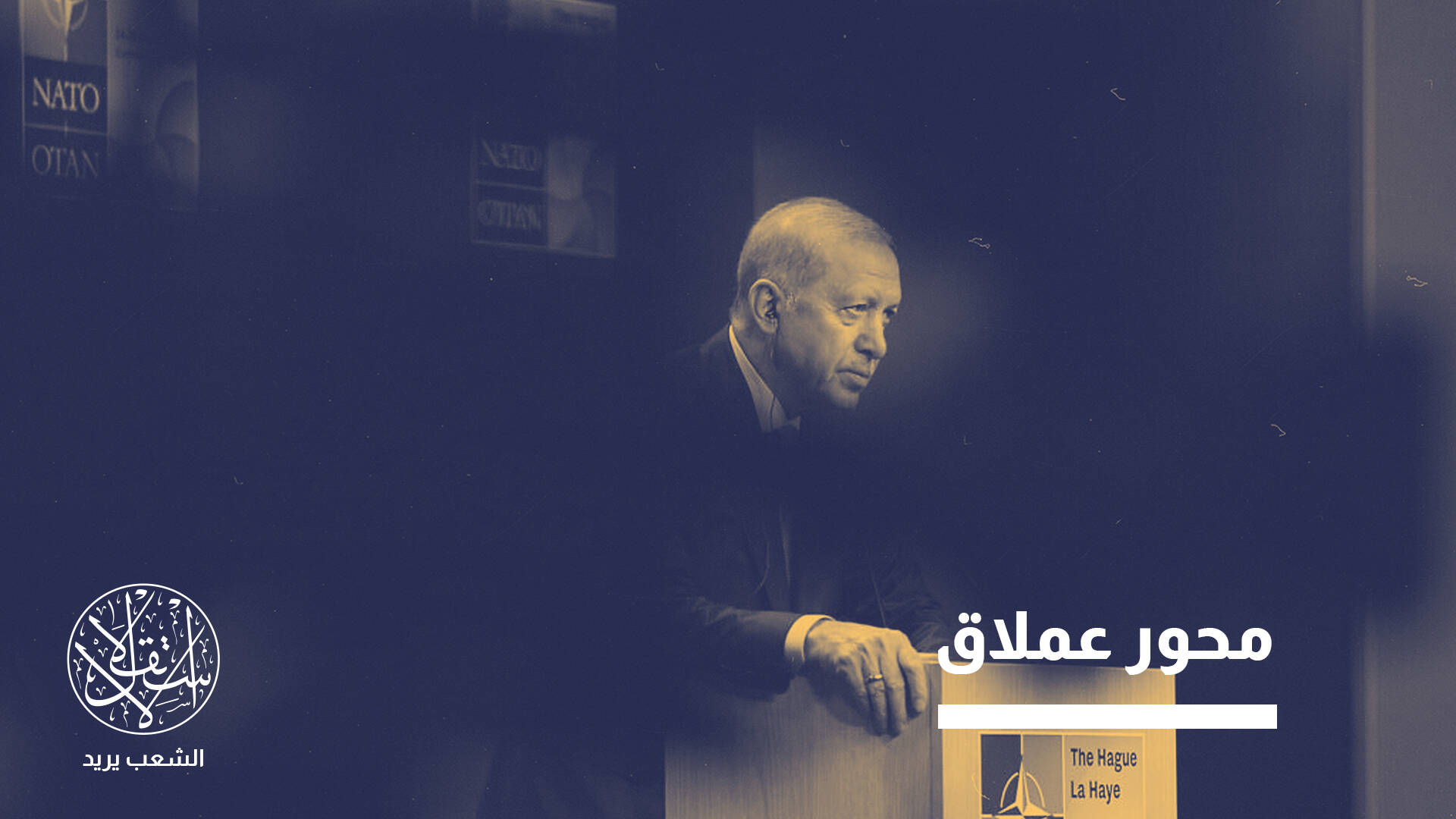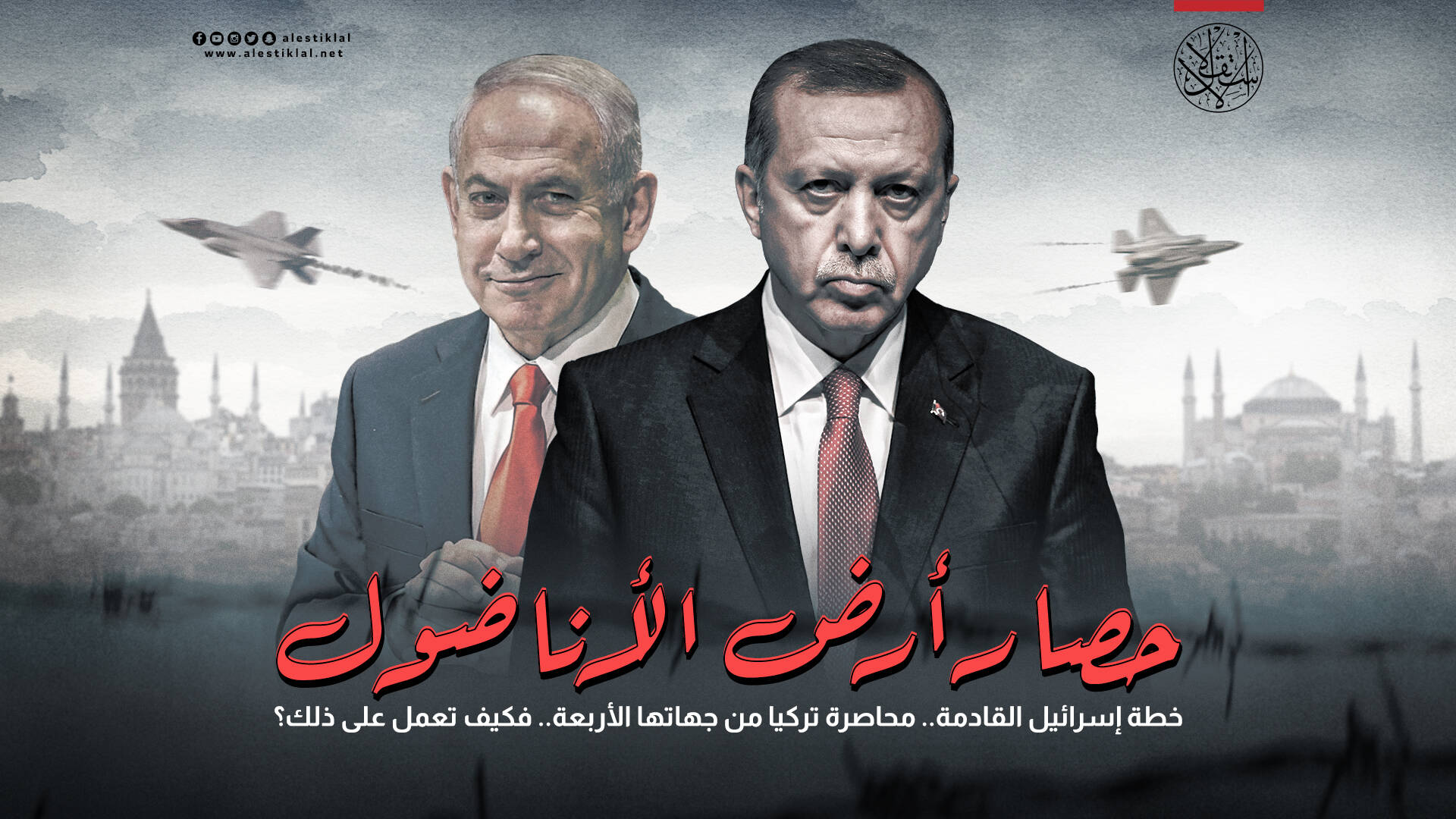صحيفة تركية: العثمانيون أنقذوا الأرثذوكس وأحفادهم يهاجمون الإسلام
.jpg)
لقيت التصريحات الأخيرة لرئيس الأساقفة في اليونان إيرونيموس الثاني عن الإسلام والمسلمين، إدانات واسعة، وصفتها تركيا بأنها "تطاول على الدين المقدس وزرع للفتنة بين المجتمعات".
وزعم إيرونيموس، في تصريحات له في 17 يناير/كانون الثاني 2021، عن حرب الاستقلال اليونانية إن "الإسلام ليس ديناً” و”المسلمون يقفون دائما مع الحرب”.
وأضاف: “الإسلام، وأتباعه… ليس دينا، بل حزب سياسي، طموح سياسي وأناس حرب، وأناس توسعيون. هذه خصوصية الإسلام. وتعاليم محمد تدعو لهذا”، بحسب زعمه.
وكان إيرونيموس، قد أعرب عام 2016، عن “قلقه” من إنشاء مسجد كبير للمسلمين، في أثينا، داعيًا السلطات إلى تأجيل الخطوة.
وتابع: “علينا ألا نستعجل”، قبل أن يتساءل باستنكار “لمن سننشئ المسجد؟ وما الذي سيفعله الناس؟ وهل سيكون المسجد للعبادة أم مدرسة للجهادية والأصولية؟ ومن سيراقب هذه الأمور”؟
وبدورها، قالت صحيفة "صباح" التركية: "صرح رئيس أساقفة اليونان بتصريحات استهدفت الإسلام والمسلمين مع أن الفتوحات التي قام بها العثمانيون في روميليا (اسم أطلقه الأتراك على أراضي الدولة العثمانية الواقعة في أوروبا) هي من أنقذت المسيحيين الأرثوذكس من تغيير مذهبهم".
وأضافت الصحيفة في مقال للكاتب "ايرهان أفيونجو": "كما كان أجداد اليونانيين اليوم من قاموا بدعوة الأتراك لإنقاذهم من الكاثوليك".
نجاة الأرثوذوكسية
وأوضح ذلك بالقول: "في الربع الأخير من القرن الرابع عشر، لم تكن البلقان موحدة سياسيا، بل مجزئة إلى العديد من الدول الإقطاعية، وقد منعها التنافس والصراع فيما بينها من العمل معا ضد العثمانيين كما سهل ذلك الفتوحات العثمانية لأنهم تعاونوا مع الأتراك ضد بعضهم البعض".
وتابع قائلا: بدت البلقان وكأنها تتوحد بعد الإمبراطورية الصربية التي تأسست في عهد ستيفان دوشان (1331-1355). لكن هذه الدولة انهارت سريعا مع وفاة دوشان في عام 1355.
وبحسب الباحث "خليل إنالجيك" فقد بدأ دور العثمانيين في لعب دور الوصي في البلقان بعد ضعف الإمبراطورية الصربية.
لقد كانت أكبر دولتين، المجر في الشمال، والبندقية في الغرب والجنوب، تتبعان سياسة توسع وانتشار في البلقان مستغلين التشرذم السياسي في المنطقة.
وكانت هاتان الدولتان تمثلان الكاثوليكية إلى جانب الهيمنة السياسية والعسكرية. لذلك، لم يتم الاعتراف بحكمهما وسلطتهما من قبل الشعب في البلقان. لكن ونتيجة للضغط الذي مارسته الدولتان، بدا أنه من المحتم على البلقان أن يصبح كاثوليكيا. وفقا للكاتب.
ونوه قائلا: "منع صراع العثمانيين مع هذه الدول مثل هذا الخطر، وضمن بقاء الأرثوذكسية في البلقان، لكن ومع ضعف السلطة السياسية البيزنطية، أصبح الشيوخ في المقاطعات أكثر استقلالية عن الحكومة شيئا فشيئا بالامتيازات المالية والقانونية التي يملكونها".
لكن ذلك أدى إلى زيادة الأعمال والضرائب على الفلاحين. لذلك ومع الفتح العثماني، تمت إقامة سلطة دولة مركزية ومطلقة في المنطقة بدلا عن السلطات المحلية، وتم إلغاء الحكم الإقطاعي، يقول الكاتب التركي.
ويلفت إلى أن الفتوحات العثمانية لم تتم بالسيف فقط. إذ يقول خليل إنالجيك إنها جرت بسياسة تصالحية تسمى "استمالة القلب" (تأليف القلوب) أكثر منها بالسيف، وأن الادعاء بأن العثمانيين استقروا في البلقان بالحديد والنار لم يعد مدرجا في المنشورات العلمية.
وشرح ذلك قائلا: إن سياسة "الاستمالة" تتمثل في كسب قلوب السكان من غير المسلمين بوعود مختلفة ومتنوعة لتوسيع منطقة الحكم العثماني.
وهكذا كانت الإدارة العثمانية توفر لغير المسلمين وتضمن لهم أمن الحياة والممتلكات والحرية في دينهم، وتنقذهم من تبعيتهم الإقطاعية السابقة في إطار سياسة التسامح الإسلامية.
الحفاظ على الهويات
وفي حال دفع السكان من غير المسلمين الذين قبلوا بالإدارة والسلطة العثمانية (آنذاك)، ضريبة "الجزية" بدلا عن الخدمة العسكرية، فإن الدولة تضمن الحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم ودياناتهم.
كما حصل السكان، الذين كانوا يهربون من غارات المحاربين ليحتموا في القلاع، على الأمن الوقائي من قبل إدارة الدولة مع توطين الحكم العثماني. ونتيجة لذلك، اعترفت العديد من الأماكن تلقائيا بالحكم العثماني، وفقا للكاتب.
ويستطرد الكاتب قائلا: "حمى العثمانيون الكنائس والأديرة الأرثوذكسية بالإضافة لحماية الشعب من غير المسلمين، وأعفوهم من الضرائب ولم يمسوا مؤسساتهم الدينية.
وبينما ألغى العثمانيون الامتيازات والحقوق الإقطاعية للطبقة العسكرية المحلية الإقطاعية، قاموا بضمهم ودمجهم في نظامهم العسكري".
وهكذا جذبوا الفلاحين والكنيسة وأهل البلدة والجنود إلى صفوفهم. لذلك، كان تأسيس الحكم في المناطق المفتوحة سهلا بعد إسقاط حكم السلطات المحلية التي كانت مستمرة لأجيال والتي قاومت الحكم العثماني.

واستدرك الكاتب: "ضمن العثمانيون حفاظ السكان في جميع المناطق التي فتحوها على هويتهم الدينية والوطنية، ولذلك لم يكن هناك تغيير كبير في لغات وأديان الناس في كل من البلقان والشرق الأوسط بعد انسحاب العثمانيين، بل أصبحت بعض هذه الدول أكثر تقدما مما كانت عليه قبل الفتوحات العثمانية".
واستشهد بالخطر الذي كان يتهدد الصرب والذي واجهه الفتح العثماني لتستمر الأرثوذكسية بعد ذلك في صربيا إضافة لإنشاء كنيسة وطنية صربية فيها أيضا.
وهكذا، استطاع الصرب الذين وقعوا تحت تأثير البطريركية اليونانية الحفاظ على هويتهم الوطنية والدينية ونجوا من تأثير الثقافة الهيلينية (تحويل الناس إلى حضارة الهيلينية أو اليونانية).
في حين فرض البريطانيون والفرنسيون، الذين بقوا لمدة 50-100 عام في الأماكن التي بقيت فيها الإمبراطورية العثمانية لقرون، دينهم ولغتهم الخاصة على الشعب.
ولا تزال اللغة الرسمية لمعظم مستعمرات هذين البلدين، الإنجليزية أو الفرنسية. كما لا تزال الفوضى والاضطرابات التي لا تنتهي مستمرة في هذه البلدان في فترة ما بعد الحكم العثماني، يقول الكاتب.
دعوات متعددة
ويلفت الكاتب إلى أن العثمانيين استقبلوا دعوات من الناس في العديد من الأماكن أثناء فتح البلقان. ويمكن العثور على معلومات حول هذا الموضوع في مقالات مورة ويانيا في موسوعة الإسلام وفي بحث "يشار إرتاش" حول مورة.
ويحكي عن ذلك قائلا: "جاء ممثلي شعب "يانيا" (اليونانية وتعرف الآن باسم لوانينا) ودعوا العثمانيين إلى مدينتهم عندما حاصر مراد الثاني سلانيك اليونانية عام 1430.
وأحضروا مفاتيح المدينة إلى قرية كليدي بالقرب من سلانيك. أما في عهد السلطان الفاتح، فقد دعا اليونانيون في مورة والصرب في مختلف المناطق، السلطان العثماني لإنقاذهم من "الطغاة".
ويتابع: كانت مورا حيث عاش اليونانيون، قد احتلت من قبل البندقية. لكن وعندما حاول الكاثوليك فرض معتقداتهم على الشعب الأرثوذكسي، استبعد اليونانيون البندقيين.
وقد كان الدبلوماسي الفرنسي "دي لا موتراي" قد رأى اليونانيين يصلون من أجل عودة الحكم التركي عندما توقف عند مورة في أوائل القرن الثامن عشر.
وكان اليونانيون يقولون إن الأتراك فرضوا ضرائب أقل ولم يتدخلوا في عبادتهم. وذكر الناس أن البندقيين استولوا على منازلهم واغتصبوا نساءهم وفتياتهم.
كما قال اليونانيون إن رجال الدين الكاثوليك تحدثوا ضد الأرثوذكسية وأجبروهم على اعتناق الكاثوليكية، في حين أن الأتراك، الذين كانوا يعيشون تحت حكمهم من قبل، لم يفعلوا شيئا كهذا، ومنحوهم جميع الحريات الممكنة، بحسب الكاتب التركي.
وأضاف: "حظر البندقيون تعيين الكهنة الأرثوذكس، وعينوهم كهنة من المستوى الأدنى في التسلسل الهرمي الكاثوليكي. وهكذا طلب اليونانيون، الذين عانوا على أيدي البندقيين، من السلطان العثماني أن ينقذهم بواسطة البطريرك اليوناني في إسطنبول".
وختم الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن اليونانيين في مورة وبعض جزر بحر إيجة كانوا يطالبون السلطان أحمد الثالث بتحريرهم من إدارة البندقية.
وقد دعمت والدة السلطان أحمد الثالث، السلطانة جومنوش أمة الله، مطالب اليونانيين. ومن الناحية الأخرى هدد البطريرك اليوناني بإخراج أي شخص يدعم البندقيين من الكنيسة أثناء الحرب.
لم يقاوم اليونانيون عندما دخل الصدر الأعظم شهيد علي باشا مورة عام 1715، بل ساعدوا القوات العثمانية حتى.
ودفع علي باشا ثمن كل شيء، بدلا من طلب طعام مجاني من الناس مثل البندقيين، وعامل اليونانيين كولاية عثمانية تعرضت لاحتلال من الخارج. وفي الواقع، جاء اليونانيون وأعلنوا ولائهم للإمبراطورية العثمانية بعد الفتح. وفقا للكاتب.