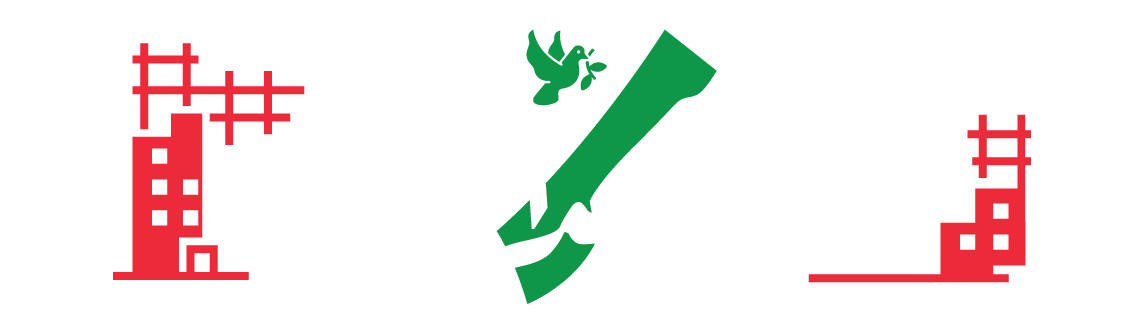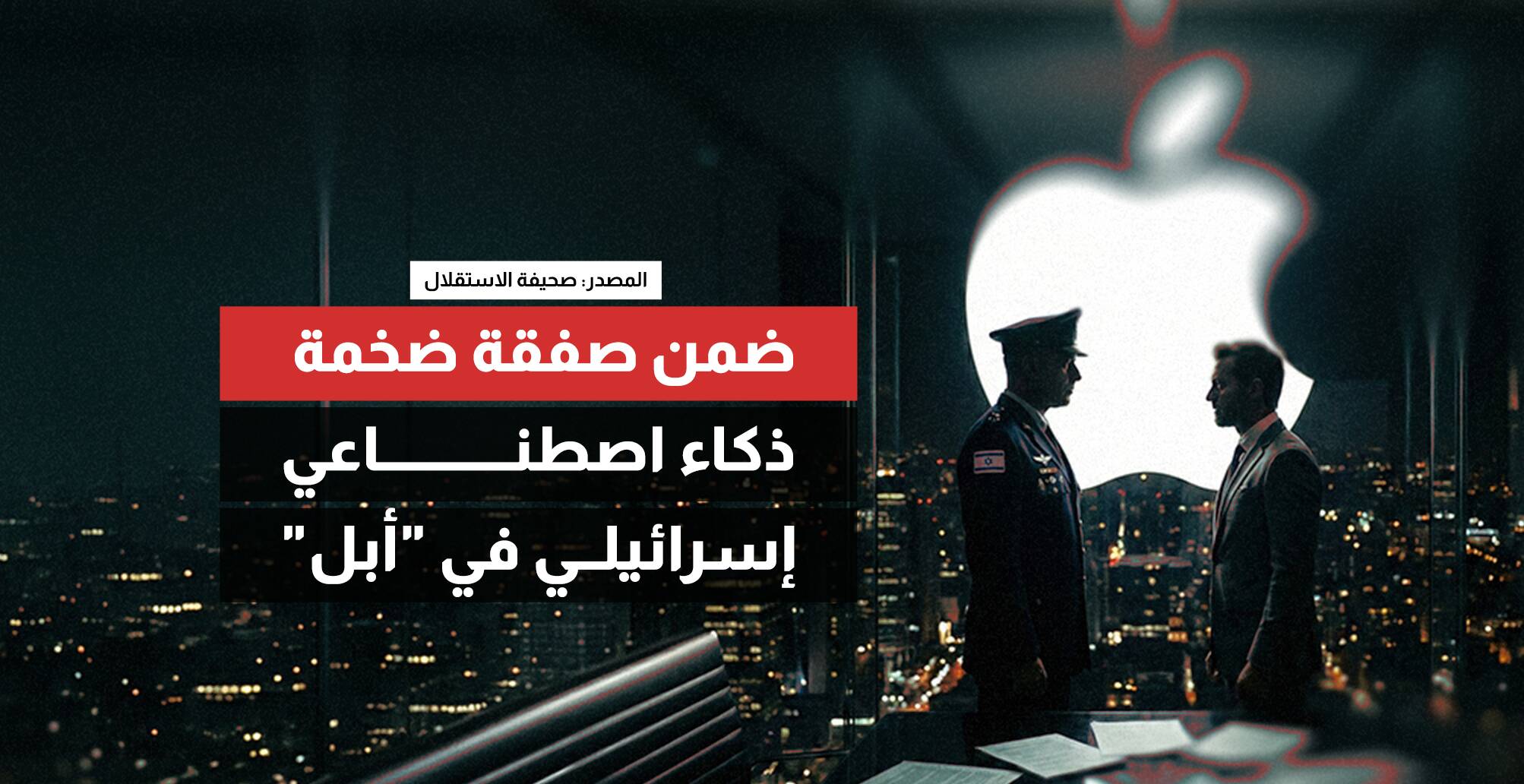الطرق الصوفية في السنغال.. ما أبرزها وما حجم نفوذها السياسي؟

توصف السنغال الواقعة في أقصى غرب إفريقيا بأنها قبلة إسلامية صوفية خالصة مع عدد سكان يبلغ 18 مليون مواطن بحسب تقرير البنك الدولي للعام 2023.
إذ ينتمي 97 بالمئة من هؤلاء إلى الدين الإسلامي، ومن هذه النسبة يقدر أتباع الطرق الصوفية السنغالية بـ 95 بالمئة من إجمالي مسلمي البلاد.
ومعظمهم يتبعون أربع طرق صوفية رئيسة، هي التيجانية والمريدية والقادرية واللايينية.
وبحسب تقرير مؤسسة "بيو" الفرنسية للأبحاث، لعام 2023، فإن أتباع الطرق الصوفية في السنغال هم أكثر من أي مجموعة من المسلمين في العالم تنتمي لاتجاه واحد.
تلك الميزة تحديدا مثلت لها تحديات كبيرة، حيث أصبح لها تأثير حاسم في حياة السكان، وأسهمت في مجالات متعددة على رأسها الاقتصاد والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والثقافية.
لكن الأهم أنها ظلت تقوم بدور رائد في الحياة السياسية السنغالية، فإليها يهرع الملوك والسلاطين والرؤساء بعد ذلك.
ولم يخل الأمر من تشابكات وتقاطعات مع الكولونيالية الفرنسية التي حاولت كثيرا نسج شباكها على السنغال.
فتارة استخدمت الطرق الصوفية وتارة حاربتها، وفي كل الأحوال لم تستطع أن تحجمها أو تقضي على نفوذها.
فإلى أي مدى يصل نفوذ تلك الجماعات داخل السنغال؟ وما هي خريطتها؟ وما التحديات التي تواجهها؟
الصوفية في السنغال
تعد الطريقة "المريدية" من أكبر وأهم الطرق في البلاد بعدد أتباع يتجاوز 4 ملايين شخص.
أسس هذه الطريقة في نهاية القرن التاسع عشر الشيخ أحمد بمبا امباكي (1853- 1927)،الذي ولد في مدينة امباكي باول السنغالية.
أتم بمبا حفظ القرآن في صغره، ثم شرع بدراسة العلوم الشرعية وغيرها. ومن مسقط رأسه بدأ يتصل بشيوخ البلاد المشهورين للاستفادة منهم علميا وروحيا.
واستطاع في فترة قصيرة أن يجمع حوله عددا كبيرا من الأتباع، ما أدى إلى أن بدأت السلطات الاستعمارية الفرنسية بالشك فيه والتضييق عليه، وهو ما اضطره إلى مغادرة قريته، طوبى، بسبب كثرة الوافدين عليه.
اتجه بمبا بعد ذلك إلى جولوف السنغالية، موطن أجداده الأولين. وكانت الشكاوى قد تراكمت ضد الشيخ وأتباعه فلم يكد يستقر فيها حتى اعتقله الاستعمار الفرنسي، عام 1895.
ونفي إلى الغابون حيث بقي هناك 7 سنين ثم أعيد إلى السنغال عام 1902.
آنذاك قرر الشيخ بمبا الشروع في التربية الصوفية وجمع أصحابه، وقال لهم: "من كان صاحبنا للتعلم فلينظر لنفسه وليذهب حيث شاء، ومن أراد ما أردنا فليسر بسيرنا وليقم بأمرنا".
إثر هذا الإعلان بقي معه فريق من تلاميذه تكونت منه النواة الأولى للطريقة المريدية، التي استمرت إلى الآن وكثر أتباعها وتعهد بالطريقة أبناء وأحفاد الشيخ أحمد بمبا.

مركزية "طوبى"
وهناك سمة مميزة لتلك الطريقة تميزها عن بقية الطرق الصوفية المنتشرة في عموم البلاد، بأن لها عاصمة خاصة ومدينة تكاد تكون مقدسة، هي "طوبى".
"طوبى" ليست مدينة عادية أو هامشية، فهي ثاني أكبر المدن السنغالية بعد العاصمة داكار.
وهي كذلك الحاضنة الروحية لأتباع "الطريقة المريدية"، الأمر الذي جعلها إحدى المدن الأكثر تأثيرا وقوة في غرب إفريقيا.
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف ارتبطت "طوبى" بالمريديين؟
الأمر يعود إلى أن كلاهما خرج من بوتقة واحدة، حيث أسست "طوبى" عام 1887 على يد مؤسس "الطريقة المريدية" الشيخ "أحمدو بمبا".
وللمدينة طقوس خاصة، حيث يحيي متبعوها بمدينة "طوبى" ذكرى عودة المؤسس بمبا إلى البلاد من المنفى، عبر احتفال يطلقون عليه اسم "ماغال".
ويستقطب هذا الاحتفال السنوي الملايين من متبعي "الطريقة المريدية" من السنغال وخارجها، حيث يتدفقون نحو المدينة للاحتفال.
ويبالغ بعض المغالين في وصف ذلك "الاحتفال" بـ "حج الفقراء"، حيث يقدم البعض عليه بدلا من "الحج الأكبر" لعدم استطاعتهم توفير النفقات، وهو ما عده علماء الدين الإسلامي من السنة بدعة محرمة.
ويعد مسجد "طوبى" الكبير في المدينة ضمن أكبر المساجد في دول غرب إفريقيا.
ووضع حجر أساسه "بمبا"، فيما استكمل بناؤه على يد مريده الشيخ "إبراهيم فال"، عام 1963، وهو يتسع لـ 7 آلاف مصل.
ويحرص الزعماء السياسيون والرؤساء على زيارة طوبى من آن إلى آخر، حتى إنه في 13 يناير/كانون الثاني 2018 أرسل ملك المغرب محمد السادس مبعوثا خاصا إليها لتهنئة شيخ الطريقة المريدية الجديد "منتقى بصيرو امباكي".

المرشحون الرئاسيون
لمعرفة سطوة الطرق الصوفية السنغالية، يجب النظر إلى تهافت المرشحين الرئاسيين لاستمالة كبار زعاماتها لا سيما طريقة المريدين.
ففي 9 فبراير/ شباط 2024، أعلن زعيم جماعة المريدين القوية في السنغال "مونتيخا باسيرو مباكي"، أنه ودائرته الداخلية يعملون بقوة على تخفيف التوترات السياسية التي أشعلها التأجيل المفاجئ للانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها مطلع فبراير/شباط 2024.
وهو ما أدى إلى إشادة المرشح الرئاسي كريم واد، في أول خطاب مصور له منذ أكثر من ثماني سنوات، بـ "خليفة" طريقة المريدين "مباكي" وسلفه سيرين سيدي مختار مباكي الذي توفي عام 2018.
الأمر الذي برز في خطاب "واد" السياسي القوي والطامح لقيادة البلاد، هو إعرابه عن أسفه لإبعاده عن الزعيمين الأعليين لجماعة المريدين منذ نفيه إلى قطر بعد إدانته من المحكمة عام 2016.
كانت الإشارة إلى الشخصيتين الرئيستين في الجماعة مهمة، لأنها تمثل بوابة مستقبله السياسي القادم.
كما يمثل المريدون مجموعة مهمة من الناخبين في الانتخابات الرئاسية.
الطريقة القادرية
وكذلك تأتي الطريقة "القادرية" فهي تكافئ "المريدية" من حيث النفوذ والانتشار وقوة التأثير.
وتعود جذورها في السنغال إلى عام 1886 عندما ورث فتى يبلغ من العمر 15 سنة عن والده الشيخ الموريتاني "محمد فاد الله" مهمة التعريف بالإسلام وبطريقته الجديدة لسكان السنغال.
ذاك الفتى أصبح الشيخ "ساديبو شريف أيدارا"، الذي يعد سليل العالم الإسلامي "عبد القادر الجيلاني".
ويرجع الفضل في نشر الطريقة "القادرية" في السنغال واستمرارها حتى اليوم، إلى الشيوخ الموريتانيين الذين جابوا البلاد ونظموا أتباعهم في كل مدينة كبيرة بواسطة ممثلين تولوا تنسيق علاقات الأتباع بشيخهم.
وقد استوطنت أسر منهم السنغال نهائيا، ومن أبرز هؤلاء: الشيخ محفوظ الموريتاني الذي استقر في كاسمانص وأسس قرية دار السلام، عام 1902.
ونفذ الأخير جولات عديدة في المنطقة واتصل بالزعيمين ساموري توري وموسى مولو، حيث تبنوا الطريقة واعتنقوها وساهموا في تعزيز أواصرها.
وتعد مدينة "غويول" السنغالية، الواقعة على الطريق بين العاصمة داكار والحاضرة سانت لويس، مركز الطريقة القادرية.
ويعتنق كل أهل "غويول" تقريبا القادرية ويقيمون لها الاحتفالات والندوات الكبرى، التي يحضر إليها أبناء الطريقة من دول خارجية كالمغرب وموريتانيا والسودان.
التيجانية واللاهينية
أسست هذه الطريقة في المغرب العربي خلال القرن الثامن عشر الميلادي، على يد الشيخ أحمد بن محمد المختار بن سالم التيجاني الذي وُلد بقرية عين ماضي الجزائرية.
لكن انتشارها في السنغال جرى على أيدي شيوخ سنغاليين، أبرزهم عمر بن سعيد الفوتي، الذي كان له الفضل في دخول هذه الطريقة إلى البلاد والتمهيد لها.
ثم جاء من بعده الشيوخ المربون الذين رسخوا قدم التيجانية في البلاد ومن هؤلاء: عبد الله نياس وأولاده الذين نشروا الطريقة في منطقة سالوم السنغالية وغامبيا وبعض البلدان الإفريقية.
ومن الطرق الكبرى في السنغال أيضا الطريقة "اللاهينية". وكلمة (اللايين) تحريف لكلمة (إلهيين) نسبة إلى الإله.
وتنسب الطريقة إلى أتباع شيخ سنغالي يدعى لباس تياو (1843-1909)، ويلقب بـ "ليمامو لاي"، أي "الإمام الذي عينه الله".
ولد هذا الشيخ في قرية يوف، غرب دكار، ولما بلغ الأربعين من عمره ادعى أنه المهدي وأنه كلف بالدعوة إلى الله فتقبل فريق من جيرانه إعلانه ونشروا طريقته.

الدور السياسي
في 5 أغسطس/ آب 2018، نشر مركز الجزيرة للدراسات السياسية، دراسة عن "الدور السياسي للطرق الصوفية في السنغال".
وذكر أن "الوزن الاقتصادي والاجتماعي للطرق يجعل لها أهمية سياسية كبيرة، وقد أدركت السلطة السياسية التقليدية هذه الحقيقة فسعت للتحالف معها من أجل تسخيرها للحصول على مقاصدها".
وأضافت: "اتصل الملوك المحليون مثل لاتْ جُورْ، وصمب لاوبه، وعالي بوري، في القرن التاسع عشر بالشيخ أحمد بمبا طالبين مساعدته في استعادة عروشهم مقابل قيامهم بالدفاع عن الإسلام إذا تم لهم ما أرادوا".
وأوردت الدراسة: "أدركت السلطات الاستعمارية الفرنسية المكاسب السياسية التي كان يمكن تحقيقها باستعمال الطرق، فاتخذت مبدأ فرق تسد وسيلة في التعامل معها".
وأتبعت: "استغلت التنافس القائم بين أتباع الطرق ليجند بعضهم ضد بعض، حتى أوجدت لها حلفاء من القادريين الفوتاويين لمحاربة الثوار التيجانيين واستعملت بعض هؤلاء لمراقبة المريديين ومضايقتهم".
ومما أشارت إليه، أن "الدور السياسي للطرق كان محدودا في بدايته، إذ لم يكن لمعظم سكان المستعمرة حق المشاركة في الانتخابات الذي كان حكرا على سكان المديريات الأربع: داكار، وروفيسك، وغوريه، وسانت لويس".
وقالت الدراسة إن التحدي الذي يواجه مستقبل الطرق الصوفية في السنغال، يتمثل في المستوى الثقافي للسنغاليين الذي يتحسن بسرعة بسبب كثرة المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت أن الازدياد الملحوظ في عدد خريجي الجامعات ونزولهم إلى ميدان العمل الإسلامي أسهم في التطور العلمي والثقافي.
وأكملت: "أنشأوا جمعيات لتقديم رسالة الإسلام خالية من المصالح الضيقة، فنجم عن كل ذلك وعي إسلامي كبير دفع فريقا من المثقفين وغيرهم إلى العودة إلى الإسلام ودراسته دراسة عميقة والبحث في ضوء تعاليمه عن حلول لمشاكل المجتمع السنغالي، بعيدا عن أساليب وطقوس الطرق الصوفية".