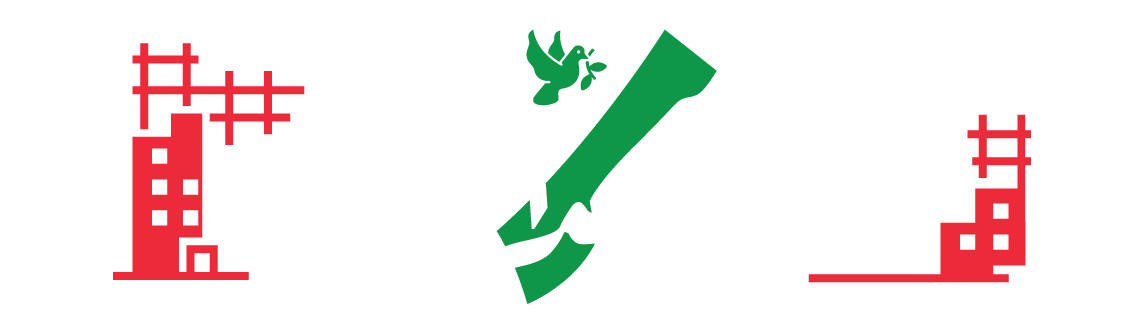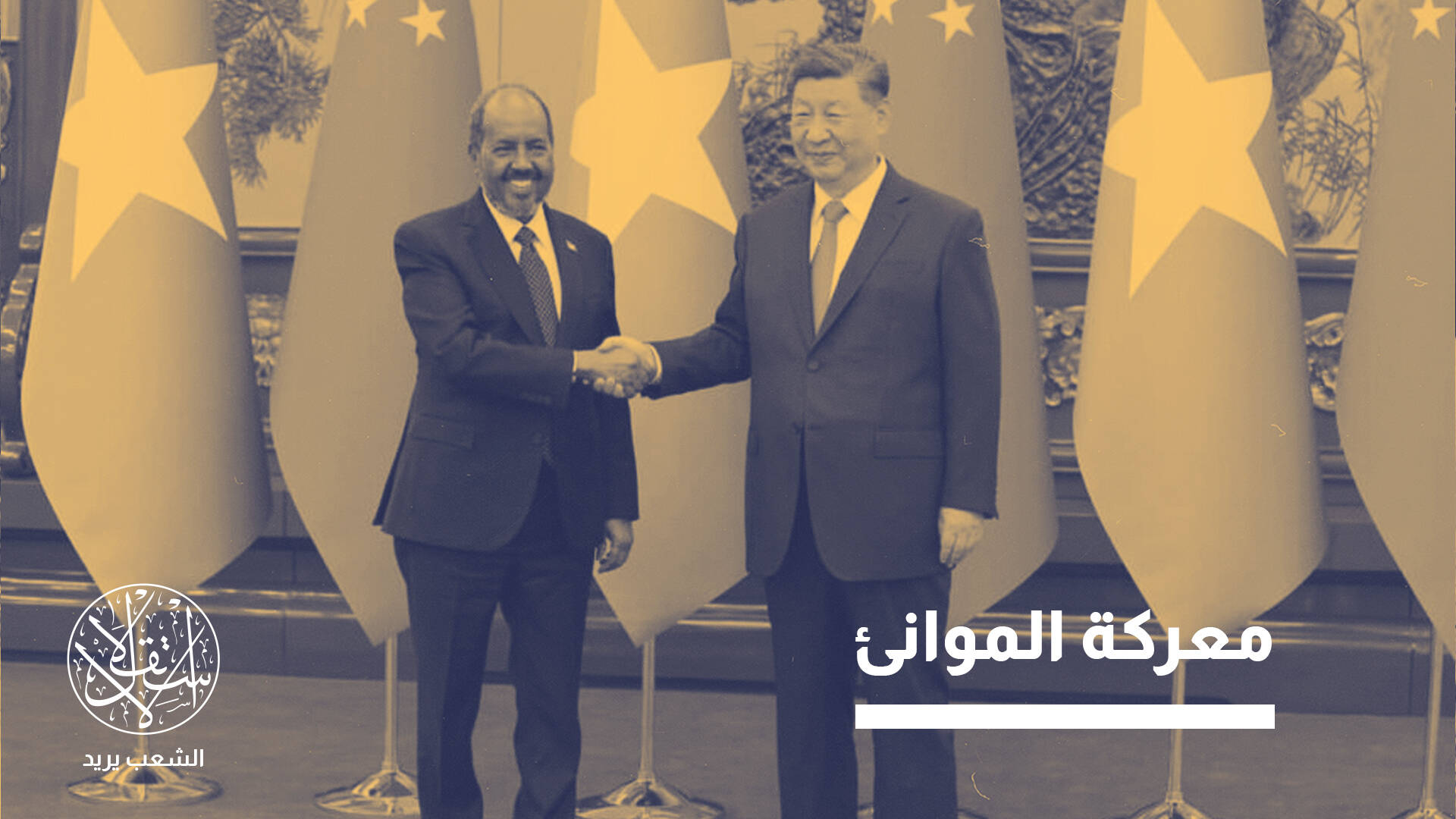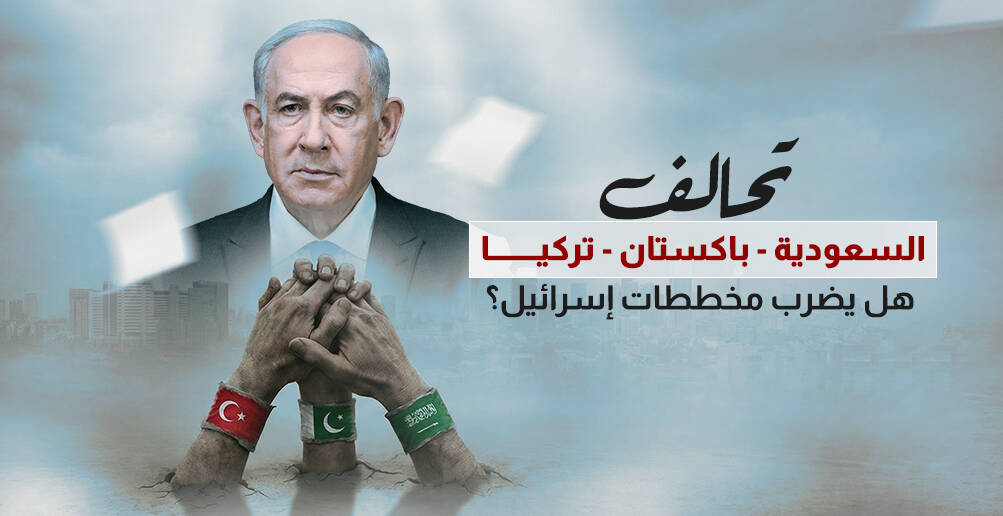من الانقلاب إلى الشرعية.. هكذا يُحكِم جنرالات إفريقيا سيطرتهم على السلطة

شهدت منطقة غرب ووسط إفريقيا موجة انقلابات منذ عام 2020 بتتابع سريع
في 12 أبريل/نيسان 2025 شاهد العالم المواطنين الغابونيين، يدلون بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية منذ سقوط سلالة بونغو، التي حكمت البلاد لما يقرب من ستة عقود.
ولكن بدلا من أن تُمثل الانتخابات قطيعة ديمقراطية واضحة مع الماضي، فقد أكَّدت ترسيخ سلطة الجنرال بريس أوليغي أنغيما، الضابط برتبة "جنرال" في القوات المسلحة، وقائد الحرس الجمهوري.
وأطاح هذا الأخير بالرئيس علي بونغو أونديمبا في انقلاب عام 2023، وشغل منذ ذلك الحين منصب الرئيس الانتقالي.
وعلى الرغم من الوعود السابقة بالعودة السريعة إلى الحكم المدني، فإن فوز "أنغيما" الساحق بنسبة 94.9 بالمئة، يُشير إلى نمط مُتزايد من ترسيخ سلطة الانقلابات، وهو ما شهدته المنطقة خلال السنوات الأخيرة. وفق مجلة فورين بوليسي الأميركية.
وقال صلاح بن حمو، الباحث المشارك في معهد بيكر للسياسات العامة بجامعة رايس الأميركية: إن "قادة الانقلابات يُعيدون صياغة تكتيكاتهم، فحتى عندما تنتهي المراحل الانتقالية بانتخابات، فإن هدفهم لا يكون الخروج من السلطة، بل ترسيخها".

نموذج يُحتذى به
وأضاف، في مقال نشرته المجلة الأميركية، أن "القادة العسكريين باتوا يتخلّون تدريجيا عن النمط السابق المتمثل في نقل السلطة سريعا إلى السلطات المدنية بعد الانقلابات".
ففي بعض الحالات جرى تمديد الفترات الانتقالية بشكل واسع وتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، كما في بوركينا فاسو ومالي.
وفي حالات أخرى، مثل تشاد والآن الغابون، استخدم قادة الانقلاب الانتخابات وسيلة لإضفاء الشرعية على استمرارهم في الحكم. لكن تداعيات هذه المناورات تتجاوز بكثير حدود السياسات الداخلية لأي دولة بعينها.
فبينما يراقب قادة الانقلابات في جميع أنحاء المنطقة بعضهم بعضا، أصبحت محاولات ترسيخ السلطة، سواء من خلال تأجيل الانتقال، أو التلاعب بالانتخابات، أو قمع قوى المعارضة الرئيسة، نموذجا يُحتذى به.
ويشير مصطلح "عدوى الانقلابات" إلى أن الاستيلاء العسكري على الحكم لا يحدث بمعزل عن السياق الإقليمي، بل يمكن أن يمتد إلى دول مجاورة.
ولا تقتصر هذه العدوى على فعل الانقلاب نفسه، بل تشمل أيضا الأساليب والتكتيكات التي يستخدمها قادة الانقلابات للبقاء في السلطة، والتي يجرى تبنّيها وتطويرها عبر الحدود من خلال مراقبة تجارب الآخرين.
وشهدت منطقة غرب ووسط إفريقيا موجةً من الانقلابات منذ عام 2020 بتتابع سريع، وذلك من مالي وتشاد إلى بوركينا فاسو وغينيا والنيجر والغابون.
ويشير بعض المحللين إلى نقاط ضعف مشتركة كأسباب جذرية لهذه الموجة، مثل ضعف المؤسسات، وسوء الإدارة، وانتشار السخط.
لكن توقيت هذه الأحداث وقربها يوحي بأمر أكثر من ذلك -وفق الكاتب بن حمو- وهو أن الانقلابات يمكن أن تؤثر على بعضها بعضا.
وقال: "المنطق هنا بسيط، فعندما يشاهد ضباط عسكريون في دولة ما انقلابا يحدث في دولة أخرى، فإنهم لا يراقبون فحسب، بل يتعلمون، ويركزون بدقة على ما ينجح وما يفشل، وعلى تفاعل المواطنين والمجتمع الدولي مع الحدث".
"فهذه الوقائع تُرسل رسائل بالغة التأثير: إذا فشل الانقلاب أو قوبل بعقوبات دولية سريعة أو رفض شعبي واسع، فقد يشكل ذلك تحذيرا، أما إذا نجح دون مقاومة تُذكر أو حظي بدعم شعبي، فإنّه يشجع ضباطا في دول مجاورة على أن يسلكوا المسار نفسه".
وأضاف: "الاستيلاء على السلطة بطريقة درامية غالبا ما يتصدر العناوين، لكنه لا يمثّل سوى البداية بالنسبة لقادة الانقلابات".
فالمرحلة الفورية التي تلي الانقلاب وهي فترة ترسيخه حاسمة في تعامل القادة مع الاضطرابات الداخلية، والمنافسين السياسيين، والضغوط الدولية.
وأظهر باحثون أن الأنظمة الاستبدادية غالبا ما تتعلم من بعضها البعض، مستعيرةً أدوات القمع والدعاية والسيطرة السياسية لترسيخ سلطتها، لكن تركيزهم الأكبر انصبَّ غالبا على الأنظمة الاستبدادية الراسخة.
وأوضح الكاتب أن ما يُغفَل كثيرا هو أن قادة الانقلابات، خاصة أولئك الذين يبرزون ضمن موجة إقليمية واحدة، غالبا ما يتبنون تكتيكات متشابهة في المرحلة الحساسة التي تلي مباشرة استيلاءهم على السلطة، كما هو الحال في سلسلة الانقلابات الأخيرة في إفريقيا.
وأردف: "في حين لا تزال التدابير التقليدية، مثل تقييد الصحافة وتهميش المنافسين، شائعة، فإن الأساليب البديلة تعكس باضطراد استفادة الجيران العسكريين من بعضهم بعضا".

سقوط قطع الدومينو
أحد الأمثلة البارزة على ذلك هو التأجيل الممنهج للانتقال الموعود إلى الحكم المدني. فقد شكّل انقلاب مالي في أغسطس/آب 2020، والذي كان أول قطعة دومينو تسقط في سلسلة الانقلابات الأخيرة، سابقة مهمة في هذا السياق.
إذ أطاح الانقلاب بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وجاء بالعقيد آسيمي غويتا إلى السلطة بداية كنائب لرئيس الحكومة الانتقالية إلى جانب الرئيس باه نداو.
لكن لم يمضِ عام حتى انفرد غويتا بالقيادة، بعد أن دبر انقلابا ثانيا أطاح بـ "نداو".
ومنذ ذلك الحين، دأبت حكومة غويتا على تأجيل الانتخابات مرارا، وقدّمت السلطات الانتقالية سلسلة من التبريرات لهذا التأجيل، من بينها "أسباب تقنية"، والحاجة إلى إعداد دستور جديد، بالإضافة إلى خلافات مع شركة "إيديما" الفرنسية المتخصصة في الأنظمة البيومترية والمسؤولة عن سجل الناخبين.
وقد مثّل التأجيل المفتوح لأحدث انتخابات رئاسية، كان من المقرر إجراؤها في فبراير/شباط 2024، خرقا جديدا للوعود السابقة، لكنّه أيضا بعث برسالة واضحة: غويتا لا ينوي التخلي عن السلطة في أي جدول زمني محدد.
ولم تغب هذه الرسالة عن نظرائه من قادة الانقلابات في المنطقة، وفق الكاتب. ففي غينيا، اتبع المجلس العسكري بقيادة العقيد مامادي دومبويا نهجا مشابها بعد إطاحته بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر/أيلول 2021.
وبرّر دومبويا انقلابه بأنه "واجب وطني لإنقاذ البلاد"، معلنا في البداية عن مرحلة انتقالية تمتد لعامين تنتهي بعودة الحكم المدني وإجراء انتخابات بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.
غير أن المجلس العسكري عاد لاحقا ليتبنى مبررات مماثلة لتلك التي ساقها الانقلابيون في مالي. مشيرا إلى ضرورة إعداد دستور جديد كذريعة لتمديد المرحلة الانتقالية.
وقد ترافقت هذه الخطوة مع حلّ عدد كبير من الأحزاب السياسية وإجبار نحو ألف عسكري على التقاعد، في مؤشرات واضحة على سعي ممنهج لتفكيك النظام السابق وترسيخ الحكم العسكري، بحسب الباحث.
وبعد إخلافه للموعد الذي تعهّد به، أثار نقض المجلس العسكري لتعهداته موجة احتجاجات، أسفرت عن تمديد جديد للانتخابات حتى ديسمبر 2025.
أما وعد دومبويا بإجراء استفتاء دستوري فلم يبعث على الاطمئنان، إذ إن غياب جدول زمني واضح يعكس إحجامه عن ترك السلطة.
وفي بوركينا فاسو، استولى المقدم بول هنري داميبا على السلطة في يناير/كانون الثاني 2022، مطيحا بالرئيس روش كابوري، ومقدما وعودا بعودة الحكم الديمقراطي من خلال قانون تأسيسي جديد يُؤكد على الحريات المدنية.
لكن بعد ثمانية أشهر فقط، أطاح به النقيب إبراهيم تراوري، الذي ادعى أن داميبا فشل في احتواء التمرد الإسلامي في البلاد، فحلّ تراوري الحكومة، وعلّق العمل بالدستور، وحوّل السلطة إلى مجلسه العسكري.
وعلى الرغم من تعهد تراوري في البداية باستعادة الحكم المدني بحلول يوليو/تموز 2024، فقد تراجع عن هذا القرار في مايو/أيار من نفس العام، ممددا الحكم العسكري لخمس سنوات، وأعلن أهليته للترشح للرئاسة.
واللافت أنَّ هذا حدث بعد أيام قليلة من فوز زعيم المجلس العسكري في تشاد، محمد ديبي، في انتخابات مثيرة للجدل.
وتولى ديبي السلطة بعد وفاة والده عام 2021، وكان قد وعد هو الآخر بمرحلة انتقالية، قبل أن يستخدم الانتخابات لترسيخ حكمه.
وها هي الغابون تسير على النهج نفسه؛ إذ استخدم أوليغي أنغيما، الانتخابات لإضفاء الشرعية على رئاسته التي جاءت بعد انقلاب عسكري.
وقال الكاتب: "تكشف هذه التحركات عن درس أوسع يتبادله قادة الانقلابات مفاده: حتى عندما تنتهي المراحل الانتقالية بانتخابات، فإن الهدف لا يكون الخروج من السلطة، بل ترسيخها".
ويمكن قياس هذا الاتجاه بوضوح؛ فمنذ عام 2020 تجاوز متوسط مدة بقاء القوات المسلحة في الحكم بإفريقيا ألف يوم، مقارنة بمتوسط لم يتجاوز 22 يوما بين عامي 2002 و2020.
وقال الكاتب: "أصبحت إعادة تنظيم السياسة الخارجية الإستراتيجية -وما يصاحبها من خطاب مناهض للاستعمار- أداة حاسمة لتعزيز ما بعد الانقلاب".

دور روسي
وباضطراد، ينأى قادة المجلس العسكري بأنفسهم عن شركائهم الغربيين التقليديين، خاصة فرنسا، متوجهين بدلا من ذلك إلى بدائل مثل روسيا، التي يأتي دعمها مصحوبا بمطالب أقل تتعلق بالديمقراطية.
ولكن، إلى جانب تقليد كل منهم لتحركات الآخر، تعكس هذه التحولات الآن تطورا أعمق وهو الانتقال من التقليد البسيط إلى التعاون والتنسيق الفعال.
وقال: "مرة أخرى، كانت مالي هي من رسمت الاتجاه، فبعد استيلاء آسيمي غويتا على السلطة، أصدرت التكتلات الإقليمية- مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي- إدانات، كما علّقت فرنسا عملياتها العسكرية المشتركة".
لكن غويتا لم يتراجع، بل غيّر المسار، فعزّز علاقاته مع روسيا، وطرد القوات الفرنسية، مستخدما في ذلك خطاب السيادة الوطنية ورفض "الاستعمار الجديد"، الغربي بطبيعة الحال.
وكان في قلب هذه الشراكة الجديدة مجموعة فاغنر الروسية، التي وصل مرتزقتها إلى مالي عام 2021 لدعم جهود مكافحة الإرهاب.
وأوضح الكاتب أنه "رغم عدم الاعتراف الرسمي بها، قدّمت مجموعة فاغنر لغويتا أكثر من مجرّد دعم ميداني في المعارك، فقد وفّرت له شريكا أمنيا مواليا وخارج الأطر القانونية ساعده في قمع المعارضة الداخلية".
وواجهت فاغنر اتهامات موثوقة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، شملت الاعتقالات التعسفية والتعذيب وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، لا سيما في القواعد التابعة للأمم المتحدة التي كانت تديرها بالاشتراك مع الجيش المالي.
وعلى الرغم من هذه الانتهاكات، ساعد هذا التحالف في ترسيخ سيطرة غويتا، وهي نزعة يُرجّح أن تستمر مع استبدال فاغنر بجهاز "فيلق إفريقيا" (Africa Corps) التابع للدولة الروسية.
وسارت بوركينا فاسو والنيجر على النهج نفسه في السنوات اللاحقة، فقطعتا علاقاتهما مع فرنسا، وفتحتا الباب أمام تحالفات جديدة مع روسيا، متبنيتين خطابا مناهضا للاستعمار لتبرير هذا التحول.
وبحلول أواخر عام 2023، أطّرت الدول الثلاث -مالي وبوركينا فاسو والنيجر- تعاونها رسميا من خلال إنشاء "تحالف دول الساحل"، وهو تكتل أُعلن صراحة أنه يهدف إلى حماية السيادة العسكرية، ومقاومة التدخل الأجنبي.
ودعا الباحث المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في كيفية التعامل مع موجة الانقلابات العسكرية في إفريقيا، خصوصا في مرحلتها الثانية التي تتسم بترسيخ الحكم العسكري لا مجرد الاستيلاء على السلطة.
ويوضّح أن التعامل مع كل انقلاب كحدث منفصل يسهم في تعزيز عدوى الانقلابات؛ حيث تتعلم المجالس العسكرية من بعضها وتكرر الأساليب التي أثبتت نجاحها في ترسيخ الحكم.
كما شدَّد على أن الاقتصار على مراقبة المواعيد الشكلية- مثل تواريخ الانتخابات أو الاستفتاءات الدستورية- يمنح المجالس العسكرية شرعية زائفة ويشجع غيرها على السير في المسار نفسه.
ويختم الكاتب بأن المرحلة الأولى من "عدوى الانقلابات" في إفريقيا جذبت الأنظار بسبب الطابع المفاجئ والانقلابات السريعة، لكن المرحلة الثانية، الأكثر هدوءا، تتمثل في ترسيخ الحكم العسكري، وهي الأخطر.
وأكد على أن وقف هذا المسار يتطلب كبح الأدوات التي تُستخدم في تعزيز بقاء العسكر في السلطة، وليس فقط ردع الانقلاب القادم.