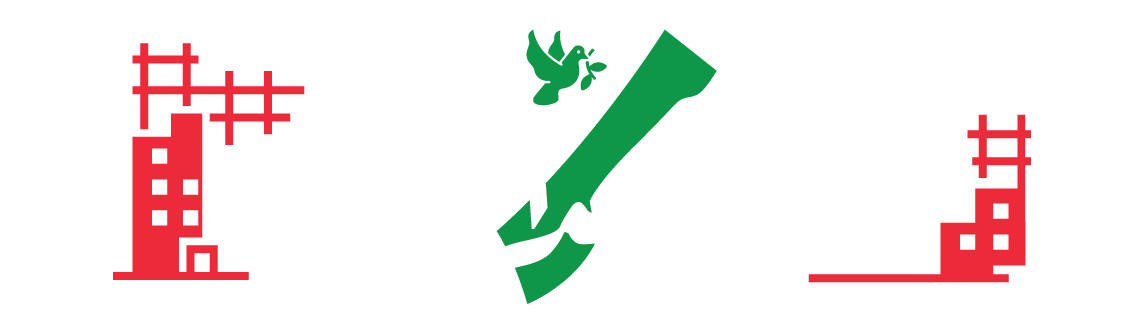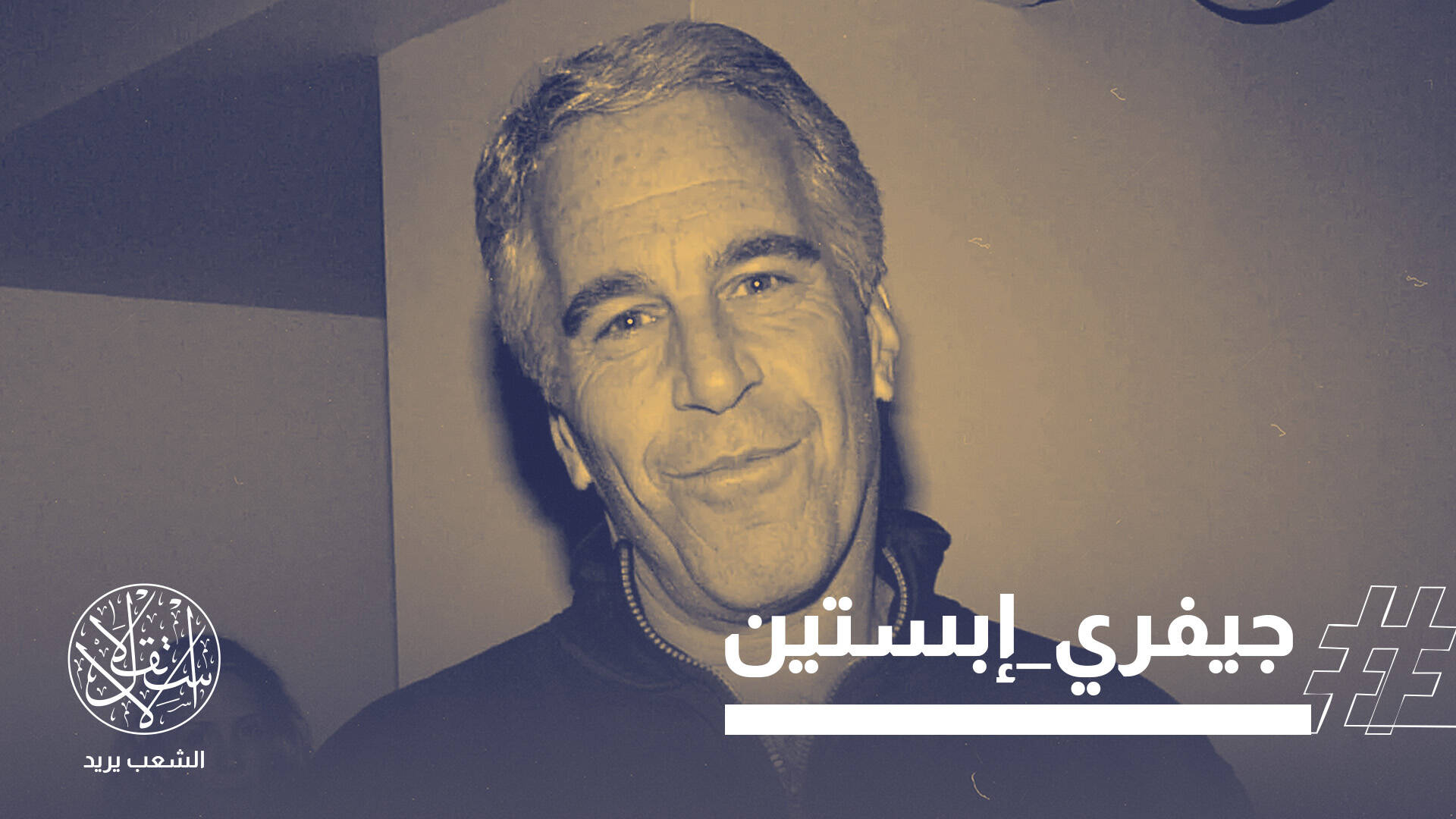خبير إيراني: "الاتفاق النووي" أمام مفترق طرق.. وضغوط إسرائيل تفاقم الوضع (خاص)

علاقة ترامب بإيران تتشكل إلى حد كبير بالتهديدات والضغوط
توقع المحلل السياسي الإيراني غدير غولكاريان أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية فيما يخص البرنامج النووي الإيراني إلى خفض التوتر الإقليمي وتمهيد الطريق نحو اتفاق محدود.
وفي حوار مع “الاستقلال”، استبعد غولديكان حدوث تطبيع شامل للعلاقات؛ بسبب الحسابات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، ورفض إيران التنازل عن أيديولوجيتها الثورية، مبينا أن الحلول ستكون تكتيكية ومؤقتة.
وتتولى سلطنة عمان دور الوساطة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لإنهاء خلافات جوهرية تتعلق بالملف النووي لطهران. وعقدت 5 جولات من المفاوضات حتى الآن، 3 منها في العاصمة العمانية مسقط.
وتسعى إيران إلى رفع العقوبات المفروضة عليها مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
وتأتي هذه التطورات في ظل جمود طويل في المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018، وسط محاولات متكررة لإعادة إحيائه بشروط جديدة من الجانبين.
ولفت غولديكان إلى أن واشنطن تقاوم حتى الآن ضغوط تل أبيب من أجل شن ضربة عسكرية ضد إيران، على تقدير أن أميركا مضطرة إلى مراعاة موازين القوى العالمية، وأن الدخول في مواجهة مباشرة سيكون مكلفا للغاية وينطوي على عواقب يصعب التنبؤ بها.
وتطرق المحلل إلى ملفات أخرى مثل علاقة إيران مع لبنان وسوريا بعد التغيرات الكبيرة لديهما، وأيضا طبيعة التفاهمات بين طهران وأنقرة في ملف حزب العمال الكردستاني وتأثيراته.
كما سلط الحوار الضوء على الأوضاع في الداخل الإيراني نتيجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والضغوط السياسية والعزلة الدولية التي يعاني منها المجتمع في السنوات الأخيرة.
والبروفيسور غدير غولكاريان محلل سياسي إيراني وعضو هيئة تدريس بجامعة الشرق الأدنى في قبرص التركية، ورئيس مركز الأبحاث الأوراسية التابع للجامعة.

إيران وأميركا
كيف تصف شكل العلاقة التي أقامها الرئيس الأميركي ترامب مع إيران منذ توليه السلطة؟ وهل يتبنى فكرا ميكافيليا؟
يمكن تعريف شكل العلاقة التي أقامها ترامب مع إيران بأنها سياسة قوة تتشكل إلى حد كبير بالتهديدات والضغوط والتحركات المفاجئة، بدلا من المسارات الدبلوماسية التقليدية.
فانسحابه من الاتفاق النووي عام 2018، وهدفه المتمثل في إسقاط الاقتصاد الإيراني بسياسة "الضغط الأقصى"، وتصريحاته المباشرة بالتهديدات العسكرية، كلها مؤشرات تدل على أن هذه العلاقة لم تُبنَ على الثقة المتبادلة، بل على إستراتيجية أحادية الجانب تقوم على القسر والإكراه.
ردود فعل ترامب في السياسة الخارجية لم تُبنَ على توازن جيوسياسي طويل المدى، بل على أهداف براغماتية مثل تعزيز موقعه في السياسة الداخلية، وكسب رضا الناخبين، وزيادة تأثيره الإعلامي.
أما الفكر الميكافيلي، فيقوم على تقدير أن استخدام أي وسيلة للحفاظ على السلطة وتحقيق الأهداف تعد مشروعة.
ومن هذا المنطلق، فإن سلوك ترامب يحمل بالتأكيد بصمات ميكافيلية، فهو سلوك قائم على المصلحة، ومتقلب، يتجاوز الحدود الأخلاقية، وأحيانا يصعب التنبؤ به.
إلا أن ميكافيلية ترامب ليست نتاج وعي نظري، بل تنبع من إستراتيجية غريزية تركز على مصلحته الشخصية.
نحن إذن أمام نسخة من الميكافيلية تشكَّلت عبر البراغماتية الشعبوية وألعاب القوة والسلطة المتمحورة حول الإعلام، وليس من خلال الذكاء الميكافيلي الكلاسيكي.
ما النتيجة المتوقعة للمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة؟ وهل ستتمكن طهران من الخروج من عزلتها الدولية؟
إذا ما اتجه الطرفان نحو بناء ثقة متبادلة، وهدفا إلى تقليل الأضرار بدلا من السعي وراء مكاسب إستراتيجية، فقد تؤدي المفاوضات غير المباشرة الجارية بين إيران والولايات المتحدة إلى خفض التوتر الإقليمي وتمهيد الطريق نحو اتفاق محدود.
إلا أن المشهد الحالي، خاصة في ظل الحسابات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، ورفض إيران التنازل عن أيديولوجيتها الثورية، يشير إلى أن الحلول ستكون تكتيكية ومؤقتة، لا تطبيعا شاملا.
ولذلك يبدو من الصعب أن تُحدث المفاوضات تحولا دراماتيكيا على المدى القصير.
ولكي تتمكن إيران من كسر عزلتها الدولية، فإن عليها استعادة ثقة الغرب عموما، وليس فقط الولايات المتحدة.
وهذا يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة في قضايا مثل حقوق الإنسان والشفافية والسياسات الإقليمية.
وعلى الرغم من محاولات إيران تجاوز العزلة جزئيا من خلال تحالفات بديلة مع الصين وروسيا، فإن تحقيق موقع حقيقي في النظام العالمي يتطلب منها التوصل إلى تفاهم بناء مع الغرب، غير أن معطيات الوضع الحالي تشير إلى أن هذا المسار سيكون بطيئا ومؤلما.
وبدورها، تدرك دول الغرب، وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، هذا الواقع وتسعى للضغط على إيران من خلاله.
فالمحادثات التي جرت قبل أسابيع بين إيران والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في القنصلية الإيرانية بإسطنبول، لم تفض إلى نتائج ذات قيمة كبيرة.

هجوم عسكري؟
إسرائيل تمارس ضغوطا على الولايات المتحدة بشأن إيران.. كيف يكون تحرك واشنطن حال استجابتها لها؟
كما هو معلوم، لطالما سعت إسرائيل إلى إشعال الحروب في بعض المناطق بهدف تأمين مصالحها، وقد نجحت بالفعل في تحقيق ذلك في دول مثل فلسطين ولبنان وسوريا.
وبحسب بعض الآراء، فقد خُطط لهذه الحروب في إطار السعي للسيطرة على "الأرض الموعودة"، إلا أن إيران لا تقع ضمن حدود هذه الأراضي.
وهنا يطرح سؤال جوهري: لماذا تسعى إسرائيل إلى شن حرب على إيران؟
والإجابة واضحة: فمن منظور السياسة الخارجية الإيرانية، تعد إسرائيل نظاما غير شرعي وكيانا احتلاليا، وتحملها مسؤولية الاستيلاء على أرض مملوكة للشعب الفلسطيني.
كذلك تؤكد طهران أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المظلومين، ما يجعل هذه النقطة محور الصدام. فبالنسبة لإسرائيل، تعد إيران تهديدا رئيسا لا يمكن تجاهله بأي حال من الأحوال.
لكن من المهم أن ندرك أيضا أن تأثير إسرائيل على الولايات المتحدة تاريخي وعميق، خاصة من خلال نشاط اللوبي الصهيوني المكثف داخل الكونغرس ووزارة الدفاع (البنتاغون)، ومراكز الأبحاث والفكر الإستراتيجية.
وتسعى إسرائيل إلى تشكيل صورة إيران بصفتها "تهديدا وجوديا"، وتستغل كل فرصة لدفع واشنطن نحو فرض عقوبات أشد، وتشديد الحصار الدبلوماسي، بل وحتى التفكير في تدخل عسكري.
ومع ذلك، فإن هذه الضغوط لا تكون حاسمة بمفردها إذا لم تتطابق مع مصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية.
فواشنطن مضطرة إلى مراعاة موازين القوى العالمية، والدخول في مواجهة مباشرة سيكون مكلفا للغاية وينطوي على عواقب يصعب التنبؤ بها.
ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن خطاب إسرائيل المؤثر، وخاصة حملاتها الإعلامية المدروسة، ينجح أحيانا في التأثير غير المباشر والتدريجي على صانعي القرار في الولايات المتحدة.
وإذا ما شهد البرنامج النووي الإيراني تسارعا مفاجئا، فقد تتحول هذه الضغوط إلى خطوات عملية.
إلا أنه من غير المرجح أن تكون هذه الخطوات على شكل تدخل عسكري مباشر، بل ستكون على الأرجح من خلال زيادة العقوبات الاقتصادية، وتكثيف الضغوط الدبلوماسية، أو دعم القوى الحليفة في المنطقة كأدوات تنفيذ غير مباشرة.
هل يمكن أن تشن الولايات المتحدة أو إسرائيل هجوما واسعا ومعلنا على إيران؟ وإن كان ذلك ممكنا، فما نوع التحرك المتوقع؟
إن تنفيذ تدخل عسكري مباشر ضد إيران يعد سيناريو بالغ الخطورة ومرتفع التكلفة، خصوصا من منظور الولايات المتحدة.
فالتجارب السابقة في العراق وأفغانستان لا تزال حاضرة في الأذهان، ومهاجمة دولة كبيرة وقوية مثل إيران، تمتلك قدرة عالية على خوض حروب غير متماثلة، سيُفضي إلى عواقب تتجاوز الجانب العسكري، تشمل أيضا زعزعة الاستقرار الإقليمي، وأزمات في الطاقة، وانهيارات دبلوماسية.
لذلك، من غير المرجح أن تقدم الولايات المتحدة على غزو مباشر أو شن حرب شاملة ضد إيران.
ومع ذلك، إذا لم تسفر المفاوضات الجارية عن نتائج ملموسة، فمن المتوقع استمرار بعض أشكال التهديد.
إذ ستكون التدخلات المستترة والمركزة -مثل الضربات الجوية والعمليات السيبرانية والاغتيالات، أو أعمال التخريب الاقتصادي- أدوات مطروحة على الطاولة.
أما من الجانب الإسرائيلي، فإن احتمال تنفيذ عمليات محدودة ورمزية ضد إيران يبدو أكثر واقعية، وقد سبق أن ألحق بعضها أضرارا بالفعل.
فالهجمات الدقيقة على منشآت نووية، واستهداف علماء بارزين، أو تنفيذ عمليات ذات طابع إعلامي لافت عبر وكلاء جرى تدريبهم وتوجيههم، هي من بين السيناريوهات المحتملة.
وإذا اندلع صراع واسع، فلن يكون على شكل مواجهة جبهات مباشرة، بل سيأخذ طابع الحرب الاستنزافية عبر تكتيكات هجينة وحروب بالوكالة وتحركات مجزأة.
ورغم أن خيار الحرب المفتوحة يبقى مطروحا كـ "حل أخير"، فإن تخطي هذا الحد يتطلب أزمات عالمية حادة، ولن يتم بسهولة.
ولذلك فإن وقوع مثل هذا السيناريو لن يهدد وجود إسرائيل فحسب، بل سيجعل جميع المصالح والقواعد العسكرية الأميركية، في الدول الإقليمية، أهدافا مباشرة.
بل يمكن القول دون مبالغة إن نتائج جولة ترامب في الخليج (مايو/أيار 2025) ستنسف تماما في حال نشوب هذا الصراع. ولذلك فإن الولايات المتحدة لا تستطيع المجازفة بتحمل مثل هذا الخطر.

الداخل الإيراني
نظرا للصعوبات الاقتصادية، بدأ المجتمع الإيراني في التعبير عن بعض الاعتراضات.. كيف ينظر إلى المفاوضات في هذه المرحلة؟
يمر المجتمع الإيراني بمرحلة تحول عميقة نتيجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والضغوط السياسية والعزلة الدولية التي يعاني منها في السنوات الأخيرة.
فارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر زاد من صعوبة الحياة اليومية، ما عزز المطالب الإصلاحية، خاصة في أوساط الشباب والطبقة الوسطى.
ويُعد هذا أحد الأسباب الرئيسة التي تقف خلف فوز مسعود بيزشكيان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إذ تعكس نتائجه رغبة شعبية في التغيير.
وبالتالي، فإن شريحة كبيرة من الإيرانيين تعقد آمالا على أن تقود المفاوضات الدولية إلى إنهاء العزلة وتحقيق انفراجة اقتصادية.
ومع ذلك، فإن التجارب السابقة والبنية السياسية الحالية تدفع بالكثيرين إلى الحذر. فالإيرانيون يدركون أن فشل المفاوضات قد يؤدي إلى أزمة أعمق.
ولهذا السبب، ترتفع في المجتمع أصوات تطالب بتغييرات إصلاحية وجذرية على حد سواء. فالشباب الإيراني، على وجه الخصوص، يحلم بإيران أكثر انفتاحا وحرية واندماجا مع العالم.
وفي هذا السياق، فإن نتائج المفاوضات ستكون حاسمة ليس فقط في مسار السياسة الخارجية، بل أيضا في تشكيل الديناميات الداخلية.
لكن من المهم أن نشير أيضا إلى أن إيران، وعلى مدار سنوات طويلة، تأقلمت مع العقوبات ونجحت في التكيف مع الواقع المفروض.
ولعل المثل الإيراني القائل: "لا لون غير السواد"، يلخص نظرة الكثير من الإيرانيين؛ فهم يعيشون بالفعل أوضاعا قاسية، وبالتالي فإنهم مستعدون للتكيف مع ما هو قادم، وإن كان أسوأ.
غير أن العالم والمنطقة قد لا يتمكنان من تحمل المزيد من الاضطراب، كما أن السلام والاستقرار في المنطقة والعالم لن يتحققا بسهولة مرة أخرى.
العلاقات مع تركيا
ما نقاط التصادم والالتقاء بين تركيا وإيران، لا سيما في الملف السوري؟
تعد تركيا وإيران فاعلين إقليميين لطالما اتسمت علاقتهما بمزيج من التنافس والتعاون عبر التاريخ. وفي الملف السوري تحديدا، ازدادت العلاقة تعقيدا.
فبينما أبدت إيران دعما عسكريا ولوجستيا مباشرا للنظام السابق برئاسة بشار الأسد، دعمت تركيا على مدى سنوات الفصائل المعارضة له، ما وضع الطرفين في موقفين متضادين في ساحة النزاع السوري.
وقد تحولت سوريا إلى ساحة صراع جيوسياسي بين البلدين، خاصة في مناطق مثل إدلب وتل رفعت ودير الزور، حيث تقع مواجهات متكررة بين الفصائل المدعومة من تركيا والمليشيات الموالية لإيران.
ورغم ذلك، نجحت أنقرة وطهران في الجلوس على طاولة واحدة ضمن منصات دبلوماسية متعددة الأطراف، مثل "مسار أستانا" للحل السياسي، انطلاقا من المصالح المشتركة.
فكلاهما يعارض الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، ويتشاركان في القلق من صعود قوات مثل حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.
وعليه، فإن العلاقة بين الطرفين في سوريا تتسم بتوازن ديناميكي يجمع بين التنافس الميداني والحوار الدبلوماسي القسري.
وفي المرحلة المقبلة، ستواصل التوازنات الإقليمية ومواقف القوى الكبرى التأثير في مسار هذه العلاقة المعقدة.
بعد حل حزب العمال الكردستاني نفسه في تركيا.. ما التأثير المحتمل لهذا التطور على فرعه في إيران؟
يُعرف حزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك) بكونه الامتداد الإيراني لحزب العمال الكردستاني، وقد تسبب لسنوات في اشتباكات مسلحة متقطعة على الحدود الغربية لإيران.
ولا تقتصر مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب" التي أطلقتها أنقرة على تأثيرها في السياسة الداخلية، بل تمتلك أيضا قدرة مباشرة على التأثير في بنية الأمن الإقليمي.
وإذا ما عد إعلان العمال الكردستاني عن حل نفسه خطوة حقيقية ودائمة، فقد يؤدي ذلك إلى تصاعد الضغط السياسي والعسكري على "بيجاك".
بالنسبة لإيران، يعد هذا التطور إيجابيا من حيث أمن الحدود، وقد تسعى طهران لاستثماره من أجل إدارة ملف الأكراد داخلها بشكل أكثر انضباطا.
إلا أن مقاربة إيران تختلف عن تركيا، فهي لا ترى في حزب الحياة الحرة مجرد تهديد أمني، بل تعده أحيانا أداة توازن إقليمي في مواجهة حكومات أخرى.
وفي حال توقّف تنظيم "بيجاك" عن نشاطه بالكامل، فقد يُسهم ذلك في تعزيز السلم الداخلي الإيراني.
لكن النظام الإيراني سينتظر ليرى ما إذا كانت خطوة الـ "بي كا كا" في تركيا حقيقية ومستدامة، ثم يقرر بناء على ذلك كيفية التعامل مع أذرعه الداخلية.
باختصار، من الممكن نظريا أن نشهد عملية "حل" مماثلة داخل إيران، لكن ذلك سيكون في وقت لاحق، وبما يتماشى مع الديناميات الداخلية الإيرانية.
وهنا فإن تصريحات مسعود بارزاني (زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ) خلال زيارته الأخيرة إلى طهران، التي قال فيها بوضوح: إن "منطقة شمال العراق وإقليم كردستان لن تشكلا أي تهديد لإيران بعد الآن"، كانت بمثابة مؤشر مشجع ولو بشكل نسبي.

سوريا ولبنان
فقدت إيران نفوذها في منطقتين مهمتين هما سوريا ولبنان.. كيف ستعيد تشكيل حزب الله؟ وما شكل علاقتها مع الدولة اللبنانية؟
تعد إيران حزب الله أداتها الإستراتيجية الأهم في لبنان، ليس فقط كقوة عسكرية، بل أيضا كوسيلة نفوذ أيديولوجية وسياسية وثقافية.
غير أن السنوات الأخيرة شهدت تدهورا في البيئة السياسية اللبنانية: أزمة اقتصادية خانقة، وتراجع في تقبل الشارع للجماعات المسلحة، وتصاعد الضغوط الدولية. وكل هذه العوامل أضعفت بشكل ملحوظ شرعية حزب الله.
أمام هذا الوضع، تدفع الظروف إيران لبناء نموذج جديد لحزب الله، يتسم بمرونة أكبر وبنية مزدوجة.
فمن جهة، الحفاظ على القدرات العسكرية لمواجهة إسرائيل، ومن جهة أخرى، تقديم صورة حزب سياسي "لبناني" أكثر شرعية، يسعى إلى كسب الدعم الشعبي.
كما أن شكل العلاقة بين إيران والدولة اللبنانية سيتأثر بهذه التحولات. فلم تعد طهران قادرة على لعب دور الآمر الناهي المباشر، بل باتت مضطرة لتبني دور "الفاعل من الخلف"، مستخدمة أدوات دبلوماسية واقتصادية، مع الحرص على موازنة القوى المحلية.
ستواصل إيران دعم حزب الله كـ "فاعل غير حكومي"، ولكنها في الوقت نفسه ستعمل على تطوير علاقاتها مع مؤسسات الدولة اللبنانية الرسمية، بهدف تجنب أن تصبح هدفا مباشرا.
وهذه الإستراتيجية لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت، من وجهة نظري، ضرورة لبقاء النفوذ الإيراني في المنطقة.
إيران تحاول بناء مسار خال من المشاكل في نمط علاقاتها مع إدارة سوريا الجديد.. ما المتوقع في العلاقات بينهما؟
يمكن القول: إن جدول أعمال إيران تجاه الإدارة الجديدة في سوريا يقوم على ثلاثة أهداف أساسية.
أقول "يمكن" لأن أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع الرئيس السوري الانتقالي) لا يعد، من وجهة نظر إيران، شخصية شرعية.
فهو -بالنسبة لها- زعيم جماعة مصنفة إرهابية تسبب في إراقة الدماء لسنوات، وبلغ موقعه الحالي عبر دعم بعض القوى الخارجية.
وعلى الرغم من أن بعض الدول باتت تتعامل معه وتُجري لقاءات معه، فإن طهران ما زالت تترقب الوضع وتقيمه.
وبناء عليه، يمكن القول إن إيران لن تبادر إلى إقامة علاقات دبلوماسية إلا بعد أن تتولى حكومة شرعية وشاملة الحكم في سوريا.
أما في الوقت الراهن، فيرتكز موقف إيران في سوريا على ثلاث نقاط رئيسة: ضمان استمرارية النظام الحالي، والحفاظ على النفوذ الشيعي، والحصول على حصة من المشاريع الاقتصادية والتجارية. هذه هي محددات السياسة الإيرانية في الوقت الراهن هناك.
ملفات أخرى
ما موقف إيران من التوتر القائم بين باكستان والهند المجاورتين لها؟
سعت إيران إلى اتخاذ موقف متوازن وحذر من التوتر بين باكستان والهند، عبر تبني دور الوسيط تارة، والتشديد على أهمية حفظ التوازن الإقليمي تارة أخرى.
وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما كان نائبا للوزير، جولة دبلوماسية إلى عاصمتي البلدين عقب تصاعد التوتر، حيث أجرى لقاءات مع مسؤولين من كلا الطرفين.
وذلك لأن الحفاظ على علاقات دبلوماسية سلمية بين الهند وباكستان يعد أمرا بالغ الأهمية لأمن إيران الإقليمي.
ورغم أن لإيران علاقات تاريخية مع الهند في مجالات الاقتصاد والطاقة، فإن علاقتها مع باكستان تستند إلى تقديرات مذهبية، وتعاون في أمن الحدود ومكافحة الإرهاب، وهي تقديرات لا تقل أهمية.
ولهذا، فضلت إيران عدم الانحياز العلني لأي طرف، وتبنت خطابا يدعو إلى الاستقرار الإقليمي.
ويكمن خلف هذا الموقف الحرص على منع أي اضطراب في جنوب آسيا من التمدد إلى حدودها الشرقية، إضافة إلى الحفاظ على فرص الاستثمار المرتبطة بمبادرة "الحزام والطريق" الصينية، والتي تمر عبر محور إيران-باكستان-الهند.
فالسلام في هذا الممر له أهمية حيوية بالنسبة لإيران من حيث ممرات النقل الإستراتيجية وأمن الحدود.
كيف تؤثر العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة على خيارات إيران؟
العلاقات السعودية الأميركية تمثل تهديدا مباشرا لإيران ولكنها في الوقت نفسه تفتح مجالا لفرص غير مباشرة.
فإذا استمرت هذه العلاقات في عمقها الإستراتيجي، واستمرت واشنطن في الحفاظ على وجودها العسكري في الخليج، فإن هذا يعد بمثابة طوق حصار لإيران.
لكن مؤشرات الانسحاب التدريجي للولايات المتحدة من الخليج، وميول السعودية نحو تخفيف التوتر وبناء علاقات مع كل من الصين وإيران، توفر لطهران مساحة جديدة للمناورة.
وبدورها، تسعى طهران إلى استغلال هذه الفراغات من خلال تفعيل أدوات الدبلوماسية الإقليمية والدبلوماسية الطاقوية.
وبالتالي، فإن كل صدع في العلاقات السعودية الأميركية يمثل فرصة لإيران لتوسيع نفوذها، وكل تقارب بينهما ينظر إليه كخطر جيوسياسي يستوجب الاستعداد له.
فالمملكة العربية السعودية تظل فاعلا إقليميا بالغ الأهمية، ويجب على إيران أن ترصد بدقة تحركات منافسيها.