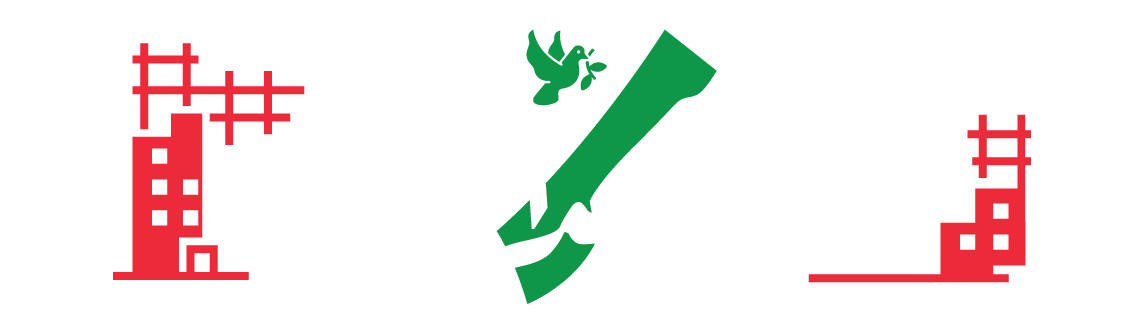رؤية 2030 السعودية.. كيف أعادت رسم العلاقة بين الرياض وواشنطن؟

"رؤية 2030 ليست شعارا بل طريقة جديدة لاستخدام المال العام"
سلط معهد دراسات إيطالي الضوء على ما وصفه بـ"التحول الإستراتيجي" في رؤية المملكة العربية السعودية للتعاون الاقتصادي مع الأطراف الخارجية لا سيما مع الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح المعهد الإيطالي لتحليل العلاقات الدولية أنّ "فهم التحول الجاري في العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية يبدأ من الصورة التقليدية التي حكمت هذه العلاقة لعقود طويلة".
فطوال عقود، كان المحور بين البلدين بسيطا وواضحا: كانت الرياض تؤمّن النفط للأسواق العالمية، وكانت واشنطن تضمن الأمن والتكنولوجيا العسكرية.
ويضيف المعهد أن الشركات الأميركية الكبرى كانت تبيع المنصات والخدمات والاستشارات، بينما كانت عائدات النفط، المعروفة باسم "البترو دولار"، تتّجه إلى الخارج لتُستثمر في السندات والعقارات وحصص الشركات داخل المراكز المالية الغربية.
فقد بقيت المشاريع والبنى التحتية في الداخل السعودي، لكنّ جوهر القيمة -أي الملكية الفكرية، وسلاسل الإنتاج، والمهارات الأساسية- ظلت بالخارج.
ويشير إلى أنّ "هذا النموذج عمل بكفاءة طالما استطاعت المملكة النمو اعتمادا على عائدات الطاقة، لكن حين أصبح واضحا أن المستقبل الاقتصادي لا يمكن أن يقوم فقط على تصدير المحروقات، قرّرت الرياض أن تغير المسار".
وفي هذا السياق، يلفت المعهد إلى أن "نقطة التحول كانت رؤية 2030، البرنامج الضخم للتحول الاقتصادي الذي أطلقته القيادة السعودية".
وأوضح أن "رؤية 2030 ليست شعارا، بل طريقة جديدة لاستخدام المال العام، فلم يعد الهدف مجرد شراء ما تحتاجه المملكة من الخارج، بل جذب المصانع ومراكز البحث والخبرات الإدارية وسلاسل التوريد إلى داخل البلاد".
ويضيف أن "جوهر الفكرة هو الاحتفاظ برأس المال والدماغ معا؛ لأن الثروة في الاقتصاد الحديث لا تكمن فقط في المنتج النهائي، بل في القدرة على تصميمه وتصنيعه وتطوير عملياته وتدريب الكفاءات القادرة على تطويره مستقبلا".
ويخلص إلى أن "الرسالة التي توجهها الرياض إلى شركائها أصبحت واضحة: إذا كنت تريد أن تعمل معنا، فلا تكتفِ بالبيع لنا. تعالَ وابنِ معنا هنا، على أرضنا".

قواعد شراكة جديدة
يوضح المعهد أن الحديث عن "التوطين الصناعي" في السعودية لا يشير إلى مجرد دعوة عامة لتوظيف مزيد من العمال المحليين.
بل يشير إلى تغيير حقيقي في القواعد التي تحكم كل مناقصة حكومية وكل شراكة إستراتيجية، بحيث تُوجَّه نحو الإنتاج داخل المملكة، وتدريب الكفاءات السعودية، ونقل العمليات والملكية الفكرية بشكل منظم.
وذكر أن المملكة أنشأت برامج ووضعت معايير تحدد فعليا من سيفوز بأي عقد. فلم يعد السعر أو السجل الدولي وحدهما هما الفيصل، بل مقدار القيمة التي تبقى وتنمو داخل السعودية.
ويشرح المعهد أن هذا أشبه بـ"نظام استحقاق معكوس": لا يفوز من يجلب المنتج الأكثر بريقا، بل من يثبت أنه قادر على ترسيخ سلاسل توريد وكفاءات ومعرفة داخل السعودية.
وبحلول عام 2024، بلغ المحتوى المحلي في العقود العامة ما يقارب نصف القيمة الإجمالية، والهدف المتوسط المدى هو تجاوز هذه النسبة، لترسيخ هذا التحول وجعله القاعدة الجديدة بدلا من الاستثناء.
وبين المعهد أن صندوق الاستثمارات العامة لم يعد مجرد مستثمر عالمي ضخم، بل أصبح يتصرف كـ"مطور صناعي مشارك"، فهو لا يشتري ببساطة حصصا في الشركات، بل يشغل قطاعات صناعية جديدة.
وأردف: "ففي مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين الإستراتيجي والرعاية الصحية والطاقة وتحويل المواد، يدخل الصندوق كشريك طويل الأمد، ويعمل على تقليل المخاطر للمستثمرين الأجانب".
كما "ينسق الحوافز والطلب العام، ويصر -قبل كل شيء- على وجود هياكل صناعية ملموسة: مصانع ومراكز صيانة وإصلاح ومختبرات أبحاث وتطوير".
ويشير المعهد إلى أنه في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، يبرز التوجه نحو المشروعات المشتركة التشغيلية، بل وإطلاق عروض أولية لشركات وطنية "رائدة"، ما يدل على أن النظام البيئي لم يعد في مرحلة التأسيس، بل بدأ التوسع والتصعيد الصناعي.
ويؤكد أن الأثر المتسلسل لهذا النهج واضح، فوجود مرتكز حكومي قوي يقلل من المخاطر التي يدركها المستثمرون، ويسهل تمويل المشاريع ويسرع بناء سلاسل توريد محلية قادرة على الالتزام بالمعايير الدولية.
كما تحدث المعهد الإيطالي عن التكنولوجيا الحساسة؛ أي أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني. مشيرا إلى أن الابتكار هنا ليس فقط في نوع المشاريع، بل في أسلوب تنفيذها.
فقد بدأت السلطات الأميركية بإعادة ضبط أدوات الرقابة على الصادرات عبر نهج أكثر دقة وتحديدا بحسب كل بلد، مما يسمح بالتعاون مع الشركاء الموثوقين في إطار ضوابط واضحة.
وهذه الضوابط تشمل حدود الاستخدام، وحماية الملكية الفكرية، ومتطلبات معالجة البيانات، وعمليات التدقيق الأمني، وتتبع سلاسل الإمداد.
ويشرح أن هذا لا يعني إطلاقا منح "ضوء أخضر" مطلق، بل بناء إطار أمني اقتصادي وتكنولوجي يمكن من خلاله إنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي داخل السعودية، وخطوط لتعبئة واختبار المكونات، ومنصات برمجية وخدمات مُدارة، ومراكز يدرَّب فيها المهندسون والفنيون وتجرَّب فيها التطبيقات.
والنتيجة -كما يؤكد- هي أن "التعاون لم يعد نظريا، بل يتجسّد في بنى تحتية وأشخاص وعمليات معتمدة".

إطار سياسي مواز
من جانب آخر، لفت إلى أن "الإطار السياسي والمؤسسي يسير الآن بالتوازي مع المضمون الصناعي".
وذكر أنّ "المنتديات الثنائية والبعثات الاقتصادية ومذكرات التفاهم القطاعية أصبحت أكثر من مجرد استعراض إعلامي، وتحولت إلى جداول زمنية عملية تتضمن مراحل ومسؤوليات ومؤشرات أداء قابلة للقياس".
ويُضيف أنّ العقود التي كانت تُبرم سابقا على شكل "تسليم مفتاح"، باتت تُستبدل اليوم بـ"اتفاقيات محددة الشروط تحدد نسب المحتوى المحلي وأهداف السعودة ومراحل نقل التكنولوجيا ومؤشرات الأداء في الجودة والأمن والامتثال السيبراني".
وفي قطاع الطاقة، يترجم الأمر إلى خطوط إنتاج وتطوير مشتركة للمركبات والجزيئات والمواد.
أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فيترجم إلى مصانع بيانات ومنصات تطبيقية محلية. وفق المعهد.
وتابع: "وفي مجالي الدفاع والأمن، يترجم إلى دورات متكاملة للصيانة والإصلاح والتجديد وإلكترونيات متقدمة تُنتج داخل البلاد".
وفي الخدمات الرقمية، يترجم ليس لمجرد مكاتب تجارية إقليمية، بل مراكز تشغيلية وتقنية حقيقية.
ويخلص إلى أن "كل اتفاق من هذا النوع ينقل جزءا من القيمة إلى داخل المملكة، ليكوّن في النهاية فسيفساء جديدة من الاستقلال الصناعي، حيث تتحول التبعية للاستيراد إلى تشابك إنتاجي متبادل".
ويؤكد المعهد أن "هذا هو جوهر التغيير الحقيقي في الوضع القائم، فهو ليس تعديلا شكليا، بل خلق آليات تُجبر جميع الأطراف -العامة والخاصة، المحلية والأجنبية- على التفكير بعقلية الإنتاج والتعلم داخل السعودية".
فالمنظومة القديمة التي كانت تسير على خط واحد "ادفع-استورد-استهلك" تتراجع، لتحل محلها حلقة جديدة في المملكة وهي "صمم-ابنِ-درب-ابتكر".
وحين تصبح الاستدامة جزءا من العلاقة، أكّد المعهد أن الاستقرار الجيوسياسي يزداد؛ وذلك لأن "المصنع والمختبر وسلسلة التوريد والجيل المدرب لا يمكن نقلها بمرسوم، بل تُحمى وتُطور وتُوسع".

السعي للاستقلال
وفي تحليله لأسباب هذا التحول، يقول المعهد: إن القوة الأولى التي تحرّكه هي السعي السعودي إلى الاستقلال الإستراتيجي.
ففي الاقتصاد الواقعي "ليست كل الاقتصادات متكافئة: هناك من يمتلك التقنيات الحرجة وهناك من يشتريها، ومن يضع المعايير ومن يخضع لها".
وذكر أن "المملكة أدركت أن البقاء طويلا في الفئة الثانية يجعل الاقتصاد الوطني مكشوفا أمام الصدمات الخارجية؛ مثل الحروب التجارية والعقوبات وانقطاع الإمدادات، أو القواعد الجديدة على الصادرات، وهي عوامل يمكنها أن تشل قطاعات كاملة".
وتابع: "لمواجهة هذا الخطر، اختارت السعودية بناء أجزاء أساسية من سلسلة القيمة داخل حدودها: مختبرات ومنصات بيانات للذكاء الاصطناعي، وخطوط إنتاج لأشباه الموصلات الخفيفة، وقدرات أمن سيبراني مدمجة في البنى التحتية الحيوية، ودورات صيانة وإصلاح كاملة للأنظمة الدفاعية المعقدة".
ويلفت إلى أنّ "الهدف ليس الاكتفاء الذاتي المطلق -وهو أمر غير واقعي وغير فعال- بل تحقيق سيادة تشغيلية: أي القدرة على الاستمرار في العمل والابتكار والنمو حتى في الأوقات المضطربة دوليا".
وهو ما يعني "نقل مركز الثقل من الاعتماد الكامل إلى الاعتماد المتبادل القابل للتفاوض؛ عبر مزيد من المعرفة المحلية والكفاءات المدربة والعمليات والمهارات المتجذرة في المملكة، والتي لا يمكن استنساخها في يوم وليلة".
أما القوة الثانية -كما يضيف المعهد- فهي الارتباط الثنائي العميق مع الولايات المتحدة.
وأوضح أن العلاقة القائمة على البيع بنظام "المفتاح الجاهز" تكون هشّة نسبيا، فإذا تغير المزاج السياسي أو برزت خلافات، يمكن ببساطة تأجيل طلب أو إلغائه، وتنتهي القصة.
"لكن على النقيض من ذلك، يخلق الإنتاج المشترك تشابكا من المصالح يجعل أي تراجع خطوة مكلفا للغاية". وفق المعهد.
ومع ذلك، يؤكد أن "ما سبق لا يلغي الخلافات، لكنه ينقل العلاقة إلى أرضية تكون فيها التسوية أكثر منطقية من الانفصال".
وتابع: "بالمصطلحات الجيوسياسية، يعني ذلك تحويل التحالف من إطار سياسي عسكري إلى بنية اقتصادية صناعية: أي علاقة لا تقوم على التعاون فقط، بل على التطور المشترك".
"وكلما ازداد البناء المشترك، عمل الزمن لصالح الاستقرار؛ لأن إيقاف مصنع أو تفكيك مركز أبحاث ليس كإلغاء صفقة توريد، فالأمر ينطوي على تكاليف اقتصادية واجتماعية وسمعة ضخمة يجب على صناع القرار احتسابها".
أما القوة الثالثة -كما يورد المعهد الإيطالي- فهي المنافسة العالمية على رأس المال والملكية الفكرية.
وأوضح أن "المال اليوم لا يبحث فقط عن العائد، بل عن أنظمة بيئية تحمي ذلك العائد من خلال حواجز دخول مكونة من المهارات والشبكات والمعايير والوصول إلى الطلب العام والدعم التنظيمي".
ويشير إلى أن "السعودية -وقد أدركت هذه الديناميكية- تستخدم أدوات ملموسة للغاية تتمثل بـ"حوافز ضريبية مستهدفة، ومناطق اقتصادية خاصة تقلل العوائق التشغيلية، وبرامج شراء حكومية ضخمة تضمن طلبا طويل الأمد، وأيضا الاستعداد للاستثمار المشترك لتقليل المخاطر على الشركاء".
ويصف المعهد الرسالة الموجهة إلى رأس المال الدولي بأنها بسيطة وواضحة: "لا تأتِ لتضع علامة رمزية، بل تعالَ لتنمي جذورا اقتصادية حقيقية".
ومن الجانب الأميركي، تتناغم هذه الفلسفة مع الحاجة إلى إعادة توطين مراحل حساسة من سلاسل القيمة في دول صديقة موثوقة، خاصة في قطاعات الطاقة المتقدمة والرقمنة والأمن.
فإذا أصبح الخليج مركزا تتحدث فيه المعايير والامتثال وحماية الملكية الفكرية بلغة مألوفة للصناعة الأميركية فإن "رأس المال الأميركي لن يأتي فقط للبيع، بل سيأتي ليبني الآلات والعقول والبرمجيات داخل بيئة تضاعف قيمتها بمرور الوقت".
هذه القوى الثلاث لا تمثّل مجرد تعديل تكتيكي، بل تحول في المسار بأكمله. حسب المعهد.