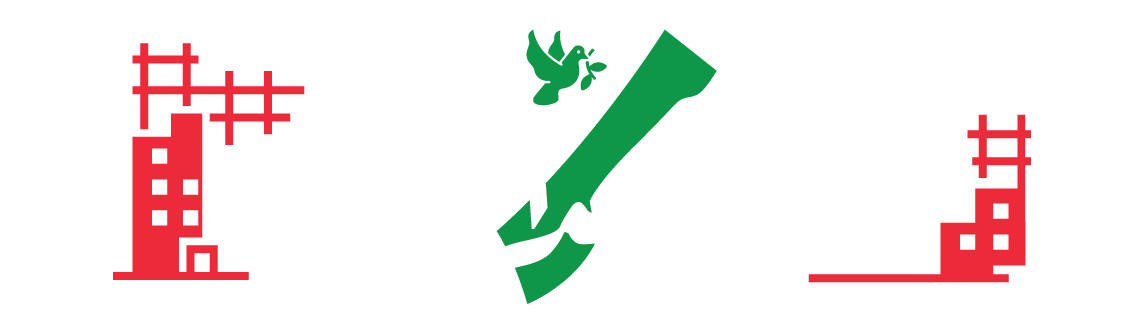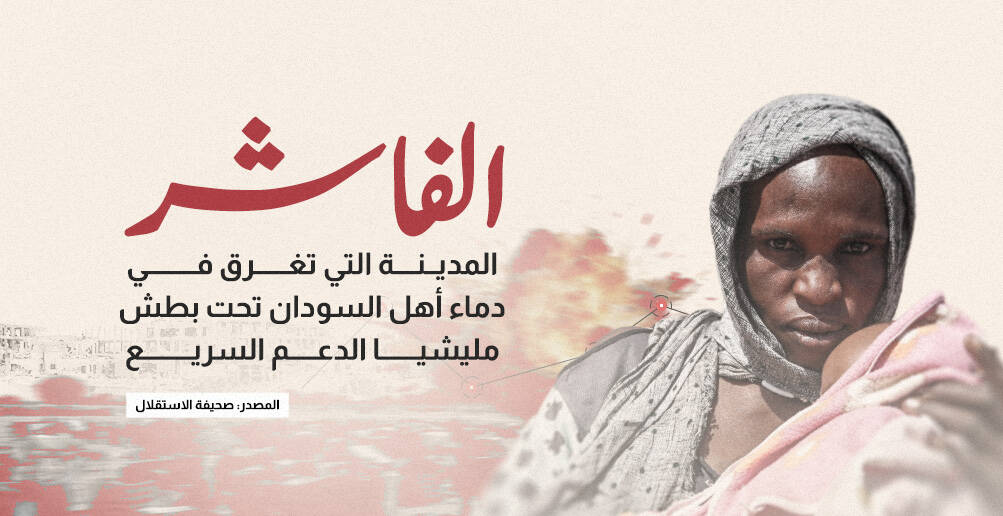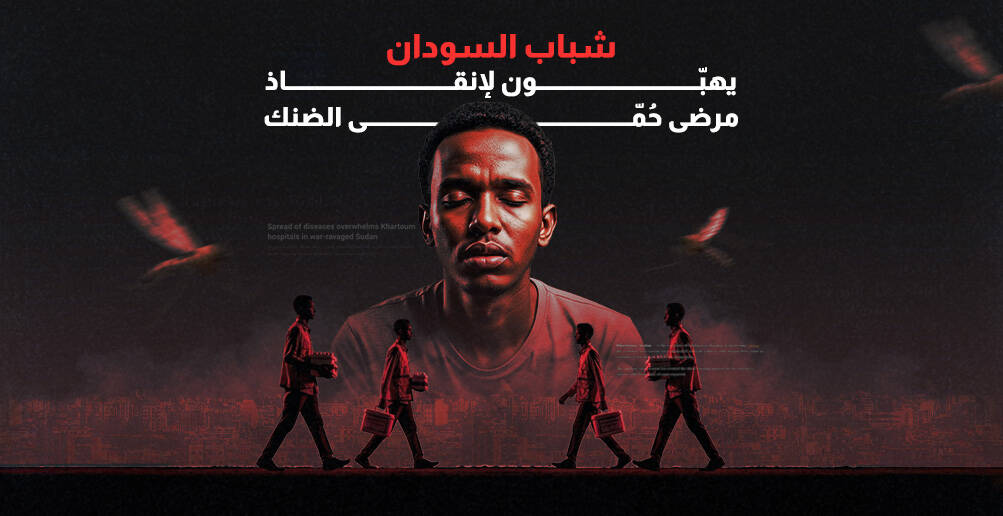تجلية المفاهيم المغلوطة في الحياة المصرية المعاصرة

من أهم مداخل الثقافة ضبط المفاهيم حتى تنصرف الكلمة إلى مفهوم محدد عام متفق عليه بأن يفهم المتلقي المعني كما أراده المرسل وألّا يكون مفهوما ذاتيا مضمرا في ضمير المتكلم أو الكاتب بينما يفهمه المتلقي فهما مخالفا. والمسافة الفاصلة بين المفهوم والكلمة تتسع عادة لتشكل حائطا أو مانعا عقليا ولغويا بين المتخاطبين وتزداد هذه الظاهرة وضوحا كلما كان المتخاطبون من بيئات مختلفة داخل الدولة أو بين الدول. وأبرز الأمثلة على ذلك هو أن معظم المفاهيم السياسية التي تستخدمها النخب المصرية مثل العلمانية والليبرالية وغيرها لم يتم وضع المفهوم المصري لها.
كما أن المفهوم الذي ظهرت فيه مع الكلمة مفهوم أجنبي في مجتمع أجنبي وفي سياق مختلف؛ وأبرز الأمثلة فكرة فصل السياسة عن الدين أو فصل الدين عن الدولة، بحجة أنه لا يجوز للدول أن يكون لها دين وهذا فهم خاطئ للمسألة برمتها؛ ثم أنه فهم مغرض يخفي في طياته الكثير من الأغراض السياسية وتسبب في مشاكل عدة، وربما ببراءة بين المتخاطبين في مصر خاصة عندما يكون الإلحاد من صفات المثقف والمتحضر، وأن يكون التخلف من نصيب المتدين حتى ظهر اتجاه في الدراسات الغربية، يعتبر أن الدين خاصة الإسلام وحده هو سبب تخلف الدول الإسلامية وهذه قضية أخرى لا نريد أن نترك السياق العام للرد عليها، وبيان سفاهتها ويكفينا في هذا المقام مفاهيم وسلوك نماذج مشرفة بالمقاييس الغربية وهما تركيا وماليزيا.
وقد سادت في مصر مفاهيم غريبة ومستفزة وعصية على الفهم تصدر ممن يروجون الجهل، وهي البيئة المثالية لتقسيم المجتمع بين سادة وعبيد بمعيار تعسفي لا علاقة له بتقسيم المجتمعات، وحسبنا أن نلقي نظرة تاريخية على كيفية فهم الحاكم العسكري في مصر منذ عام 1952 للعدالة الاجتماعية فقد فهمها عبدالناصر في شكل لم يعجب السادات وفهمها حسني مبارك في شكل مختلف في طريقة توزيع الثروة ثم فهمها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل آخر.
وبصرف النظر عن مفهوم العدالة الاجتماعية عند كل هؤلاء فمن الواضح أنها خلفت لنا مجتمعا معقدا في تركيبته وفي قيمه البعيدة أصلا عن كافة قيم المجتمعات المتحضرة مثل العمل والأمانة والصدق والإجادة والصراحة والشفافية، التي تقوم عليها المجتمعات المستقرة ولكن تبقى كلمة العدالة الاجتماعية مفهوما مخيفا بالنسبة لطبقة تستحوذ على المزايا ولا تريد إعادة توزيع الثروة، ولكن هؤلاء جميعا اتفقوا في هامش واحد وهو أن أتباع النظام طبقة وأتباع الوطن طبقة أخرى بدرجات ونسب متفاوتة، وفي هذه المقالة نختار ثلاثة مصطلحات لضبطها، على أن نستمر في رصد بقية المصطلحات التي تشبعت بها الحياة المصرية المعاصرة.
المصطلح الأول: هو وصف سيادي لكل ما يتعلق بالوضع الغامض الذي لا يجوز تحري مصدره فيقال مصدر سيادي وصندوق سيادي ويقال جهة سيادية أي جهة عليا لا يمكن مراجعتها أو الكشف عنها. هذا المصطلح يحاول أن يستند إلى مصطلح أوسع وهو مذهب منطق الدولة raison d”etat أوسيادة الدولة، ولكن مذهب سيادة الدولة يفترض سلوك الدولة أي المؤسسات سلوكا منضبطا وفقا للدستور وتحت رقابة القضاء المستقل في ظل الفصل بين السلطات.
والثابت في القانون الدولي أن سيادة الدولة تعني أن الحكومة التي تدير الدولة وحتى تتمكن من حسن إدارتها فإنها تتمتع بسلطات الهيمنة، وفقا للدستور، وأن هذه السلطات في بعض المواضيع الحساسة تتمتع بالحصانة من الرقابة القضائية، وهذه هي التي يطلق عليها أعمال السيادة، فإذا استخدمت الحكومة هذه الحصانة بالمخالفة للدستور سقطت حصانتها وارتكبت جريمة الخيانة العظمى كمؤسسة وكأفراد، ولا يجوز أن يطلق وصف السيادي على أي جهاز في الدولة أو مؤسسة.
لأن هذا الوصف يعني أنه لا يمكن مساءلة الجهاز أو المؤسسة ثم أنه وصف غامض ويقصد بغموضه أن يلقي الرعب والتسليم في نفوس المواطنين، ولم ألحظ في أي دولة أخرى هذا الوصف إلا في مصر التي تطلق على بعض الوزارات "الوزارات السيادية"، وهي الخارجية والدفاع والداخلية، وهذه الوزارات الثلاثة هي المرتبطة ارتباطا مباشرا بأمن الدولة من الداخل وأمن الدولة ومصالحها والدفاع عنها من الخارج هذه الوزارات موجودة في كل دول العالم ولا يلحق بها وصف الوزارات السيادية كما رأيت في مصر.
إذ تتجه هذه الأوصاف إلى تحصين أعمال هذه المؤسسات من المساءلة والإيحاء بأنها هي المهيمنة هيمنة مطلقة ولا راد لما تقرره خاصة وأن الحاكم يجمع السلطات السيادية في يده. يلحق بهذه الوزارات الثلاثه أجهزة الإعلام وهي تتبع السلطة وتؤدي وظيفة هامة بالنسبة للسلطة في الداخل والخارج وتزداد أهمية هذه الوظيفة كلما احتكرت السلطة مصادر المعلومات وتبددت قيم الشفافية والصراحة وهو أمر مألوف في النظم السلطوية.
الكلمة الثانية هي كلمة (وطني) يلحق هذا الوصف بكل شئ ابتداءا بالجيش الوطني والسياسة الوطنية والصناعة الوطنية والإنسان الوطني؛ من الواضح أن كلمة وطني تشبه كلمة أمي الشخص الذي لم يتعلم شيئا منذ أن ولدته أمه فالوطني نسبة إلي الوطن وغير الوطني هو الخارج عن الوطن والذي يعمل ضد مصلحته. هذا المصطلح يستخدم في جميع دول العالم ولكن يقصد به الانتساب إلى الدولة فمثلا هناك الجيش الفرنسي وهو الجيش الوحيد التابع للدولة وليس للكلمة أي مدلول كذلك الحال في جميع دول العالم.
الكلمة الثالثة هي "الجاهلية" ويقصد بها أصلا المجتمع العربي في الجزيرة العربية قبل الإسلام، ولذلك ذم القرآن الكريم هذه الفترة المنفلتة التي كان فيها القوي يفترس الضعيف وساد فيها انفلات الأخلاق وكافة العادات القبيحة ولذلك منّ الله على هذا المجتمع بالإسلام الذي نقله من الظلام إلى النور. ويستخدم وصف الجاهلية بالذم من جانب الجماعات الإسلامية لخصومهم، كما أن وصف الجاهلية ينتسب إلى الجهل ومنها الجهالة والجهول وهي أوصاف تدل على الغلظة وعدم الرحمة وعدم الانضباط والانصياع لأي قانون.
وينصرف معناها الحالي إلى تدني أخلاق المجتمع وعدم تماسكه والتفريط في دينه وفي قيمه، التي حفظته طوال هذا الوقت فيتخلى عن قيمه وينزلق إلى الفوضى والجاهلية وقد عبر شاعرنا القديم عن المعنى السلبي للجاهلية عندما أظهر فخرا باللجوء إلى السلوك الجاهلي الأحمق في مواجهة السلوك الأحمق من الآخرين قائلا: ألا لا يجهلن أحد علينا.. فنجهل فوق جهل الجاهلينا.