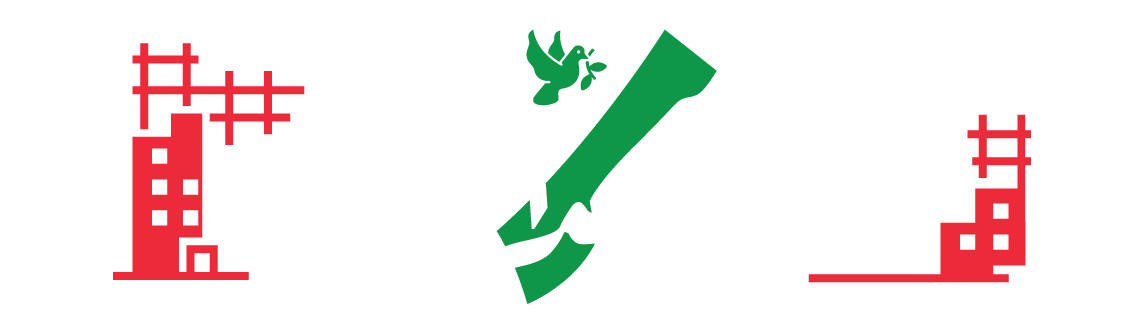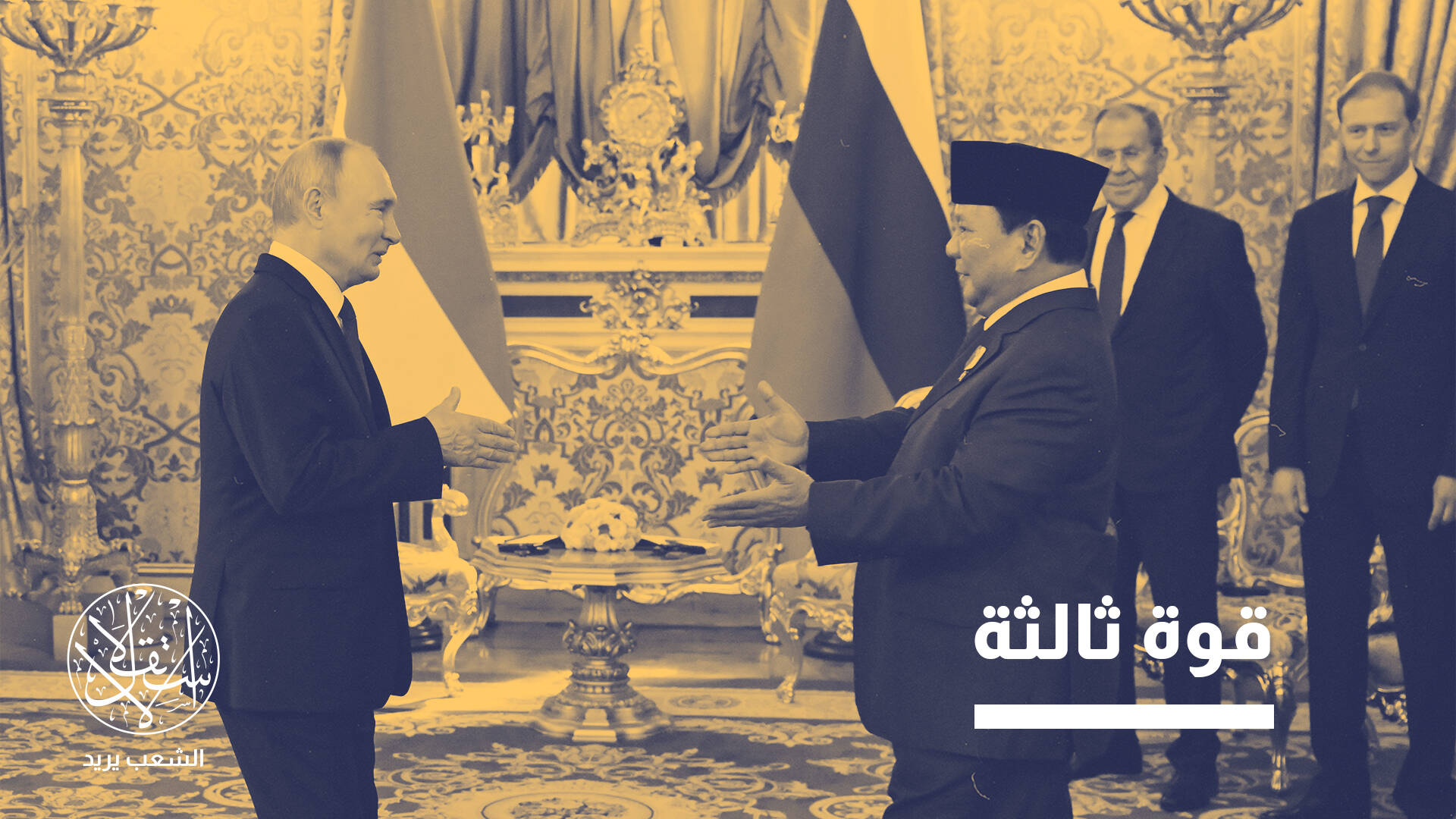طالبان تعود إلى كابول.. التأثير العالمي والإقليمي
.png)
مقدمة
أولا: مواقف القوى الكبرى
أ. أميركا
ب. الصين
ج. روسيا
ثانيا: القوى الإقليمية
أ. باكستان
ب. تركيا
ج. إيران
د. الهند
ثالثا: الدول المحادة
تركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان
خاتمة
المقدمة
ردود الفعل حيال عودة طالبان لسدة السلطة في أفغانستان تراوحت بين ترحيب ورفض، مرورا بأطياف التعاطي الحذر على كلا الجانبين؛ بين الرفض والقبول، فيما تفاوتت مواقف القوى الكبرى في هذا الإطار.
وبينما تصرفت أميركا بقدر من العدائية المستترة، فإن الاتصالات الروسية والصينية المفتوحة على طالبان منذ عام 2007 و2010 على التوالي؛ فتحت الباب لحوار مصلحي لم يخف القلق من أن تكون طالبان مدخلا لعدم استقرار دول الجوار.
ولا يتجاوز هذا القلق إلى داخل هذه الدول، لاطمئنانها إلى أن إزاحة تنظيم "القاعدة" من أفغانستان يجعل "طالبان" تنظيما محليا بامتياز.
أما الدول الإقليمية والمحادة، فغالب رد فعلها يتمثل في الحوار مع "طالبان" وحول "طالبان"، فيما يبدو أن محاولات الحركة لطمأنة دول جوارها مهدت الطريق، لكنها لم تقض على حال انعدام الثقة الذي خلف تجربة "طالبان" الأولى.
ما ملامح الموقف الدولي؟ وما اتجاهات تطوره؟ تحاول الورقة إلقاء الضوء على هذين المحورين.
أولا: موقف القوى الكبرى
في هذا المحور نجيب عن التساؤلات بخصوص مواقف القوى الكبرى من وصول حركة طالبان للقصر الرئاسي في كابل، وتداعيات هذا الحدث على السياسة الخارجية الأميركية التدخلية، وعلى رد الفعل في كل من الصين وروسيا.
غير أن ثمة ما يجمع هذه الدول جميعها كعامل مشترك، يحدد سلوك ما بعد وصول طالبان للحكم، ألا وهو اشتراكهم جميعا في مواجهة "تنظيم القاعدة" خلال الفترة الماضية. وفيما انخرطت أميركا وروسيا في المواجهة العملياتية، كانت مشاركة الصين استخباراتية محضة.
والعائد المشترك جراء هذه المواجهة مع "تنظيم القاعدة"، أنه بخلو أفغانستان من هذا التنظيم، أمكن الاطمئنان إلى أن المتبقي في أفغانستان، أي طالبان، أضحى حركة محلية، وهو أمر يمكن التعايش معه إن طال الأمد بهذه الحركة في السلطة.
ويشير مراقبون إلى أن الصين وروسيا استفاد كل منهما كثيرا من الحضور الأميركي في أفغانستان، ولم تعارضاه، لتأثيره الإيجابي على استقرار المنطقة وأمنها، بالرغم من عدم استسلام حركة طالبان.
أ. أميركا:
نحاول في هذا المقام أن نجيب على الأسئلة التالية: لماذا انسحبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أفغانستان؟ وما تداعيات ذلك على السياسة الخارجية الأميركية الداخلية؟ وما تداعياته على الموقف في وسط آسيا؟
كان عنوان "نيويورك تايمز" لافتا مع إشارتها إلى أن 20 عاما من الحضور الأميركي انتهى كما بدأ، إذ إن "حركة طالبان" في الحكم.
ولم يفت الصحف الأميركية، نقلا عن وكالات الأنباء، أن تقدم كشف حساب لهذا الوجود الصفري التأثير، نقلا عن وكالات الأنباء.
وكان عنوان تقرير وكالة "أسوشيتد برس" هو "تكلفة الحرب الأميركية على أفغانستان في الأرواح والدولارات"، والتي أشارت فيها لارتفاع التكلفة البشرية والمادية لهذه الحرب.
ووفقا للوكالة، فإن التكلفة البشرية للحرب تضمنت (2448) جنديا قُتلوا في أفغانستان، و(1144) جنديا من قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو".
علاوة على (3846) متعهدا ومقاولا أميركيا، و(66 ألفا) من قوات الجيش والشرطة الأفغانية، و(47 ألفا و245) مدنيا أفغانيا، و(51 ألفا و191) جنديا من طالبان وغيرها، و(444) من موظفي منظمات الإغاثة، و(72) صحفيا من جنسيات مختلفة.
أما التكلفة المالية، بحسب الوكالة، فبلغت بالنسبة لكلا الحربين في العراق وأفغانستان ما قيمته (2) تريليون دولار، لافتة إلى أن هاتين الحربين شنتا من خلال الائتمان (Credit) أو الاقتراض، وليس من خلال الإنفاق المباشر (Cash) من أموال دافعي الضرائب.
كما ألمحت إلى أن قيمة نفقات هاتين الحربين وفوائدها التي تسدد بحلول 2050 تبلغ نحو (6.5) تريليون دولار.
مدخل دراسة هذه المساحات الثلاثة ينطلق من قراءة تأثير الانسحاب الأميركي، وتصورات هذه القوى للتعاطي مع الوضع المستقبلي. ولفهم قرار بايدن بسحب القوات من أفغانستان، ينبغي العودة للنقاش الذي دار قبل أكثر من عقد، خلال السنوات الأولى من حكم الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.
خلال هذه الفترة، ناقشت إدارة أوباما الجديدة ما إذا كان ينبغي زيادة القوات الأميركية في أفغانستان بعد ما يقرب من 8 سنوات من الحرب التي فشلت في إخماد تمرد قوات طالبان.
إذ طلبت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" في وقت مبكر من العام 2009 إرسال 17 ألف جندي إضافي، وبعد أن حصلوا على هؤلاء، طلبوا 40 ألف عسكري إضافي لإضعاف طالبان ودعم الحكومة الأفغانية.
وكان نائب أوباما آنذاك الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، أحد أكبر المتشككين في توصيات الجيش، وأثار مرارا تصوره بأن إستراتيجية البنتاغون، من غير المرجح أن تؤدي إلى تحقيق نصر.
لم يتغير تصور بايدن خلال فترة حكم الرئيس التالي دونالد ترامب، وهو ما يرجع لمتابعته مسار التفاعلات في الساحة الأفغانية، بالنظر للموارد التي توفرت، ولحجم الإنفاق الهائل الذي أنفقته واشنطن هناك.
أما عن تداعيات قرار الانسحاب على الرؤية السياسية الأميركية، فنرصده في عجالة من زاويتين؛ أولاهما تتعلق بالداخل الأميركي.
يمكن القول: إن الداخل الأميركي متوافق مع القرار، ومع وقف النزيف الائتماني الذي يمثل عبئا على الموازنة الأميركية، الآن ومستقبلا، علاوة على حاجة واشنطن لزيادة الإنفاق الداخلي.
وهو تصور مرتبط بطبيعة الإدارات الأميركية المنبثقة عن الحزب الديمقراطي، وكانت إدارة ترامب وعدت بإنجاز هذا الانسحاب، ولم يسعفها الوقت حينها، لكنها كانت قد بدأت مسار التفاوض المباشر مع "طالبان" عبر الراعي القطري في الدوحة.
أما على صعيد السياسة الخارجية التدخلية، فلا يمكن القول بأنها ستتأثر بهذا القرار، من زاويتين؛ أولاهما أن إدارة بايدن تبدو حتى اللحظة إدارة بمزاج تدخلي واضح.
وهو ما يمكن النظر إليه من منظور الحضور العسكري في أوروبا، وفي البحر المتوسط، وفي البحر الأسود، وفي المحيط الهادئ، وغيرها من المناطق، وهو ما يمثله شعار "أميركا عادت". وهو ما يشي بأن الانسحاب الذي قرره بايدن، كان محض إنهاء لما ارتئاه "خطة غير مجدية"، ويصل غياب جدواها لحد الفشل الذي صاغته ببراعة صحيفة "نيويورك تايمز".
إنهاء الخبرات "غير المجدية"، وفق طرح إدارة بايدن، خطوة ضمن تصورات عدة لخفض النفقات الدفاعية غير الضرورية، تعتمد جميعها على الموازنة بين محاور "الجاهزية" و"الاستثمار" و"الهيكل" جنبا إلى جنب مع إجراءات أخرى من قبيل إعادة تشكيل ميزانية الدفاع.
التصورات الراهنة ربما يدفع إحداها البنتاغون، إلى أن ينفق أقل على الهيكل، مما سيقلل بدوره الضغط على الفئتين الأخريين (الجاهزية والاستثمار)، مع منح أولوية للإنفاق على الجاهزية.
هناك اتجاهات داخل الإدارة الأمريكية ترى أن ثمة بدائل للحضور في أفغانستان، في مواجهة الدب الروسي الصاعد، وتميل الخيارات الواعدة لتجنب سياسة الاحتواء، التي اتبعت خلال الحرب الباردة.
وأن تستبدل بها إستراتيجية تقوم على تكبيد روسيا خسائر سياسية واقتصادية وعسكرية فادحة لا تستطيع موسكو تحملها على المدى الطويل، بسبب وجود منغصات أمنية وعسكرية على حدودها.
ومن جهة ثانية، التمسك بحماية أميركا لحلفائها وضمان مصالحهم، وأن تستجيب لتصرفات روسيا بسياسات تدفع الأخيرة نحو الانصياع، واتخاذ مواقف أكثر قبولا على الصعيد الدولي، وبخاصة من جانب حلفاء واشنطن.
وتتعالى أصوات خبراء من مؤسسات مختلفة أبرزها "هيريتيج فاونديشن" مطالبة بأن يتسم رد الفعل الأميركي بالعقلانية والرشادة والتروي، وعدم الانسياق وراء المغامرات العسكرية غير ذات الجدوى.
وفي اتجاه آخر، يطالب خبراء بأن يكون فحوى الإستراتيجية الأميركية قائما على الدفاع عن القيم التي تتبناها واشنطن مثل الحرية وسيادة القانون ونبذ الدكتاتورية، ما يمثل رصيدا من القوة الأميركية الناعمة، قادرا على تعويض تضرر صورة أميركا ومساندة جهازها الدبلوماسي، وجبر ضعف فاعلية مؤسستها العسكرية.
ورغم أن هذه الرؤية ظهرت في 2016، إلا أنها تمثل أبرز محاور عمل إدارة بايدن، التي ترى في الصين "منافسا" و"تهديدا"، لكنها لا ترى فيها "عدوا" أو "تهديدا خطيرا".
غير أن الحضور الأميركي في المحيط الهادئ وفي البحر المتوسط وغيرهما يمكن أن يشكل آلية مستقبلية لكبح خطة الحزام والطريق، وتحويل بنيتها التحتية إلى موارد إقليمية للدول التي بنيت بها، ومنع تحويلها لأداة هيمنة.
هذا فضلا عن اتباع نفس التوجهات مع روسيا، ورفع درجة مخاطر التعاون الإقليمي في البقاع المختلفة مع روسيا.
وتعد عملية ترميم العلاقات مع حلفاء واشنطن عبر العالم، وبخاصة في آسيا، أحد مداخل إدارة بايدن لمواجهة الصين بطريق غير مباشر.
وفي نفس الإطار، يمكن فهم السبب الرئيس وراء ترك أميركا الأسلحة التي أرسلتها للحكومات الأفغانية المختلفة، وهي ترسانة ضخمة، أغلبها ذو طبيعة برية، لكنها تنطوي على 200 طائرة مقاتلة.
فرغم أن إدارة بايدن آثرت الانسحاب من أفغانستان، إلا أنها تركت أمر مواجهة طالبان لأحد مسارين؛ مستفيدة من هذا السلاح.
فمن جهة، سوف يقلق هذا السلاح دول الجوار، ما يدفعها لشرائه أو لتدميره، فإذا قبلت طالبان بيعه؛ فستصبح بلا قوة إستراتيجية، ويمكن مواجهتها عبر معارك الجيوش النظامية.
وأما إذا رفضت بيعه، فإن هذا من شأنه أن يعقد المشهد الإقليمي في مواجهتها، ويؤدي لبناء أسس عدم ثقة بينها وبين دول الجوار.
غير أنه إذا بقي، فإنه يمثل رصيدا في اتجاهين؛ أولهما أنه رمز لهوية نمط التسليح الأفغاني، ويمكن البناء عليه في اتجاه تبعية عسكرية مستقبلا.
وثانيهما أنه يمكن أن يكون مستقرا لقوة أخرى تخطط أميركا لدعمها لمواجهة طالبان، ومن بينها قوة أحمد مسعود، والتي شهدت دعما لوجيستيا أميركيا خلال فترة ما بعد وصول طالبان للعاصمة كابول، ما بلغ حد القيام بعملية "إنزال جوي" في الإقليم، بعد مطالبة مسعود بالدعم العسكري.
ذلك الإجراء ربما ينطوي على إقدام أميركي لتقديم الاستشارة العسكرية لمسعود، من أجل الصمود في مواجهة "طالبان"، وهو ما من شأنه إرسال صورة عن عدم الاستقرار، ما قد يؤدي لتعبئة شعبية نسبية في مواجهة الحركة على ما تأمل واشنطن من إعادة تدوير التاريخ.
ربما يستعمل مسعود المشورة الأميركية، ولا يرمي بها إلا الحفاظ على وضع "الحكم الذاتي" الذي تمتع به إقليم "بنجشير" طوال العقدين الأولين من القرن الـ21.
ب. الصين:
لا شك في أن الصين لديها "بعض القلق" من وجود دولة غير مستقرة ، إلى حد الفشل على حدودها، تديرها طالبان، خاصة وأن فشلها يعود للاضطرابات العرقية من ناحية، ولوجود حكومة لها سابقة في رعاية تنظيم بخطورة "القاعدة".
ويضاف لهذا بطبيعة الحال "تجارة المخدرات"، وهي التجارة التي تورطت فيها أفغانستان بسبب طبيعة زراعة مصادر المواد المخدرة، والتي لا تحتاج لموارد مياه كبيرة، وهو ما ناسب الطبيعة الجافة لأفغانستان.
غير أن تهديد الحكومة غير المستقرة في أفغانستان يدفع لتهديد دول الجوار، وبخاصة المحادة لأفغانستان، وهي دول تتسم بعلاقات قوية مع الصين.
سواء في ذلك دول الشمال: طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان، أو جارتها الشرقية التي تعد الحليف الأبرز للصين؛ وهي باكستان.
علاوة على إيران التي تتمتع بعلاقات قوية مع الصين، إذ ضخت الأخيرة في هذه الدول استثمارات ضخمة، قطاع منها يتعلق بمبادرة "الحزام والطريق".
غير أن التخوفات الصينية قد يخفف من وطأتها ثلاثة عوامل، الأول منهما يتعلق بالعلاقة القوية بين طالبان وباكستان، التي تعد أحد الحلفاء الجنوبيين للصين.
وتتمتع باكستان بنفوذ كبير داخل حركة طالبان، بدءا من دورها في دعم عملية تأسيس الحركة خلال الفترة ما بين 1994 و1996، علاوة على دور باكستان الراهن، ذي الرؤية المستقبلية، في دعم الحركة.
وخلال فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، كانت كلمة باكستان حاضرة في إقرار الاستقرار، أو عدم الاستقرار، في أفغانستان، وهو ما يجعل باكستان حليفا مهما للصين فيما يتعلق بالشأن الأفغاني.
العامل الثاني يتعلق بحركة طالبان نفسها، والتي تشي بأنها أضحت صاحبة باع مقبول في الدبلوماسية، وأنها ليست طالبان الأمس، والتي لم تكن تعرف لغة التفاوض.
ولا يقدح في هذا التصور فشل المفاوضات بين الحركة وأميركا، وهو الأمر الذي تحدده محددات كثيرة، منها ما هو ذاتي في فكر وثقافة الحركة، سواء ثقافة الحركة نفسها ذات المرجعية الشرعية التي ترفض الاحتلال "الكافر"، أو ثقافة المجتمع القبلي، والذي يرفض الغزو، ويحفظ مفهوم الثأر، ويعتز بمفهوم الكرامة.
ومن الجهة الأخرى، فإن الحركة ترغب في تجنب انضمام الصين وأجهزتها الاستخبارية للتدابير التي ستتخذ للتأثير على مستقبل أفغانستان تحت إدارة الحركة.
العامل الثالث يرتبط بالثاني من زاوية أن طالبان الجديدة باتت تعرف لغة المصالح، وتدرك أهميتها الإستراتيجية من جهة، وأهميتها الاقتصادية كمنجم معادن نادرة.
وهو بالضبط ما تحتاجه الصين، ولقيت في إطاره تجاوبا من الحركة التي اعتمدت خلال الـ20 عاما الماضية على التقنية الصينية في مواجهة الوجود الأميركي.
ولهذه العوامل جميعها، أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، أن بكين تعتزم الاستمرار في مساعدة أفغانستان، بعدما فرضت حركة طالبان سيطرتها عليه.
واستطرد مشيرا لدور بلاده في المستقبل: "سنواصل مساعدة جهود استعادة السلام في أفغانستان وسنقدم كل مساعدة ممكنة لهذا البلد لتحفيز تنميته الاجتماعية والاقتصادية".
لكن المتحدث الصيني استدرك بأن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية جديدة مع أفغانستان، إلا بعد تشكيل "حكومة متسامحة ومنفتحة هناك تمثل بشكل كاف مصالح بلادها".
وكانت طالبان تعهدت للصين، في وقت سابق خلال زيارة قام بها وفد من الحركة لبكين، بأنها لن تسمح باستخدام أراضي أفغانستان كقاعدة لشن هجمات تستهدف أمن دول أخرى".
غير أن اعتبارات الطمأنة لم تمنع من توفير قدر من الاستعدادات العسكرية لاحتمالات حدوث فراغ أمني نتيجة أية أوضاع فوضى ربما تنشأ عن توفر مقاومة لحكومة طالبان.
ولعل هذا ما دفع كلا من الصين وروسيا لتنظيم أكبر مناورات مشتركة بينهما 9 أغسطس/ آب 2021، وهي مناورات "التعاون 2021"، والتي ضمت أكثر من 10 آلاف جندي، وطائرات مقاتلة ومدفعية، وإقامة مركز مشترك للقيادة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، أن هذه التدريبات تهدف إلى تعزيز وتطوير شراكة إستراتيجية شاملة بين روسيا والصين، والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، والتأكيد على مكافحة الإرهاب.
وأوضح من هذا التصريح أن المناورات تأتي استجابة للتحولات في أفغانستان، ويعضد هذا التوجه أنها أتت بعد أيام من لقاء الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين في طاجيكستان.
ج. روسيا:
الموقف الروسي يشابه الموقف الصيني من الحركة، رغم أنها محظورة في موسكو منذ عام 2001 وحتى اللحظة، تحت تأثير تهديدات الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن.
لكن تعقيدات السياسة فرضت وضعا مختلفا، وكانت المفاجأة أنه نهاية عام 2016، عبرت الحكومة الأفغانية وقيادات أميركية عن القلق من تعميق العلاقات بين روسيا وحركة طالبان، متهمين موسكو بأنها تقدم دعما للحركة التي تحارب لإسقاط الحكومة الأفغانية المدعومة أميركياً.
ومع تطور الأحداث على الساحة الأفغانية، استهلت روسيا السيطرة المضطردة للحركة على المدن الأفغانية للتصريح بأن "تنظيمات إرهابية" ربما تستغل الفراغ في أفغانستان لشن هجمات ضد روسيا ودول آسيوية أخرى.
ولم تلبث بعد استيلاء الحركة على العاصمة الأفغانية كابل أن أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن ترحيبه بالبيانات الأولية التي أدلت بها الحركة، ووصفها بأنها إشارة إيجابية.
فيما اكتفى مسؤولون عسكريون روس رفيعو المستوى بالتأكيد على أن روسيا "في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستقدم مساعدة، حال ظهور تهديد بالعدوان أو عدوان حقيقي".
وأضاف أن هناك صيغا محتملة للرد، وأشار للمناورات العسكرية الروسية مع أوزبكستان، كما أشار لجاهزية كل من طاجيكستان وأوزبكستان وقرغيزستان للقتال اليوم.
وكانت روسيا أطلقت مناورات عسكرية (روسية - أوزبكية) مشتركة، 2 أغسطس/ آب 2021، في ميدان "ترميز" الجبلي للتدريب، جنوبي أوزبكستان، على الحدود مع أفغانستان، استغرقت خمسة أيام بمشاركة أكثر من 1500 عسكري.
أعقبت روسيا هذه المناورات بأخرى أكبر مع الصين، وهو ما تحدثنا عنه سلفا.
غير أن المفاجأة في هذا الملف ما نقلته "وكالة تاس للأنباء" عن الممثل الخاص للرئيس الروسي، زامير كابولوف، بشأن أفغانستان، 16 أغسطس/ آب 2021، من أن المحادثات الروسية مع الحركة سبقت هذه المناورات، وأن السفير الروسي في أفغانستان أدار هذه المحادثات بسلاسة منذ عام 2007.
هذا التصريح سبقه بعدة أيام تصريح آخر من لافروف، امتدح فيه موقف مفاوضي الحركة، ووصفهم بأنهم "أشخاص عاقلون".
وأضاف: "من الخطأ محاولة الإبقاء على الغموض الراهن لأطول فترة ممكنة، وهناك قوى في كابول تريد حدوث هذا لأنه يسمح لها بالبقاء في السلطة".
وفي مقابلة كابولوف، صرح الأخير أن روسيا لا ترى أن حركة طالبان في أفغانستان تمثل تهديدا لآسيا الوسطى.
وأضاف أن موسكو مهدت الطريق سلفا لإقامة اتصالات مع الحركة، وأن المسؤولين الروس بالفعل على اتصال بمسؤولي حركة طالبان عبر سفارة موسكو في كابل.
وكان غطاء الموقف الروسي ما صرحت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن بلادها تفضل التوصل إلى سلام عن طريق التفاوض في أفغانستان؛ وهو ما لا يمكن أن يحدث بغير إقامة علاقات مع كل الأطراف بما فيها حركة طالبان.
أطياف التحليلات المرتبطة بالموقف الروسي تبدأ لدى المراقبين من رد الدَّين لأميركا التي ساعدت "المجاهدين الأفغان" على إخراج الاتحاد السوفيتي من أفغانستان، وحتى رغبة روسيا في توقي شرور الحركة بإقامة علاقات معها.
غير أن المناورات العسكرية الروسية الأوزبكية على الحدود مع أفغانستان لم تكن موجهة ضد طالبان بقدر ما كانت موجهة لدرء تداعيات أي حالة فراغ أمني ربما تحدث بسبب المرحلة الانتقالية في أفغانستان.
ثانيا: القوى الإقليمية:
يجيب هذا المحور على السؤال المتعلق بتداعيات الانسحاب الأميركي من أفغانستان على سلوكيات القوى المتوسطة الإقليمية حيال أفغانستان، هذه القوى نحددها في كل من باكستان وتركيا وإيران والهند.
وبداية، وكعامل مشترك بين كل القوى الإقليمية، يمكن أن نشير إلى ثلاثة ملامح متبادلة في العلاقة بين هذه القوى وحركة طالبان.
أول هذه الملامح يتمثل في انخراط هذه القوى جميعا، تماما مثل القوى الكبرى، في علاقة حوارية مع طالبان باعتبارها القوة القادمة، وربما الوحيدة، للسلطة في مستقبل أفغانستان.
أما ثاني هذه الملامح فيتمثل في شروع هذه القوى في إدارة حوار فيما بينها بشأن مستقبل أفغانستان، هذه الحوارات جرت في صورة محاور، إذ تحاورت باكستان مع إيران وتركيا، فيما تحاورت الهند مع إيران، علاوة على مسارات الحوار مع القوى الكبرى.
ويتمثل ثالث الملامح في ردود فعل حركة طالبان بعد وصولها للقصر الرئاسي، إذ صدرت عنها بادرات إيجابية تجاه كل دول الجوار، بما في ذلك إيران والهند.
وتفاصيل هذا المحور فيما يلي:
أ. باكستان:
من أهم العبارات التي تميز العلاقة بين باكستان الرئيس الحالي عمران خان، وبين طالبان، تصريح الأول بأن الأفغان "كسروا أغلال العبودية"، الأمر الذي اعتبرته "واشنطن بوست" الأميركية ضربا من النظر إلى حركة "طالبان" الأصولية باعتبارها نموذجًا لنوع من الأصالة التمكينية.
حسابات معقدة تحكم الطرفين، بالرغم من العلاقة التاريخية بين إسلام أباد وحركة طالبان في إطار حديث الخبراء عن الدعم الباكستاني للحركة خلال مرحلة التأسيس، وكذلك بالرغم من أن باكستان كانت أول دولة تعترف بالحكومة الأولى للحركة في 1996.
وبالرغم من رفض الرئيس الباكستاني تقديم الدعم اللوجيستي أو ما دونه للحكومة الأفغانية برئاسة أشرف غني، وبرغم النفوذ القوي لباكستان في الحركة، إلا أن هذا لا يعني أن العلاقة بين الطرفين تخلو من الحسابات الإستراتيجية المعقدة، والمتعلقة بحماية الاستقرار والتكامل الإقليمي الباكستاني.
من أهم أمارات الحسابات المعقدة بين الطرفين، إعلان باكستان المبكر رفضها الاستيلاء على الحكم بالقوة في أفغانستان، ودعوتها طالبان والحكومة الأفغانية لتقديم تنازلات متبادلة.
وثمة أيضا مؤشر إقدام باكستان على إغلاق المعابر الحدودية بين البلدين مع تتابع سيطرة الحركة على المدن الحدودية الشرقية، وكان آخرهم وأهمهم معبر "تورخم" الذي أغلق في أعقاب سيطرة الحركة على مدينة "جلال آباد" الشرقية الواقعة على الطريق السريع الرئيس المؤدي إلى العاصمة كابل.
وهو مستوى عال من الاحتياط الأمني يجري بالرغم من سيطرة الحركة على الجهة المقابلة من المعبر.
وإلى جانب هذا، تأخرت باكستان في الاعتراف بحكومة طالبان، وأعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، أن بلاده ستعترف بحكومة طالبان الأفغانية، عندما يحين الوقت المناسب، وذلك وفق الاتفاقات الدولية والحقائق على أرض الواقع.
ويرى الخبراء أن ثمة تخوفات عدة لدى الجانب الباكستاني، أولها التخوف من حركة "طالبان الباكستانية"، والتي ما زالت تمثل هاجس الانفصال المتعلق بعرقية "البشتو".
وكان زعيم حركة "طالبان باكستان"، نور والي محسود، أشاد بما حققته حركة طالبان الأفغانية، ونوه إلى أن العلاقات مع "طالبان أفغانستان" مبنية على "الأخوة والتعاطف".
وقال: إنهم لا يزالون يقاتلون بجانب طالبان الأفغانية، وأنهم في حالة حرب مع قوات الأمن الباكستانية، ويتمنون السيطرة على المناطق الحدودية القبلية الباكستانية، و"تحقيق استقلالها".
وفي هذا الإطار، يرى مراقبون أن الخطر بالنسبة لباكستان هو أنه إن كانت طالبان أفغانستان أقوى فيمكنها في الواقع أن تقلل من تعاونها مع المخابرات الباكستانية في السيطرة على طالبان باكستان، ما يساعدها في تحقيق هذا الهدف.
وبرغم هذه المخاوف، فإن إشارات عدة تشير إلى دعم باكستان للحركة، وبخاصة الدعم الاستخباراتي والعسكري، وهو ما عبر عنه الرئيس الأفغاني أشرف غني نفسه، وهو الدعم الذي أسهم في وصول الحركة إلى ما آلت إليه.
ب. تركيا:
أفغانستان تمثل بالنسبة لتركيا مجالا لدعم حضورها في وسط آسيا، بصيغة تنتج حالة من الاتساق في الرؤية بين دول هذه المنطقة، وفي حماية المصالح المتبادلة بين دول العالم الإسلامي، أو على الأقل باعتبار وجود عرق تركي واسع بين الأعراق العديدة المشكلة للمجتمع الأفغاني على نحو ما صرح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
هذا النزوع يجعل "المجلس القومي التركي" (الجامع للدول الناطقة بالتركية) منطلقا لتوفير أرضية تستوعب الأعراق الأفغانية كما استوعبت الأعراق الباكستانية من أجل بناء أممية إسلامية تدعم سكان العالم الإسلامي في مواجهة التنظيم الدولي غير العادل الذي أعقب انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.
ولهذا، وقبل سقوط العاصمة كابل بأكثر من أسبوع، طرح الرئيس التركي فكرة لقاء زعيم حركة طالبان في تركيا.
ومن ناحية أخرى، وعلى الجانب التركي كذلك، ترغب أنقرة في الإفادة الاقتصادية من الكعكة الأفغانية، والتي تتضمن ملفات عدة، منها التعدين، الطاقة، وإعادة الإعمار.
ولهذا، ربما أعادت تركيا فتح باب التعاون من خلال عرض إدارة مطار كابل لصالح طالبان، وتدريب كوادر الحركة على إدارة هذا الملف كفاتحة تعاون.
ولعل هذا سبب التصريح الإيجابي للرئيس التركي قبل ساعات من إنهاء هذه الدراسة، معلنا "استعداد تركيا للتعاون مع حركة طالبان".
وفي لفتة لنزع روح التحدي عن سلوك قيادات الحركة، لفت أردوغان إلى أن "الوقوف بجانب أفغانستان في السراء والضراء أحد متطلبات الوفاء بالعهد والأخوة أيا كانت الجهة الحاكمة".
وأضاف: "تركيا مستعدة لكافة أشكال التعاون من أجل رفاهية الشعب الأفغاني وسلامة بني جلدتنا أتراك أفغانستان ومصالح بلادنا".
ومنها كذلك تدريب القوات العسكرية والشرطية، وهي مساحة -من وجهة نظر الدراسة- ربما ترتبط بالأسلحة الأميركية المتروكة في أفغانستان بدون تدمير، والتي ربما أراد الأميركان استغلالها لتكون رمزا للهوية العسكرية الأفغانية لاحقا، وهو أمر -من وجهة نظر أميركية- يمكن أن تشارك تركيا في تحقيقه.
ومن وجهة نظر طالبان، فإنها أعلنت الترحيب بالتعاون مع تركيا، كما سبق وأعلنت ذلك لصالح كل من دول الجوار الكبرى والإقليمية.
وكانت طالبان عارضت من قبل تولي القوات التركية إدارة مطار كابل تحت مظلة "الناتو"، وطالبت -بكل وضوح وقوة- برحيل القوات التركية.
غير أن هذه الخطوة، من جانب "طالبان"، لم تكن تعني استبعاد تركيا من دائرة التعاون، إذ أكد المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في مقابلة إعلامية له، أن "ما نريده هو أن تنسحب تركيا التي أتت إلى أفغانستان تحت مظلة "الناتو" قبل 20 عاما. وحين نكون بحاجة إلى تركيا سنتحدث معها مباشرة ومع الشعب التركي، إننا نريد تركيا بصفة مستقلة، ولا نريدها جزءا من الناتو".
وفيما تتجه تركيا لبناء علاقة تعاون دفاعي مع "أفغانستان - طالبان"، فإنها ربما حصلت على تسهيلات من طاجيكستان لاستخدام إحدى القواعد العسكرية الروسية سابقا لتلبية متطلبات التدخل السريع، ما يكشف عن توافق "تركي - طاجيكي" بخصوص مستقبل إدارة الوضع في أفغانستان.
ج. إيران:
تتجه إيران مؤخرا إلى بناء علاقة توافق مع كل من تركيا وباكستان من أجل تحقيق الاستقرار في مرحلة ما بعد وصول "طالبان" للحكم. ويعكس السعي نحو هذا التواصل قلقا إيرانيا مشوبا بترحيب ظاهري.
وفيما يتعلق بالموقف الإيراني، رحبت طهران بانسحاب القوات الأميركية من الأراضي الأفغانية، واعتبره انتصارا لجبهة المقاومة، ولمشروعها في إزالة الوجود الأميركي من جوارها. ويلفت مراقبون إلى أن الانسحاب الأميركي جاء وسط تصاعد الخلافات بين إيران وحكومة أشرف غني؛ ما شكل دافعا للتقارب مع طالبان من باب الضغط على حكومة غني.
وسبق لطهران أن استضافت جولات من الحوار مع قادة الحركة في إطار (أفغاني - أفغاني)؛ ما اعتبر -آنذاك- تطورا نوعيا في العلاقات بين الجانبين.
وحتى اليوم، توجد قوى معتبرة في إيران تتعاطف مع حركة طالبان، من بينها قيادات في الحرس الثوري كانت ترى قدرا واسعا المصالح المشتركة بين الحركة من جهة وإيران من جهة أخرى، وأبرزها مناهضة الوجود الأميركي في المنطقة.
غير أنه على الجانب الآخر، فإن احتمال هيمنة طالبان على أفغانستان مقلق لإيران؛ إذ تنذر التجربة السابقة لسيطرة الحركة على مقاليد الحكم في أفغانستان بالعديد من المخاطر والتحديات للمصالح الإيرانية في هذا البلد، علاوة على احتمال تشكل بؤر اضطراب مزمن على مقربة من الحدود الأفغانية- الإيرانية.
وبرغم وجود اتجاهات تولي الحركة الأفغانية احتراما واسعا، إلا أن التوجه السائد في طهران قلق من صعود هذه الحركة.
ما تمثل في عدد من الإجراءات الاحترازية من قبيل إخلاء قنصلية إيران في مزار شريف؛ رغم تأكيد طالبان على احترام البعثات الدبلوماسية، وإعلان حالة التأهب القصوى في صفوف الجيش الإيراني والحرس الثوري على الحدود الشرقية بعد سيطرة طالبان على المعبر الحدودي في هرات.
وإرسال طهران معدات عسكرية إضافية إلى تلك المناطق الحدودية، ودعم قاعدة الدفاع الجوي الخامسة والقاعدة الجوية 14 التابعة للجيش الإيراني في مدينة مشهد بمعدات قتالية؛ من ضمنها مروحيات هجومية وطائرات استطلاع وسربان من الطائرات المقاتلة.
د. الهند:
كان رد الفعل الهندي الأول من تقدم حركة طالبان نحو العاصمة كابل هو التوجس. وفي إطار الحوار الإقليمي بشأن وصول طالبان إلى السلطة مجددا، شاركت الهند في الحوارات الإقليمية بشأن هذا الملف.
وقام وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار، بزيارات دبلوماسية إلى إيران وروسيا لمناقشة التطورات في أفغانستان، وشرع في بناء مسار حواري مع الحركة.
وما كادت الحركة تنتهي من الاستيلاء على مدينة "مزار شريف"، حتى شرعت الهند في إجلاء رعاياها، وطاقم سفارتها.
ويمكن إيجاز ملامح السياسة الهندية في أفغانستان في عدة ملامح رئيسة.
أول هذه الملامح يتمثل في محاربة نفوذ خصمها التقليدي باكستان.
أما الملمح الثاني فيتمثل في منع أفغانستان من أن تصبح قاعدة للجماعات المتطرفة المعادية للهند.
ويتمثل الملمح الثالث الأكثر حداثة للمخاوف الهندية في قلقها بشأن وضع "كشمير"، في ظل التوترات الحدودية التي تقلقها مع باكستان من جهة، والصين من جهة أخرى.
وإلى جانب هذه الملامح الثلاثة، يوجد ملمح رابع، يتمثل في تأثير الوجود الأميركي السابق في أفغانستان، وعلاقة التحالف القوية بين الهند وأميركا، إذ دفع هذا الملمح واشنطن لأن تمنح الهند نصيبا من كعكة إعادة إعمار أفغانستان.
اللافت في هذه القضية الأخيرة، أن مساعي حركة طالبان لتهدئة المخاوف الإقليمية تضمنت دعوة الهند لاستكمال مشاريع إعادة الإعمار في أفغانستان.
سلوك طالبان تجاه الهند جزء من الإستراتيجية الدبلوماسية العامة للحركة، في إنتاج تدفق واسع المدى من التصريحات الإيجابية حيال دول الجوار جميعها، مع تخصيص القوى الكبرى والمتوسطة بهذا الدفق، في محاولة لتذليل عقبات ما بعد تشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد.
ثالثا: الدول المحادة:
يمكن القول إن حالة واسعة من القلق اجتاحت الدول المحادة لأفغانستان، وهي كل من طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان، وجرى تناول كل من باكستان وإيران في المحور السابق.
ويمكن في هذا الإطار أن نلاحظ ثلاثة ملامح أساسية للتعبير عن هذا القلق.
فمن ناحية، وجدنا هذه الدول تسارع لعقد اجتماعات تشاورية مع القوى الكبرى، روسيا والصين، حول مستقبل الوضع في أفغانستان، ومدى تأثيره على مستقبل هذه البلدان.
وكان أبرز هذه الحوارات أن طاجيكستان استضافت حوارا مباشرا بين الرئيسين الصيني والروسي، فيما يعد الطرفان متنافسين على الحضور في طاجيكستان، كما أقامت كل من أوزبكستان وتركمانستان مباحثات منفردة.
ومن ناحية ثانية، فإن روسيا تولت الحديث بالنيابة عن هذه الدول، وبخاصة طاجيكستان وأوزبكستان، بالنظر للبعد الجغرافي لتركمانستان، والامتداد التركي الأقوى فيها.
وفي هذا الإطار، قال المبعوث الرئاسي الروسي لأفغانستان زامير كابولوف في مقابلة إعلامية له مع "وكالة تاس" الروسية: إن موسكو ستواجه المسلحين من أفغانستان إذا دخلوا أراضي طاجيكستان أو أوزبكستان أو قيرغيزستان.
وفي نفس الإطار، صرح الرئيس السابق لأركان الجيش الروسي، الجنرال يوري بالويفسكي، بأن روسيا ربما تستخدم القاذفات بعيدة المدى من طراز "تو-22 أم زي" في حال اعتداء حركة طالبان على بلدان آسيا الوسطى.
أما الملمح الثالث في مواجهة الدول المحادة لأفغانستان، فيتمثل في إقدام هذه الدول على المشاركة في مناورات مع القوى الكبرى بالمنطقة.
إذ شاركت أوزبكستان في مناورات عسكرية مباشرة مشتركة مع روسيا، 2 أغسطس/ آب 2021، في ميدان "ترميز" الجبلي للتدريب، جنوبي أوزبكستان، على الحدود مع أفغانستان، استغرقت خمسة أيام بمشاركة أكثر من 1500 عسكري.
كما شاركت كل من أوزبكستان وطاجيكستان مع كل من الصين وروسيا في أكبر مناورات مشتركة بينهما في 9 أغسطس/ آب 2021، وهي مناورات "التعاون 2021"، والتي ضمت أكثر من 10 آلاف جندي للمشاركة في المناورات المشتركة التي شملت أيضا طائرات مقاتلة ومدفعية، وإقامة مركز مشترك للقيادة.
خاتمة
تبقى القضية في أفغانستان غير محسومة، ويبقى المستقبل رهنا بقرارات إستراتيجية على حركة طالبان أن تتخذها، ويبقى القرار الإستراتيجي محددا لاستمرار طالبان في الحكم من عدمه.
فمن جهة، تخطط أميركا بعد انسحاب واع، لإغراق طالبان في مواجهات أهلية وإقليمية، عبر عدة مفاتيح، أبرزها الأسلحة المتروكة للحركة، وهذه الأسلحة قد تكون مصدرا لإنقاذ طالبان، كما قد تكون مصدرا لإغراقها في مشكلات إقليمية عدة.
وفيما أفادت كل من الصين وروسيا من الوجود الأميركي في أفغانستان، وساعدتاها في مهمة القضاء على تنظيم "القاعدة" في هذا البلد، ما طمأنهما لكون طالبان حركة محلية لا نزوع لديها للعالمية كما هو حال "القاعدة"، فإنهما يميلان لاقتطاع جزء واسع من الكعكة الأفغانية الآن، وليس غدا.
ولا يمنع هذا من أن تُجريا استعدادات عسكرية لردع النزوع الاستقلالي لطالبان، أو للجاهزية لأي احتمال بحدوث حالة فراغ أمني في أفغانستان لأي سبب.
أما على صعيد القوى الإقليمية، فإنها جميعا شاركت في حالة حوار مع طالبان، وحالة حوار أخرى بينية أو مع القوى الكبرى عن طالبان.
وفيما يعكس كل منهما حالة "قلق عميق" حيال الحركة، ربما باستثناء تركيا، فإن هذه الأطراف تجري حسابات دقيقة لمصالحها ومخاوفها، في ضوء إشارات ترحيب صادرة عن الحركة تجاه كل منها، بما في ذلك الهند وإيران.
إشارات الترحيب "الطالبانية" موجهة للجميع، بلا استثناء، وسبق لوزراء خارجية الصين وروسيا وتركيا وباكستان أن صرحوا معبرين عن الذكاء التفاوضي للحركة، وهو ما يعكس تطورا واضحا بالحركة، يمثل ثباتا واضحا على المبدأ، مع مراعاة "مصالح" و"مخاوف" دول الجوار.
تسعى طالبان، عبر دفق رسائلها الاتصالية الإيجابية المطمئنة، إلى تحقيق الاستقرار الداخلي أكثر من غيره من الأهداف، وتسعى لتجنب التأثير السلبي لكل هذه الأطراف على مستقبل وجودها بالسلطة.
وهو الدرس الذي استوعبته بعد أن اضطرت لمغادرة كابل، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد الاستعداد الأميركي للهجوم على العاصمة.
أما عن دول الجوار، أوزبكستان وطاجيكستان إلى جانب تركمانستان، فهي التزمت جانب اللواذ بالروس، وتولى الأخيرون التصريحات العدائية نيابة عنهم.
وقامت روسيا والصين بتوظيف هذه الدول لأغراض الردع عبر مناورات أجرتها روسيا مع أوزبكستان، وأخرى أجرتها كل من روسيا والصين مع طاجيكستان وأوزبكستان، وهي مناورات "التعاون 2021" الأكبر في آسيا منذ عقود.