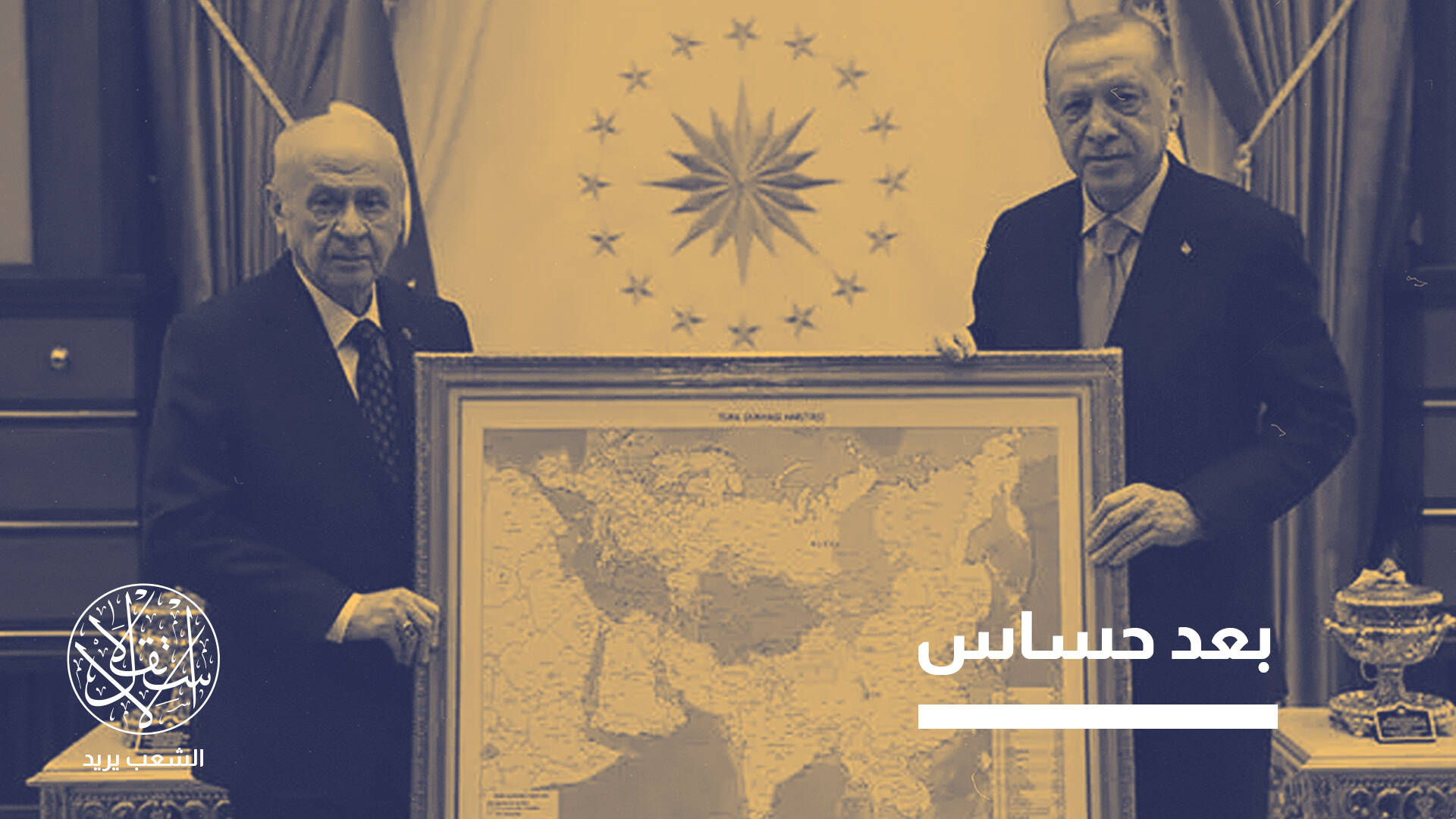زوجة المعتقل محمد البلتاجي: لا أعلم إن كان حيا أم ميتا بعد 12 سنة من الحبس الانفرادي

"ظروف الاحتجاز القاسية أثرت بشدة في الصحة الجسدية والنفسية للمعتقلين"
في ظل إضراب مفتوح يخوضه عشرات المعتقلين السياسيين عن الطعام في مصر، تروي السيدة سناء عبدالجواد، زوجة القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، شهادة إنسانية مؤلمة تكشف حجم المأساة التي يعيشها هؤلاء في سجون مصر.
وفي حوار مع “الاستقلال”، تحدثت زوجة البرلماني السابق المعتقل منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 عن تفاصيل صادمة توثق الانتهاكات المستمرة بحق الدكتور البلتاجي وكذلك ابنها أنس في زنازين العزل الانفرادي بالسجون، خاصة سجن بدر 3 سيئ السمعة.
وأكدت عبد الجواد أن زوجها وابنها يمران كآلاف المعتقلين بظروف صعبة، محرومين من حقوقهم الأساسية بالزيارة والتريض والتعرض للشمس والحصول على طعام آدمي ومياه نظيفة للشرب، ما أدخلهم في أزمات صحية ونفسية لا تنتهي.
وبدأ القيادي البلتاجي الإضراب في 20 يونيو/حزيران 2025 بشكل جزئي احتجاجًا على ظروف احتجازه، ثم تحول إلى إضراب كلي بعد تجاهل السلطات مطالبه، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى مستشفى السجن.
وقالت عبد الجواد إنها لا تعلم إن كان زوجها حيا جراء الإضراب ونقله المستمر إلى مستشفى السجن، كما أنها لم تر وجه ابنها أنس منذ 13 سنة، عندما انقلب قائد الجيش السابق ورئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي.
ووجهت عبد الجواد رسالة إلى الشعوب العربية، والمجتمع الدولي بأسره، أن يتحركوا ويتحدوا، وأن يكونوا صوتا واحدا وموقفا موحدا، للمطالبة بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، الذين يُحرمون من أبسط حقوقهم منذ سنوات طويلة.
وسناء عبد الجواد المتحدث باسم رابطة "نساء ضد قتل المتظاهرين" وعضو التحالف الثوري لنساء مصر سابقا، هي زوجة القيادي البلتاجي، وأيضا والدة أنس الذي ألقي القبض عليه بسبب اسمه بعد مطالعة هويته، في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وكان عمره حينها 19 عاماً.

ظروف مأساوية
هل يمكنك أن تصفي لنا الظروف التي يعيشها زوجك الدكتور محمد البلتاجي وابنك أنس في السجون المصرية؟
مع الأسف، جميع الانتهاكات التي كنا نسمع عنها في السابق، مثل ما كان يحدث في معتقل غوانتانامو (الأميركي سيئ السمعة)، قد تعرض لها زوجي وابني في السجون المصرية منذ لحظة اعتقالهما عام 2013.
فمنذ ذلك الحين وهما يقبعان في حبس انفرادي. في أول عامين من الاعتقال، كان يُسمح لهما أحيانا بالخروج للتريض، لكن بعد عامين تقريبا توقف هذا الأمر تماما، ومنذ أكثر من تسع سنوات لم يُسمح لهما بالخروج مطلقا.
وقد جرى احتجاز كل من زوجي وابني في عنبر منفصل، ليس ضمن زنازين تضم نزلاء آخرين، بل كل منهما في عنبر بمفرده، تحيط به زنازين فارغة أو مغلقة.
هذا العزل السلبي للأسف استمر طوال سنوات، وكأن الهدف هو عزلهما التام عن العالم، وقتلهما ببطء دون أن يشعر أحد بوجودهما أو يسمع صوتهما. لم يكن هناك أي تواصل حتى عبر فتحة الباب مع بقية السجناء.
وفي أحيان كثيرة، كانت تمر عدة أيام دون أن يصلهما الطعام، وحتى عندما يُقدم إليهما، فكان عبارة عن وجبات سيئة للغاية، لا تصلح حتى لأن يتناولها الحيوان، سواء من حيث الكمية أو الجودة.
ظروف الاحتجاز القاسية هذه أثرت بشدة في صحتهما الجسدية والنفسية، وكان لذلك انعكاسات سلبية كبيرة عليهما، كما أن العديد من المعتقلين الآخرين تعرضوا للمعاملة التمييزية ذاتها.
وحتى الآن، لم تصدر أي استجابة من الجهات المعنية بخصوص المطالب الأساسية، مثل السماح بالزيارة أو الخروج للتريض.
أما بالنسبة للحالة الصحية لزوجي، فقد جرى نقله إلى مستشفى السجن ثلاث مرات بعد تدهور حالته، والذي يفتقر لأي إمكانيات أو تجهيزات طبية.
وهذا في حد ذاته دليل على أن وضعه الصحي قد أصبح خطيرا، لأنهم عادة لا ينقلون المعتقلين للمستشفى إلا في الحالات الحرجة.
لكن للأسف، لا أعلم حتى الآن إن كان لا يزال في المستشفى أم أعيد إلى الزنزانة، ولا توجد لدي أي معلومات عن حالته الصحية، رغم أن من حقي الطبيعي أن أطمئن عليه وأعرف الأمراض التي يعاني منها، بل وأدخل له الأدوية اللازمة.
لكن كثيرًا ما كانت الأدوية التي أحملها تُمنع من الدخول أثناء الزيارات (توقفت لاحقا). وحتى المحامي عندما يستخرج تصريحا رسميا ويحضر إلى السجن لساعات في محاولة لتسليم ملابس أو أدوية، يُرفض السماح له بذلك٬ كل هذه الممارسات أثّرت بشكل كبير في صحة زوجي وابني.
ما أبرز الانتهاكات التي تعرض لها زوجك ومن معه من المعتقلين داخل سجن بدر 3، خاصة فيما يتعلق بالحبس الانفرادي والحرمان من حقوق الزيارة؟
أستطيع أن أحدد العديد من الانتهاكات التي تعرض لها زوجي وابني داخل السجون المصرية، وهي تُخالف حتى الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القوانين المحلية والدولية.
فالسجين وفقا للقانون له حقوق مكفولة، كحق الزيارة والتريض يوميا لمدة أربع ساعات، حتى لو كان محكوما عليه؛ إذ ينبغي أن يُسمح له بالتعرض للشمس. من حقوقه أيضا تلقي العلاج ووجود رعاية صحية داخل السجن.
لكن ما حدث مع زوجي أمر يفوق الوصف، فقد أُصيب بجلطتين دماغيتين خلال السنوات الماضية.
ومع أنه من المفترض أن تُنقل مثل هذه الحالات إلى العناية المركزة، فإن إدارة السجن كانت ترفض تماما خروجه لتلقي العلاج خارج المعتقل، رغم أننا عرضنا تحمل التكاليف من مالنا الخاص. وهذا بالطبع كان له أثر سلبي بالغ على صحته.
أما ظروف الاحتجاز، فهي شديدة القسوة، إذ لا خروج للتريض، ولا زيارات، ولا أي تواصل مع العالم الخارجي، والرعاية الطبية معدومة تمامًا، على خلاف ما تدعيه السلطات في الإعلام.
فحين تزداد الشكاوى من داخل السجون، تلجأ الجهات الرسمية إلى "تمثيليات" من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يزور بعضها مثل بدر.
وتُلتقط حينها له (ولزملائه) صور تُظهر السجن وكأنه فندق خمس نجوم، بملاعب رياضية وغرف طعام مجهزة، وأطعمة صحية، ومرافق طبية متقدمة. لكن كل هذا مجرد ديكور إعلامي لا يمت للواقع بأي صلة.
زوجي وابني لا يعرفان معنى كلمة "سرير" منذ سنوات٬ ينامان على الأرض، في سجون مثل العقرب، المبنية بالخرسانة، حيث تتحول الزنازين إلى "ثلاجة" في الشتاء، و"فرن" في الصيف، دون أي تهوية.
ثم نُقلا لاحقًا إلى سجن بدر، الذي وُضعت فيه إنارة شديدة للغاية داخل الزنازين، طوال الوقت، ما يرهق الجهاز العصبي ويؤدي إلى اضطرابات نفسية وعصبية.
هذا فضلًا عن كاميرات المراقبة التي تعمل على مدار 24 ساعة، وتُشعر السجين بأنه مراقب طوال الوقت، مما يخلق حالة من الضغط النفسي المستمر.
هؤلاء السجناء، ومنهم زوجي وابني، لا يُسمح لهم بمغادرة زنازينهم، فلا ندري ما الذي تخشاه الدولة حتى تبقيهم تحت هذه الرقابة المشددة.
منع التواصل مع العالم الخارجي يمتد أيضًا إلى الصحف، والكتب، والمجلات، بل حتى القرآن الكريم؛ فكثيرا ما كانت تُصادَر المصاحف خلال حملات التفتيش.
كما يُنقل المعتقلون إلى زنازين تأديبية كلما اشتكوا من شيء، رغم أن زنازينهم الأساسية أصلا غير صالحة للعيش الآدمي، فما بالك بزنازين التأديب التي هي أسوأ بكثير.
الانتهاك الأكبر الذي تعرضوا له هو انتهاك حقهم في الحرية، إذ إنهم محبوسون دون مبرر حقيقي، في قضايا مفبركة، لا تستند إلى دليل.
نحن لا نطالب بأكثر من محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل غير خاضع للسلطة العسكرية، وإذا حصل ذلك، فسيثبت للجميع براءتهم.
زوجي الدكتور البلتاجي لم يُقدم منه إلا حب هذا الوطن، فقد خدم في البرلمان، وشارك في الحركات الوطنية، وكان عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقد زار بنفسه سجن العقرب قبل 2013، وكتب تقريرا أكد فيه أنه لا يصلح للعيش الآدمي.
والمفارقة المؤلمة أنه عاد إليه لاحقا، سجينا، داخل نفس الزنزانة التي حذر منها.
ما تعرض له زوجي وابني من تعذيب نفسي وجسدي، ومنع التواصل، والحرمان من الحقوق الأساسية٬ لم يكن إلا جزءا من سياسة ممنهجة لإذلال السجناء وقطعهم عن الحياة.
حتى الحق في إجراء مكالمة هاتفية مع أسرهم، وهو حق منصوص عليه، يُمنع عنهم. وكذلك الرسائل، التي يُفترض أن يُسمح لهم بتبادلها مع ذويهم.
كل هذه الممارسات تهدف إلى قتلهم ببطء داخل السجون، وهذا ليس مجرد كلام، بل واقع نراه بأعيننا، حيث نسمع كل يوم تقريبا عن وفاة معتقل بسبب الإهمال الطبي.
إذ يُترك المريض حتى تشتد حالته، ويستغيث من حوله دون جدوى، حتى يموت، ثم يُبلغ أهله لتسلم الجثمان. هذه هي الحقيقة القاسية لما يجرى في السجون المصرية.

“الانفرادي” والإضراب
كيف أثر الحبس الانفرادي وعدم السماح برؤية الشمس على الصحة النفسية والبدنية للمعتقلين، خاصة لزوجك الذي يعاني من أمراض مزمنة؟
بطبيعة الحال، يُعد الحبس الانفرادي من أقسى وأشد أشكال الانتهاكات التي تعرض لها زوجي وابني، بل يمكن القول إنه الأسوأ على الإطلاق.
أن يُحتجز الإنسان داخل زنزانة ضيقة لا تتجاوز مترين في مترين، دون أن يُسمح له بالخروج مطلقا، ودون تواصل مع أي شخص، ولا حتى سماع صوت إنسان آخر، فهذا في حد ذاته عذاب نفسي قاسٍ.
زوجي وابني قضيا فترات طويلة في هذا النوع من العزل، دون كتب، بل وحتى دون مصحف في كثير من الأحيان. ومن الطبيعي أن يخلّف هذا الحبس الانفرادي آثارا بالغة على الصحة النفسية والبدنية.
فعلى سبيل المثال، أنس ابني لم يكن يعاني من أي أمراض قبل السجن، لكنه اليوم مصاب بارتفاع ضغط الدم المزمن، ومشكلات في الكلى نتيجة المياه الملوثة التي يُجبرون على شربها، والطعام الفاسد وغير الآدمي الذي يُقدّم لهم.
كنا نرى خلال الزيارات القليلة الماضية أواني الطعام التي يُقدم فيها الأكل، وكانت في غاية القذارة والرداءة، لا يُعقل أن يُقدم فيها طعام لبشر، ناهيك عن كونه غير صالح للاستهلاك الآدمي أصلاً.
للأسف، نواجه صعوبة شديدة في الحصول على أي معلومة بشأن زوجي أو ابني. خلال السنوات الماضية، كان يتم عرضهم على جلسات محاكمة من حين لآخر، لكن ذلك لا يُغير شيئا من وضعهم المأساوي.
زوجي وُجهت إليه نحو 29 تهمة، أي 29 قضية منفصلة، وصدر بحقه ما يقارب 230 سنة من الأحكام، بالإضافة إلى حكمين بالإعدام، أحدهما في قضية فض اعتصام رابعة، التي قُتلت فيها ابنتنا الوحيدة "أسماء".
والمفارقة أن يُتهم والدها في هذه القضية ويُحكم عليه بالإعدام، وهو أمر في غاية الغرابة والظلم.
أما أنس، فليس عليه أي قضية واضحة، ولا تُهمة محددة، وكل ما في الأمر أنه يُعاقب انتقامًا من والده.
ورغم ذلك، يُعامل بنفس طريقة المعاملة القاسية التي يتعرض لها والده، من منع الزيارة، والحبس الانفرادي، وانعدام أي وسيلة تواصل.
أنا، كزوجة وأم، محرومة تماما من أي اتصال بزوجي وابني، قد تمر سنة أو أكثر دون أن يصلنا أي خبر عنهما.
أحيانا يصل بنا الحال إلى التساؤل: هل لا يزالان على قيد الحياة؟ لا شيء يدل على ذلك، لا اتصال، ولا رسالة، ولا زيارة، ولا أي وسيلة للاطمئنان.
لقد فُرض عليهما حصار كامل داخل السجن، وفُرض علينا حصار خارجي لا يسمح لنا بمعرفة أي شيء عنهما.
ورغم مناشداتنا المتكررة للجهات الحقوقية والمنظمات الدولية، ومطالبتنا بحق الزيارة أو حتى مكالمة هاتفية قصيرة نطمئن من خلالها على أحوالهما، فإننا لا نجد أي استجابة، وكأننا نخاطب جدارا، فلا حياة لمن تنادي.
ما دوافع زوجك للدخول في إضراب عن الطعام؟ وهل هناك مطالب محددة رفعها المعتقلون خلال هذا الإضراب؟
بدأ الإضراب في العشرين من يونيو 2025 بعد سنوات طويلة من الحبس الانفرادي والعزلة التامة عن العالم الخارجي.
زوجي وابني، كغيرهم من المعتقلين، محرومون من التواصل مع أسرهم، ويجهلون كل ما يحدث خارج أسوار السجن.
على سبيل المثال، العديد من أبنائنا تزوجوا وأنجبوا وتخرجوا ومرت عليهم أحداث كبيرة، لكنهم لا يعلمون عنها شيئا. أحد المعتقلين علم بوفاة والدته بعد فترة طويلة، ولم يُسمح له حتى برؤيتها أو وداعها.
العزلة التي فُرضت عليهم كانت قاسية إلى حد لا يُطاق، وكان الهدف منها واضحا، قطع كل صلة لهم بالعالم الخارجي. ومن هنا جاء الإضراب عن الطعام، كوسيلة احتجاج سلمية للمطالبة بحقين أساسيين، التريض والسماح بالزيارات.
فهم يطالبون بأن يُسمح لهم برؤية أسرهم والاطمئنان عليهم، وبأن يُسمح لهم بالخروج من الزنازين ولو لفترة وجيزة، ومقابلة زملائهم المعتقلين، وسماع أصوات بشرية غير صوتهم.
المعتقل لا يسمع إلا صوته، بل إنه حتى لا يرى نفسه. تخيلوا إنسانا أمضى أكثر من 12 عاما لا يعرف كيف يبدو شكله، لأنه لا توجد مرآة داخل الزنزانة.
في الحياة الطبيعية، الإنسان يرى وجهه يوميا، يصفف شعره، يهتم بمظهره، أما المعتقل فلا يعرف لون بشرته ولا شكل وجهه، وقد نسي ملامحه تماما.
كذلك أنا، كأم، لا أعرف شكل ابني أنس الآن. دخل السجن وهو في التاسعة عشرة من عمره، واليوم تجاوز الثانية والثلاثين. لا أعرف كيف أصبح شكله، ولا صوته، فقد نسيت نبرة صوته تمامًا.
لقد تغير كثيرا بلا شك، لكنه لا يزال محبوسا، بعيدا عنا، مثله مثل والده الدكتور البلتاجي، الذي لا نعلم عنه شيئا منذ سنوات.
كل هذه الظروف دفعتهم للإضراب عن الطعام. لقد قالوا: “نحن بشر، ولنا حقوق”، فإضرابهم هو صرخة من الأعماق، يريدون بها أن يسمعهم العالم، أن يستجيب لمطالبهم.
إنهم يطالبون بحقوقهم، ويريدون من الآخرين أن يدافعوا عن هذه الحقوق. وحين لم يجدوا وسيلة أخرى للتعبير عن احتجاجهم، لم يكن أمامهم سوى اللجوء إلى الإضراب. وللأسف، مع مرور الوقت، وبعد أن غُيبوا عن الحياة، ونسيهم الناس، تراجعت المطالب.
بدلا من المطالبة بالإفراج عنهم بصفتهم معتقلين ظلما، أصبحت المطالب تقتصر على فتح الزيارة والتريض فقط. لقد شعروا أن لا أحد يتحدث عنهم، ولا أحد يُطالب بحقوقهم، وكأن الجميع اعتاد على وجودهم خلف القضبان.
الإضراب الذي بدأ جزئيا، تحول لاحقا إلى إضراب كلي، لكن الدكتور البلتاجي يعاني من مشكلات صحية خطيرة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير بعد بدء الإضراب، واضطروا لنقله إلى المستشفى.
لكن للأسف، لم يكن مستشفى خارجيا، بل الداخلي في السجن، الذي يفتقر إلى أبسط الإمكانيات الطبية، ولا يوفر الحد الأدنى من الرعاية المطلوبة.

حرمان من الحقوق
ما الصعوبات التي تواجهها عائلتكم في التواصل مع المعتقلين، وهل هناك أي محاولات مستمرة لكسر جدار الصمت المفروض عليهم؟
بكل أسف، الوضع سيئ للغاية، ونحن والله نكابد مشقة شديدة جداً في محاولة التواصل مع زوجي وابني أو معرفة أي خبر عنهما بعد الإضراب الذي عرفناه من الخارج بصعوبة شديدة.
للأسف، لا يوجد لديّ أي وسيلة للتواصل مع ابني وزوجي، ولا أعلم كيف يمكن تحقيق ذلك، فالتواصل عادة يكون من خلال الزيارات.
لكن الزيارات ممنوعة منذ سنوات طويلة، سواء لزوجي أو ابني، الوضع متطابق تماما بالنسبة لكليهما.
وبالتالي، فإنني، كزوجة وكأم، محرومة تماما من أي شكل من أشكال التواصل معهما، ونمر بفترات طويلة تمتد أحيانا إلى سنة أو أكثر دون أن نعلم عنهما أي شيء.
لا تصلنا منهما أي رسالة، ولا مكالمة، ولا توجد أي وسيلة تواصل، وكأنهم في حصار داخل السجن، ولا نعرف عنهما شيئًا على الإطلاق.
ورغم محاولاتنا المتكررة من خلال منظمات حقوق الإنسان، بإصدار بيانات ومناشدات تطالب بحقهما في الزيارة أو على الأقل في الاتصال الهاتفي أو إرسال رسالة تطمئننا عليهما، فإن هذه المحاولات لا تلقى أي استجابة، وكأننا نخاطب من لا حياة لهم.
كيف تقيمين دور السلطات المصرية في التعامل مع المعتقلين السياسيين وحقوقهم الأساسية؟
يمكن القول بكل وضوح إنهم محرومون من حقوقهم القانونية والإنسانية كافة دون استثناء.
فهؤلاء المعتقلون لا يُعاملون بصفتهم مواطنين لهم حقوق، بل تُمارس بحقهم سياسات الإقصاء والتهميش وكأنهم منبوذون بالكامل من الحياة العامة.
ما يُثير الاستغراب أن معظم هؤلاء المعتقلين هم من أصحاب الكفاءات الرفيعة، من أساتذة الجامعات، والأطباء، والمهنيين ذوي المكانة العلمية والمجتمعية المرموقة.
فزوجي، على سبيل المثال، كان أستاذا جامعيا، وطبيبا وجراحا كبيرا، وله إسهاماته البارزة في المجتمع. ومع ذلك جرى تهميشه وإقصاؤه بالكامل، والتعامل معه وكأنه إرهابي.
السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هو: كيف حدث هذا التحول المفاجئ؟ كيف أصبح هؤلاء النخبة إرهابيين بين ليلة وضحاها، وتحديدا بعد انقلاب عام 2013؟
كيف يتحول شخص كان يُعامل باحترام، وشارك في البرلمان المصري لدورتين، وكان ناشطًا في جميع الجمعيات الوطنية، وله مركز طبي معروف، وكان أستاذًا في جامعة الأزهر، إلى متهم يُلاحق بالإعدام؟
بل إن المستشفى الخاصة التي أسسها زوجي جرى تدميرها بالكامل بعد الانقلاب، في مشهد يعكس حجم الاستهداف والانتقام.
ما يحدث اليوم يؤكد أن هؤلاء المعتقلين لا يُنظر إليهم كأشخاص يُفترض أن تُصان حقوقهم، بل يتم التعامل معهم على أنهم خصوم يجب التخلص منهم، حتى ولو عبر أحكام الإعدام.
وهو ما يتم الترويج له بالفعل عبر وسائل الإعلام التابعة للسلطة، في حملة منظمة لتجريمهم ونزع إنسانيتهم بصورة ممنهجة.
التمسك بالأمل
ما الرسائل التي تودين توجيهها إلى المؤسسات الحقوقية الدولية والرأي العام العربي والدولي بهذا الشأن؟
أوجه رسالتي إلى جميع الشعوب العربية، والمجتمع الدولي بأسره، وكل من يعلم أن هناك آلاف المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، بأن يتحركوا ويتحدوا، وأن يكونوا صوتا واحدا وموقفا موحدا، للمطالبة بإطلاق سراح هؤلاء الذين يُحرمون من أبسط حقوقهم منذ سنوات طويلة.
إلى متى سيبقون في السجون؟ لا بد أن يؤدي كل إنسان دوره من موقعه، وأن يرفع صوته للمطالبة بالإفراج عن هؤلاء، وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، بعد أن قضوا سنوات من أعمارهم خلف القضبان.
لقد دخل بعضهم السجن في مقتبل العمر، شبابا يافعين، واليوم صاروا شيوخا. ابني دخله في سن التاسعة عشرة، واليوم بلغ الثانية والثلاثين. شباب كامل ضاع خلف الأسوار.
لهذا السبب، لا بد أن يتحرك الناس، لا بد أن يشعروا بمعاناة المعتقلين، أن يرفعوا أصواتهم، وأن تستيقظ ضمائرهم.
نحن بحاجة إلى حالة من المصالحة المجتمعية الحقيقية، فهؤلاء المعتقلون لم يرتكبوا جرائم، بل إن كثيرا منهم، ومنهم زوجي، لم تُوجه إليهم أي تهم حقيقية.
زوجي والحمد لله يده نظيفة، ولم يُتهم قط في أي قضية تتعلق بالرشوة أو الفساد أو الاختلاس أو أي إساءة استخدام للسلطة. كل ما وُجه إليه من تهم كان بسبب آرائه السياسية.
ومن حق كل إنسان أن يعبر عن رأيه، وأن يختلف في الرأي، فهل يُعقل أن يكون مصير من يُعارض أو يختلف سياسيا هو السجن، والتعذيب، والحكم بالإعدام مرتين؟ فقط لأنه مارس حقه الطبيعي في التعبير؟ في أي شريعة يُبرر ذلك؟
لا بد أن يتعلم الناس كيف يقبلون الرأي الآخر، حتى وإن اختلفوا معه سياسيا. فالمعتقلون في النهاية بشر، لهم حقوق وكرامة، وأضعف الإيمان أن نتضامن معهم، وأن نُطالب بحقوقهم الأساسية، وعلى رأسها حريتهم.
نُطالب بالإفراج عنهم، أو على الأقل تمكينهم من محاكمات عادلة ونزيهة. ما يجري اليوم هو جريمة مستمرة منذ أكثر من 12 عامًا، ولا يمكن لأي بلد أن يستقر، أو أن ينعم بالكرامة، ما دام يحتجز آلاف الأبرياء خلف القضبان.
لن أقول إنهم "خيرة أبناء الشعب المصري" فقط، بل هم أبناء هذا الوطن الذي يزخر بالأخيار، ولكنهم كانوا من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة، والدور المجتمعي، والانحياز للإصلاح ومقاومة الفساد.
ولهذا، فإن على المؤسسات الحقوقية والإعلامية، وكل من يحمل ضميرا حيا، أن يتحركوا، وأن يشعروا بمعاناة من يموتون بصمت داخل الزنازين، وأن يهبّوا لنصرتهم بكل ما يستطيعون.
إننا لا نطلب شيئا مستحيلا، بل نطالب فقط بحقهم في الحرية، ونسأل: لماذا هم أصلا في السجون؟
كيف تحافظ العائلة على الصبر والقوة في ظل هذه الظروف الصعبة بعد فقدانكم لابنتكم أسماء والاعتقالات والغربة؟
للأسف كل ما جرى خلال السنوات الماضية، وكل ما تعرّضنا له كأُسر طيلة الاثني عشر عاما الماضية، كان قاسيا وصعبا إلى أبعد حد.
ورغم كل ذلك، فإننا نحاول دوما أن نستمد قوتنا من الله سبحانه وتعالى، ونتصبر ابتغاء وجهه، ونُعزي أنفسنا بالأمل، يقينا منا بأن هذا الوضع لن يدوم، ولا بد أن يتغير في يوم ما، بإذن الله.
فالظلم وإن طال فله ساعة، وإن اشتدّ الظلام، فإن الفجر لا محالة آتٍ بعده. ونحن نصبر على البلاء بكلمات كهذه، وبإيماننا بأن ما نمر به هو قدر من الله، ومع ذلك لا نيأس، ولا نركن إلى الاستسلام، بل نأخذ بالأسباب، ونؤدي ما علينا من واجب تجاه من نحب.
إن من واجبنا كعائلة، وكأفراد، ومن واجب كل إنسان حر، وكل منظمة حقوقية، وكل من يشعر بالمسؤولية، أن يتحرك ويستشعر حجم المعاناة.
خاصة حين يعلم أن هناك أناسا في الداخل يموتون ببطء، بينما الناس في الخارج ينعمون بالأمان، ويعيشون بين أُسرهم، يأكلون ويشربون، ويتسامرون مع أبنائهم، وكأن شيئا لا يحدث.
كيف يمكن لإنسان أن ينعم بحياته، وهناك آلاف محرومون من أبسط مقومات الحياة، بل من الحياة نفسها؟
ورغم كل ذلك، فإننا ما زلنا نتقوى بالله سبحانه وتعالى، ونصبر صبرا جميلا، إلى أن يأتي فرج الله ونصره، الذي لا نشك في قدومه، بإذن الله. نحن نؤمن أن هذا الوضع الجائر لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، وأن هذه المحنة لا بد أن تزول.
صحيح أن السنوات العجاف كانت طويلة ومؤلمة، ولكن يبقى لدينا أمل لا ينطفئ بأن الأمور ستتغير، وأن الحقوق ستعود إلى أصحابها، وإن لم يكن اليوم، فغدا بإذن الله.
فهذا الظلم لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، وبعد كل هذا الظلام، لا بد أن يُشرق النور.